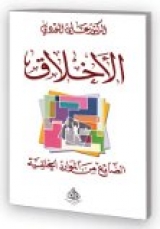
علي الورديّ.. رؤيةٌ مبكّرةٌ في النقدِ الثقافيّ / محمد صابر عبيد
2013-10-24
المظاهرُ العامةُ للرؤية:
ربّما يُعدّ الكتاب السجاليّ الموسوم بـ«أسطورة الأدب الرفيع» (أسطورة الأدب الرفيع، د. علي الوردي، دار ومكتبة دجلة والفرات، بيروت، لبنان، ط1، 2009) للدكتور علي الورديّ واحدًا من أبرز الكتب المبكّرة التي قدّمتْ رؤيةً معيّنة للنقد الثقافيّ، الذي يشتغل أوّل ما يشتغل على تجريد الأدب من فعاليته الجمالية التي تعزله عن فعاليته الثقافية والاجتماعية، إذ شنّ الورديّ هجومًا كاسحًا على النزعة الجمالية الصرف، وعلى انشغال «الشعر العربيّ» خاصةً بما لا يمكن أن يؤثر في تطوير الفكر الثقافيّ والاجتماعيّ كما تفعل المعارف الأخرى، بل على العكس يرى أنّ فعل الشعر العربيّ في مجتمعِ تلقيهِ يعدّ سلبيًا يحولُ بينه وبين أيّ تقدّمٍ محتملٍ، لأنّ الشعر يشتغل في المنطقة غير المنتجة ثقافيًا من مناطق الفعل الإنسانيّ.
ففي عتبة إهداء الكتاب يرسم الورديّ صورةً عن هذه المظاهر حين يوجّه خطابه إلى الأدباء الذين يلبسون عباءة الماضي متغافلين عن حراك الحاضر: «أهدي كتابي هذا إلى أولئك الأدباء الذين يخاطبون بأدبهم العصور الذهبية الماضية، عسى أن يحفزّهم الكتاب على أن يهتموا قليلًا بأهل هذا العصر الذي يعيشون فيه، ويخاطبوهم بما يفهمون، فلقد ذهب عهد الذهب، واستعاض الناس عنه بالحديد»، فخطابُهم موجّهٌ نحو «العصور الذهبية الماضية» في حين «ذهب عهد الذهب»، متمنيًا أن تنهض أطروحته بتحفيز هؤلاء الكتاب كي يحوّلوا اهتمامهم نحو «أهل هذا العصر الذي يعيشون فيه»، لأنهم يعيشون في عصر غير عصرهم وليس بوسعهم التأثير فيه، لذا فإنّ معرفتهم معرفة سلبية لا تؤثر في عصرهم، وخطابهم خارج إطار المعرفة الحديثة التي يعيشها العصر برحابةٍ ويتنفّس هواءها بارتياح، وصار الحديد بالمعنى التقانيّ والتكنولوجيّ العلميّ المنتج هو عنوان الحضارة الحديثة، لا الذهب الذي يعمي ببريقه العيون ويكفّها عن رؤية ما يجب أن يُرى.
ويطرح الورديّ في مقدمة كتابه منظورًا حجاجيًا متقدمًا في إدارة دفّة الجدال بينه وبين مناوئيه ومحاوريه في هذه الأطروحة، إذ هو يهتمّ بجوهر الحجاج لا سطحه، لذا لا يوجّه خطابه السجاليّ نحو مجادليه من أجل تفنيد رؤيتهم وتحقيق الانتصار عليهم، بل يسيّر خطابه في سياق تكبير صورة رؤيته وتوضيحها إلى أقصى حدّ، فضلًا عن اعتقاده ـ ومن منظور سوسيوثقافيّ يُبرزُ المظاهرَ العامةَ لهذه الرؤية، أنّ الانشغال بالجدل يقود ضرورةً إلى السعي الحثيث نحو توكيد وجهة النظر على حساب الأطروحة/الأصل، لأنّ الانغماس في الجدل يقود إلى التعصّب للفكرة، والتعصّب يُذهبُ العقلَ، ويحيلُ الجدلَ إلى كلام عقيمٍ يهتمّ بتفنيد الفكرة المضادّة أكثر من الارتفاع بمهمة تقديم الفكرة الرئيسة على أفضل ما يكون:
«سيلاحظ القارئ أنني أسهبت في آرائي وتبسّطت فيها. ولعلني ذهبت فيها مذهب من يريد التفهّم والتوضيح لا مذهب من يريد الغلبة في الجدال. وهذا هو ديدني في كلّ كتاب أخرجه للناس. فأنا واثق بأنّ الذي أريد مجادلته لا يقتنع بما أقول ولو جئت له بالشمس في رابعة النهار، كما هو شأن الإنسان في كلّ زمان ومكان. ولهذا فإني سأهتمّ بالقارئ أكثر مما أهتم بالمجادلة، ولسوف أُعنى بتبسيط الرأي أكثر مما أعنى بتزويق بيانه وزخرفة ألفاظه».
وتتمثّل رؤيته هنا بـ (أسهبت في آرائي/تبسّطت فيها/مذهب من يريد التفهّم والتوضيح/لا مذهب من يريد الغلبة في الجدال/سأهتمّ بالقارئ أكثر/أعنى بتبسيط الرأي/أكثر مما أعنى بتزويق بيانه وزخرفة ألفاظه)، وكلّها مظاهر تشتغل على توكيد الجانب الثقافيّ في الرؤية وتحويله إلى الميدان الإجرائيّ الذي تتضح معالمه على نحو واسع وعميق في مجتمع التلقي، بحيث يتمثّل الرأي، وينقله من مستواه النظريّ إلى مستواه التطبيقيّ، بعيدًا عن المظاهر الجمالية القِشريّة ذات الطبيعة الشكلية الفارغة من المحتوى.
جدل الرؤية وحرب المفهوم
إنّ الحجاجَ المستنيرَ الذي خاضه الورديّ دفاعًا عن أطروحته السوسيوثقافية في النظر إلى الشعر العربيّ على أنه عامل تحجيم للتطوّر العقليّ والثقافيّ والاجتماعيّ، وليس عامل تنوير ونهضة وتقدّم، يتجاوز حدود الفكرة النظرية المجرّدة، لينفتح على فضاء تفكيريّ مشبعٍ بالروح العلمية ذات الطبيعة الإنتاجية الواضحة، ويطرح في هذا السبيل موضوعة «التجارة» بوصفها موضوعةً مرتهنةً بالعمل القائم على بذل الجهد من أجل حصيلة واضحة ومعيّنة ومفيدة، في الوقت الذي تحوّلت الثقافة فيه إلى سلعةٍ لها باعةٌ يبيعونها ومشترون يشترونها، وثمة فائدةٌ متبادلةٌ للبائع والمشتري، فائدةٌ تسهم في الإشباع والتطوير والتقدّم بأقصى درجات الوضوح والإقناع من طرفي المعادلة:
«فالمسألة تجارية إذن. والمؤمن يقدم نفسه وماله بين يدي الله على سبيل المقايضة، والله سيردّ له ما قدّم ويضيف عليه أرباحًا مضاعفة. والظاهر أنّ المسلمين في عهودهم المتأخرة لم يفهموا كنه هذه التجارة الربانية. فقد صاروا كالشعراء يؤثرون الاستجداء من ربهم بدلًا من المتاجرة معه. ولهذا أخذوا يطمعون في الحصول على الجنة عن طريق الدعاء والعبادة، لا عن طريق العمل والإنفاق. إنهم يحسبون ربهم كالسلطان الذي يتزلف إليه الشعراء بقصائدهم الرنانة، ونسوا أن الله أجلّ من أن يطربه المدح أو يستميله النفاق».
يفتح الوردي رؤيته خارج الحقل الأدبيّ بقيمته الثقافية ليحقق موازنة بين الشاعر بوصفه طالبَ مالٍ وجاهٍ وسلطةٍ، يسخّر شعره في أعلى كفاءةٍ ممكنةٍ لدفع الآخر الممدوح وتحفيزه إلى أكبر قدر ممكنٍ من مستوى الجائزة، والمؤمن الذي لم يفهم كنه التجارة التي سخّرها الله سبحانه وتعالى له كي يشتغل بها معه، فيكافئه على قَدرِ تجارته، وفي الوقت الذي اختار الشاعر فيه الطريق السهلة للحصول على المكاسب بالمديح والتزلّف، اختار المؤمن الطريق نفسها معتقدًا أن الدعاء وحده يكفي للحصول على الجنة، مع أنّ أمامه متّسعًا من العمل والجهد والتجارة من أجل أن يحصل على ما يريد بجهده وعمله وإنتاجه، وهنا يتّضح جدل الرؤية وحرب المفهوم لدى الورديّ في نقد اتّكالية الشاعر واتّكالية المؤمن، على النحو الذي يجب أن تكون الفاعلية فيه فاعلية إنتاجية ذات طابع ثقافيّ تسهم في خير المكان والإنسان شعريًا وإيمانيًا.
فالتصوّر المفهوميّ الخاصّ عند الورديّ في هذا السياق يذهب مباشرة إلى رؤية ثقافية ترتبط بالفائدة الواضحة الجليّة الملموسة، ولا تحفل بالبهرجة التي لا تُغني من جوع ولا تحمي من خوف، فهو يقول: «وصف أحد الأدباء كتبي السابقة بأنها كجبّة الدرويش ليس فيها سوى الرقع. وأظنّ أنه سيصف كتابي هذا بمثل ذلك. ولست لأرى في ذلك بأسًا. فخير لي أن أكون رقّاعًا أخدم الناس بالملابس المهلهلة، من أن أكون خياطًا ممتازًا لصنع الملابس المزركشة التي لا تلائم أجساد الناس ولا ينتفع بها أحد»، فالعبرة، كما يرى، بالفائدة التي تسهم في إغناء الحياة وشحنها بمعنى الفرح الحقيقي المنتج.
لا ينقص الورديّ الوعي في إدراك أنّ الشعر فنّ قبل أيّ شيء آخر، غير أنّ الفنّ في المنظور الاجتماعيّ والثقافيّ حاجة نفسية مجتمعية فضلًا على حاجتها الجمالية، والمعرفة الأدبية هي صنف معرفيّ نوعيّ
لا بدّ له أن يسهم في تطوير العقل الثقافيّ والاجتماعيّ نحو الأفضل، إذ لا بدّ من إدراك أنّ الحضارة الحديثة هي حضارة بَصَرٍ ولمسٍ وإجراءٍ لا تعترف بالجماليات المجرّدة التي لا تحترم الزمن، فعلى الرغم من أنّ القصيدة الشعرية كما يراها الورديّ «هي قبل كلّ شيء قطعة فنية، إنما هي بالإضافة إلى ذلك ظاهرة اجتماعية لها مساس مباشر بما ينشأ بين الناس من صلات التعاون والتنازع. للباحث الاجتماعيّ أن يحلل القصيدة من حيث علاقتها بالمجتمع الذي ظهرت فيه، دون أن يتطرق إلى ما فيها من صفة فنية، إذ هو يترك ذلك للمختصين من الأدباء. وهم في بلادنا كثيرون لا يكاد يخلو منهم مكان والحمد لله»، بمعنى أنه لا ينفي جماليات التعبير الشعريّ لكنه يريد تطوير هذه الجماليات بحيث يمكنها أن تسهم في تطوير العقل وتمجيد الحضارة، ويكون لها تأثير ثقافيّ واجتماعيّ واسع وعميق يسهم في تحقيق نتائج واضحة وملموسة ترفع من شأن إنسانية الإنسان حين يعيش بكرامة ويستمتع بكرامة.
اللغةُ ومقصديّةُ الفهم والإبانة
اللغة عند الورديّ ليست فرصةً للتفنّن والكشف عن المهارات والتعبير عن الوهم على نحوٍ مجرّد، بل هي وسيلة لتحقيق الفهم وتوصيل المعرفة وإدراك المبتغى، «أما دراسة الفنون اللغوية فهي تملأ الذهن بالكلمات التي لا تتفاعل مع المجتمع وعلومه وفنونه، ولهذا يكون صاحبها كثير الحشو في كلامه، إذ هو يلفّ ويدور دون أن يعطي صورة دقيقة لما يريد، وكأنه يدور به في حلقة مفرغة»، لأنّ للّغة في كلّ مجتمعات الدنيا وظيفة مشتركة واحدة على أن تؤديها بإتقانٍ وحِرَفيّةٍ ودلالة مركّزة منتجة، إذ اللغة في منظور الورديّ على هذا النحو «يجب أن تكون دقيقة في التعبير عن مقاصدها لكي تؤدي وظيفتها الاجتماعية تأدية وافية»، لا أن تتمرأى أمام غرور صاحبها كي تستعرض عضلاتها البلاغية من دون جدوى.
غير أنّ الورديّ يستدرك على رؤيته هذه كي لا يُتّهم بما لا يقصد ولا يعني، حين ينفي اعتزامه إلغاء الشعر من الوجود، بل يطلب دراسة ماهيته وتأثيره على الواقع الثقافي والاجتماعيّ بعمقٍ ورحابةٍ وحيادٍ بعيدةٍ عن التعصّب والانغلاق:
«إني في الواقع لا أحبّ أن أزهد الناس بالشعر أو أصرفهم عن دراسته فالشعر حقل مهم من حقول المعرفة، ولا غنى للباحث في المجتمع العربيّ وتاريخه عن دراسة الشعر. ولكنّ الذي أريد من الناس أن يدرسوه دراسة حياد وإنصاف لا دراسة حبّ وتعصّب. وإذا كان للشعر منافع، فله مضار أيضا. وربما كان ضرره بالأمة العربية أكثر من نفعه لها».
وهو ما يقتضي مشروع دراسة ثانيةٍ للشعر العربيّ غير الدراسة التي نعرفها، فالدراسة الأولى التي تهيمن على الدرس الجامعيّ عندنا تضع الشعر العربيّ في مصاف المقدّسات، إذ إنّ مجرد إعادة النظر في قراءته يعدّ جُرمًا لابدّ من معاقبة فاعله، وذلك بسبب المناهج التقليدية التي ظلّت تقارب الشعر العربيّ دائمًا على أنّه عنوان المجد العربيّ والكرامة العربية والأصالة العربية والتراث العربيّ، وحتى هذه العنوانات في الحقيقة ليست معصومة من الخطأ، فلطالما تغنينا ببطولات قادةٍ كبارٍ في التاريخ العربيّ الإسلاميّ بوصفهم مثالًا للعزّة والكرامة والرِفعة، وحين تعرّضوا لدراسات حديثة منصفة تبيّن أنهم مجرمون بحق هذا التاريخ، فمناهج الدراسة الحديثة اليوم كفّت عن تصنيم وتوثين أيّ شيء، فكلّ شيء في منظورها يجب أن يخضع لإعادة النظر وإعادة القراءة من جديد.
إنّ نظرة فاحصة إلى الشعر العربيّ بمختلف عصوره بحسب الورديّ تكشف عن جوانبَ غاية في الأهمية أهملتها دراسته كليًّا، تلك الجوانب التي تهتمّ بتأثير هذا الشعر في صياغة وعي المجتمع وتنظيم رؤيته العقلية وبناء خطابه الثقافيّ، حيث سيتكشّف فضاء آخر مختلف يضع الشعر العربيّ موضع المساءلة عن إسهامه في استغفال الوعي والعقل والثقافة، إذ يرى الورديّ أنّ الشعر ساعد «فوق ذلك على تدعيم الحكومة السلطانية، حيث كان السلطان ينهب أموال الأمة كما يشاء وينفقها على ما يشتهي، ولكنه يأخذ قسطًا مما نهب فيعطيه للشعراء. وهؤلاء لا يترددون عند ذاك عن جعل السلطان أمير المؤمنين وظلّ الله في الأرض»، وهو ما جعل الشاعر وشعره شريكًا في جريمة السرقة والتوثين والتصنيم التي تجعل من السلطان مثالًا معصومًا من الأخطاء، لا بل إنّ الشعر يحوّل أخطاءه إلى منجزات.
وإذا كان الخطاب القرآنيّ يثور على ما كان في الجاهلية من ازدراء للفقير والمسكين واليتيم وغيرهم من طبقة العوام في المجتمع، يرى الورديّ أنّ الشعر الجاهليّ مجّدَ الاستغلال، وامتدحَ العبوديّة، وغنّى للقهر، ورفعَ من شأن القوّة الغاشمة التي كان من حقّها أن تأكل الضعيفَ ثمنًا لقوّتها وضعفه، وربما كان هذا السبب الأوّل الذي جعل الإسلام يقف موقفًا معاديًا للشعر:
«القرآن يحدثنا عن انقسام المجتمع العربيّ إلى طبقات، منها طبقة الأغنياء المستأثرين بالثروة المسرفين في الربا، ومنها طبقة الفقراء المعدمين الذين ليس لهم من الثروة ما يمكنّهم أن يقاوموا أولئك المرابين أو يستغنوا عنهم. والقرآن يذكر كذلك ما كان من العرب من بخلٍ وطمعٍ وظلمٍ وبغيٍ وأكل أموال اليتامى ونكث العهود. أما الشعر الجاهليّ فلا يذكر من ذلك كله شيئا، إنما هو يمثل العرب أجوادًا كرامًا مهينين للأموال مسرفين بازدرائها».
وإذا كان الدين الإسلاميّ دين حضارة ومدنيّة سعى إلى إيجاد تقاليد حياة جديدة تستجيب لمنطق المدنية وحضريتها، فقد «كان الشعر الجاهليّ في معظمه يمثل الحياة البدوية التي تسود القبائل خارج مكّة، وليس عجيبًا بعد هذا أن نجده مختلفًا عن القرآن في تصوير الحياة. إنه بوادٍ والقرآن بوادٍ آخر. وشتان بين الواديين»، وهو ما جعل القرآن يقبل بذلك النوع من الشعر الذي يدافع عن قيم الإسلام ويهجو الكفر والكافرين، ليعزل ما عداه خارج مدينة الإسلام لأنّه لا يقدّم نتائج واضحة تسهم في بناء الإنسان، وعيًا وثقافةً وعلمًا.
فكرة النحو العربيّ بين اللسانيّ والثقافيّ
هيمنت فكرة النحو العربي كثيرًا على أطروحة الورديّ في كتابه «أسطورة الأدب الرفيع»، وعبّر عن رؤيته في السياق نفسه الذي يذهب إلى الثقافيّ على حساب الاستغراق غير المجدي باللسانيّ في مجاله المنطقيّ الذي يعقّد المسائل ولا يحلّها، وعلى الرغم من أنّ هذه الدعوة التي تريد تيسير النحو العربيّ ليست جديدة، فإنّ الورديّ يذهب بعيدًا في مناقشة الأثر الثقافيّ والعلميّ والمعرفيّ الذي يتركه النحو العربيّ بشكله المعروف، وإذا ما أدركنا أنّ النحو العربيّ في هذا السياق كان سببًا رئيسًا في عزوف الكثير من الدارسين عن اللغة العربية، وفي تخلّفهم عن الإلمام بالقواعد التي تلدُ قواعد، وتعقّدُ رحابة اللغة العربية وتسامحها ورقّتها وعذوبتها، وتُكثر من أعدائها باستمرار، ربما سنتحالف مع أطروحة الورديّ في طبقات كثيرة منها، ولاسيما تلك التي تذهب إلى قياس الجدوى الفعلية الملموسة من تعقيد الدرس النحويّ، وتسليط سيف الإعراب على رقاب المساكين الذين سرعان ما يتفاهمون بعيدًا عن سلطة الإعراب، ولا يختلفون ويتقاتلون ـ وربما يفني بعضهم بعضا ـ إلا على مائدته:
«يمكن تشبيه النحو العربي بالعقدة النفسية. إنه وسواس. فالخطيب لا يستطيع أن ينطلق في كلامه مخافة أن يخطئ في النحو. والمستمعون لا يكترثون بما يأتي من المعاني، إنما يركزون على تتبع حركات الإعراب من كلامه. وهم لابدّ أن يعثروا فيها على لحن. فيهزون رءوسهم آسفين كأن الكلام لا يحتوي إلا على الفتح والضم والكسر والسكون. وأصبح النحو عند العرب عنوان الثقافة. فإذا أرادوا امتحان أحد منهم ألقوا إليه جملة معقّدة وطلبوا إعرابها. فإذا تلكأ أو تلعثم استهانوا به. وقد أدى هذا بالخطيب إلى أن يبطئ في النطق وأن يتنطّع به لكي يبرهن للمستمعين أنه بحر في العلم عميق. أما المعاني فتأتي بعد ذلك عرضًا».
ويستعين الورديّ بآراء علماء الاجتماع المتخصصين في هذا المجال وهم يعالجون علاقة الإعراب بنوع العقل، إذ «يقول الدكتور ضود العالم الاجتماعي المعروف، إن الإعراب يصور عقلية بدائية ساذجة، وكلما تقدم الإنسان في حضارته استغنى عن الإعراب في لغته. ولهذا نجد الاتجاه في تطور اللغات الحية يبتعد عن الإعراب تدريجيًا»، ولعلّ مما بالغ في توسيع وتعميق حجم إساءة الإعراب إلى اللغة هو اعتماد النحاة على الشعر بوصفه حجّة إعرابية، واستخدموا ما اصطلح عليه بـ«الشواهد الشعرية»، التي تضمن عندهم صحّة القاعدة النحوية، ويرى الورديّ في هذا المجال «أنّ النحاة أفسدوا النحو باعتمادهم على الشواهد الشعرية في تحرير قواعدهم. فالشعر لا يصلح أن يكون أساسًا للنحو على أيّ حال. إنه مقيّد بقيود الوزن والقافية، وكثيرًا ما تأتي الكلمات والجمل فيه على غير نسقها الطبيعيّ المألوف في لغة الأفكار المنظّمة»، وعلينا أن نتذكّر هنا مقولة «يجوز للشاعر ما لا يجوز لغيره» التي تبيح للشاعر أن يخطئ في الإعراب، أو يتجاوز قاعدة نحوية قارّة إذا لزم الأمر، فكيف يمكن أن يكون بعد ذلك حجّة إعرابية توجّه النحاة وتبرّر تقعيدهم للنحو؟
ثمّة فرقٌ معروفٌ في كلّ لغات العالم بين الكلام والكتابة، وهو فرقٌ تقانيّ وإجرائيّ وثقافيّ في آن، فالكلام فعلٌ وجدانيّ عاطفيّ يقتضي التلاؤم بينه وبين الحالة النفسية للمتكلّم في مكانٍ معيّنٍ وزمنٍ معيّن وموقفٍ معيّنٍ، لذا فهو غالبًا ما يأتي مشحونًا بالعاطفة التي تفسّر على نحو كبير نوع الخطاب المتكلَّم به وحساسيته ومقصديته، في حين لا يتحقق الفعل الكتابيّ إلا بأعلى قدرٍ ممكنٍ من الهدوء والتمثّل وحضور العقل بكلّ توهجه واستعداده، لذا الكتابة بوجه عام كما يقول الورديّ «لا تلائم الهياج العاطفيّ. ويصدق هذا بوجه خاص عند تأليف الكتب. فالمؤلف العاطفيّ قليل القراء»، فالكلام نظامٌ لسانيّ ينهض على حركية الانفعال والتوتّر العاطفيّ المرتبط بالموقف، والكتابة نظام آخر يقوم على الجهد العقليّ المنظّم الذي يقتضي الترتيب والتنظيم والتفكير والانتخاب والتعديل والتبديل حتى يتكامل الفعل الكتابي في أمثل صورة ممكنة، «وقد فطن إلى هذا الأستاذ فندريس حين قارن بين أسلوب الكتابة وأسلوب التكلّم في اللغة الفرنسية الحديثة، فالفرنسيّ لا يتكلم كما يكتب، ولا يكتب كما يتكلم إلا نادرًا، وفي كل حال يوجد اختلاف بين تركيب الكلمات إلى جانب الاختلاف في المفردات»، حيث يأتي الورديّ بهذا المثال في لغة حيّة من أكثر لغات العالم انتشارًا في حضارة اليوم.
يعزو الورديّ التمايز الحاصل في لغة النحو العربيّ المهتمّ بالتعمّل والحذلقة والغرور إلى ما عرفه المجتمع العربيّ من تمايز اجتماعيّ وطبقيّ، إذ «إنّ التمايز الطبقيّ لا يشيع إلا في مجتمع طبقيّ، وكلما قلّت الفروق الطبقية بين الناس وانتشرت مبادئ المساواة والديمقراطية، ضعف اهتمام الناس بالحذلقة اللغوية وأصبحت اللغة وسيلة التفاهم لا للتباهي والكبرياء»، فاللغة كما يرى الورديّ مظهرٌ جوهريّ أساس من مظاهر المجتمع، تستجيب للفوارق بقوّة وتستعين بها وتمثّلها وتفرضها على الواقع، إذ هو يؤكّد «أن المجتمع الذي يحتوي على فروق كبيرة في ألبسة الناس ومساكنهم ومطاياهم، يحتوي كذلك على فرق واضح بين لغة الصعاليك والمترفين. فاللغة بهذا الاعتبار لا تختلف عن أيّ مظهر آخر من مظاهر التفريق الاجتماعيّ»، وهي مسئولة على هذا النحو عن تخلّف المجتمع أو تقدّمه بما تسهم فيه من فعاليات ذات طبيعة اجتماعية وثقافية تعود بالنفع الواضح والملموس والمنتج على راهن الحراك الثقافيّ والاجتماعيّ في المجتمع، فاللغة أداة اجتماعية للتعبير عن ثقافة المجتمع وطبيعته ورؤيته وليست هدفًا وصنعةً وترفًا، كما أنها ليست أداة للتمايز الطبقيّ والقهر الاجتماعيّ.
مَهمّة الأديب مَهمّة ثقافيّة حضاريّة
لا شكّ في أنّ منتج الأديب لا بدّ أن يرتفع أعلى من لغة العامة من أجل أن يكون أدبًا يتطلّع إليه جمهور القراء ويعجبون به ويتعلّمون منه، غير أنّ هذا الإعجاب لابدّ له من فائدة تعمل على تثقيف رؤية من يطّلع عليه، ويتفاعل معه، ويستنير به من أجل أن يرتفع بلغته ورؤيته إلى موقع أرفع يسهم في تطوير ثقافته، ويجعله في مقام أكثر قدرة على تحقيق الفائدة لمجتمعه، فمهمة الأديب مهمة ثقافية وحضارية رائدة على الصعيد الفكريّ والثقافيّ كما يرى الورديّ: «الأديب في اعتقادي رائد فكرة قبل أن يكون صانع ألفاظ. وأظنّ أنّ أبا حيان هو خير من يمثل هذا النوع من الأدب في العصور القديمة. لقد أخفق أبو حيان في حياته، لأنه عاش قبل أوانه. ولو أنه ظهر في زماننا هذا لكان سيد الأدباء»، وجاء اختياره لأبي حيان التوحيديّ مثالًا لأنه لم يستغلّ اللغة والبيان لتمجيد السلطة، وإبهاج السلطان، وكتابة تاريخ أدبيّ مزيّف للسلطة والسلطان، بل دعا إلى ثقافة شعبية يسهم في إنتاجها وتلقيها الناس جميعًا، فهو من جمع بين اللغة والحياة داخل حاضنة فكرية واجتماعية وثقافية واحدة، وقد شبّهه بالجاحظ وامتاز عليه في الوقت نفسه «كان أبو حيان يشبه الجاحظ في ثقافته الضخمة وفي سعة اطلاعه على مختلف نواحي المعرفة التي كانت رائجة في زمانه. وقد امتاز
أبو حيان بهذا على أدباء عصره الذين يفخرون باطلاعهم على أسرار اللغة ويجهلون أسرار الحياة».
إنّ مهمّة الأديب ليست مهمّة جمالية محضًا فحسب، بل هي فوق ذلك مهمّة ثقافية وحضارية لها مساس بحياة الناس وسبل عيشهم ومستقبلهم، فضلًا عن كونها وسيلة لجلب الشهرة للأديب مع ضمان حياة حرّة كريمة له، ويجب أن يحصل هذا التوافق المطلوب والضروريّ بين ريادة الفعل الأدبيّ لدى الأديب وإسهامه الحقيقيّ في تطوير المجتمع، وما يستحقه من حياة مرفّهة تليق بمكانته الريادية والقيادية الثقافية، ويرى الورديّ في هذا الصدد أنّ «كلّ إنسان يحبّ الشهرة. ولكنّ الشهرة لا تعطي خبزًا. والإنسان يطلبها لأنها وسيلة إلى ما يأتي من مال ونفوذ. ومن أبغض الأمور على الإنسان أن يكون جائعًا مشهورًا»، فالشهرة مع الجوع ليست أمرًا عادلًا لأنها تنطوي عند ذلك على خلل في المعادلة الحياتية، فالأمر الطبيعيّ أن يكون المجتمع عادلًا ويعطي كلّ ذي حقّ حقّه.
وفي التفاتة ذكية لها طابع ثقافيّ وفكريّ خصب وعميق، يرصد الورديّ نزعة التطرّف عند الكتّاب المحدثين، وهي نزعة كارثيّة على صعيد تأثيرها على المجتمع وتمزيقه والعودة به إلى أكثر العصور تخلّفًا وظلاميّة وجهلًا، ففي حين كان الكتّاب الطائفيون من أهل القرن الرابع يجاهرون بطائفيتهم فإنّ كتّابنا المحدثين يضمرونها، ولا يخفى على لبيب ما تجرّه الطائفية المضمرة من ويلات أكثر من الطائفية المعلنة، إذ يقول:
«مما يلفت النظر أنّ أهل القرن الرابع كانوا يفصحون عن نزعتهم الطائفية جهارًا ويتصاولون بها من غير تكتّم. أما نحن فقد اعتدنا أن نضمر الطائفية في أعماقنا ثم نتظاهر بأننا بريئون منها. وإذا كتب أحدنا أخذ يطلي نزعته الدفينة بطلاء برّاق من حبّ الحقّ والحقيقة. فهو يكتب كما تريد طائفته أن يكتب ثم يدّعي أنه يكتب من أجل إرشاد الناس وتنوير عقولهم».
إنّ هذه الالتفاتة النوعية منه تعبّر عن رؤية ثقافية بالغة الأهمية والخطورة، وتضع الأمور في نصابها على النحو الذي يعكس وعيًا متقدمًا في النقد الثقافيّ في إطاره العام، وهو يرى أنّ الأدب والفكر والثقافة وسيطٌ اجتماعيّ ذو أهمية بارزة لا يمكن فهمه ومقاربته والتعاطي معه من دون الكشف عن دوره في تثقيف المجتمع وتطويره وتحسين نظم حياته وعيشه.
عن مجلة العربي.

08-أيار-2021
31-كانون الأول-2021 | |
22-أيار-2021 | |
15-أيار-2021 | |
15-أيار-2021 | |
ماذا يحدثُ لجرّاحٍ حين يفتحُ جسد إنسانٍ وينظرُ لباطنه؟ مارتن ر. دين |
01-أيار-2021 |
22-أيار-2021 | |
15-أيار-2021 | |
08-أيار-2021 | |
24-نيسان-2021 | |
17-نيسان-2021 |
