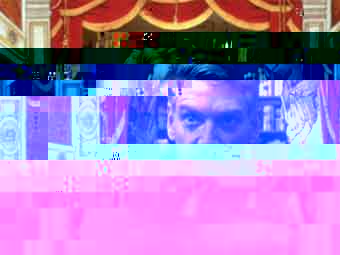
البرهان والعرفان في العرض المسرحي / تأملات في الممثل والمتصوف
خاص ألف
2009-05-29
إذا كانت الدراما بالمطلق هي أضداد وأسرار, فإنّ هذه الأضداد والأسرارمرهونتان لجنس خاص - أدبي وفني – هو المسرح, وهذه الأضداد والأسرار – في النص المسرحي -, قد شغلتا, أنتجتا, بأضداد وأسرار أخر, هي أضداد وأسرار العرض المسرحي, بكل معاييره الزمانية والمكانية, وبكل عمق معرفي وعرفاني بآن معا.
فإذا كان العلم – المعرفة والعقل -, يعتمد المنطق الرياضي والفلسفة والإدراك, وقيما فكرية وجمالية بذاتها, فإن المسرح, يعتمد مايعتمده العقل, ويضيف إليه العرفاني, الحدس, والإدراك عن طريق الحدس والذوق.
إن العلوم البحتة, وفي فرعها الأهم الفيزياء, تستخدم الرياضيات الحديثة, الدقيقة جدا, لتصوغ موضوعاتها وتفسيرها للوجود, والمسرح يستخدم الشيء ذاته, الفيزياء والرياضيات في شتى موجودات المسرح, من حيث الفضاء المسرحي – كحجم ومساحة ولون, وصوت وضوء وكتل-.
بيد أن الفضاء المسرحي, ليس كما وعلما, وتراتبا وانسجاما لكل موجوداته في عرض مسرحي ما, لمسرحية ما, بل إن المهم والأهم في الفضاء المسرحي هو: العلم اللدني , والمقصود هنا العلم الذاتي , والحدس الداخلي, لكل مبدع, ولكل خالق فنان, ساهم في صياغة العرض المسرحي بصورته النهائية, ابتداء من المخرج والممثل, ومصمم الديكور, والمؤلف الموسيقي, ومصممي الإضاءة والملابس...الخ. وكل هؤلاء أضافوا, من علمهم اللدني- الذاتي, ومن حدسهم الداخلي, صياغة خاصة للعرض المسرحي, صياغة فريدة, فيها من التجلي والكشف العرفاني, الأداة الأهم والأبرز, لهوية العرض المسرحي.
إن هاملت وماكبث وعطيل, ومسرحيات شيكسبير, ودائرة الطباشير القوقازية والأم شجاعة وبنادق السيدة كرار, ومسرحيات بريشت, والنورس والخال فانيا وبستان الكرز, ومسرحيات تشيخوف, ومسرحيات إبسن, وجورج شحادة, وبيكيت, وسعد الله ونوس......الخ, إن نصوص هؤلاء الكتاب العظام, قد قدمت كلها في مسارح شتى, في بقاع شتى من العالم, ولكن, لم يكن ثمة عرض لمسرحية من هؤلاء, يشبه عرضا آخر, لا, بل أكثر من ذلك, لم يكن ثمة عرض يشبه عرضا آخر, لذات المسرحية, ولذات المخرج والممثلين, وبقية الطاقم المسرحي, فكل ليلة, يختلف عرض هذه المسرحية, عن عرض الليلة التي سبقتها, أو التي تلتها... فثمة شيء مختلف كل ليلة, يبرز في التفاصيل الصغيرة, يبرز في روح الممثلين والتقنيين, فهم كل يوم هم في شأن, وكذلك عروضهم.
هذا الاختلاف هو شيء عرفاني, غير مرئي, لكنه موجود, لا يدركه المشاهد, لأن المشاهد يرى العرض لمرة واحدة, ويمضي, بل يراه ذاك الفنان المبدع لخلاق, الذي يدرك دياليكتيك الإبداع اليومي, ذاك الذي يعرف دياليكتيك الروح, والحدس والوجدان, وبكلمة, يدرك – أو يحس – الطاقة الروحية للعمل المسرحي بمجمله, والتي هي محصلة قوى لطاقات روحية مبدعة, تقدم كل ليلة, بل كل لحظة على خشبة المسرح, شيئا مختلفا عن العرض السابق, وعن بروفة الجنرال, حتى لو كانت, كلمات الشخصية ذاتها, ونبرة الإلقاء ذاتها, والميزانسين ذاته, والديكور ذاته وكذلك الإضاءة والموسيقى...الخ.
وثمة شيء آخر يضاف إلى الطاقة الروحية المشغولة في الفضاء المسرحي, ثمة الطاقة الروحية للمشاهدين, والتي هي محصلة قوى لطاقات روحية فردية, لكل مشاهد, تلك الطاقة التي يمنحها الجمهور, لطاقم المسرحية, والتي يحسها ويدركها – أحيانا – الممثل بالدرجة الأولى. كما لا يخفى على أحد, أن الطاقة الروحية للمشاهدين, تتأثر إلى حد بعيد – من حيث حرارتها وقوتها وتأثيرها – بطاقة العرض المسرحي الروحية, فهما يتبادلان الأثر والتأثير, ليكونا في النهاية, ذاك العرض الخاص, في الزمان والمكان المحددين, بكل فرادته وتفرده وسحره, أو بكل هزاله وكآبته وسماجته ورتابته, بكل خصوصيته.
إن المسرح, يأخذ من مدرسة البيان, ومن مدرسة العرفان, ومما يأخذه من مدرسة البيان واضح جلي, يعرفه كل من اشتغل في معمل مسرحي, أو ورشة مسرحية, أو مختبر مسرحي, أو استديو مسرحي.
أما مايأخذه المسرح من مدرسة العرفان, أو يشترك معها, في جوهرها وطبيعتها فهو أن الأحداث – الأضداد والأسرار – المدركة بالحواس, في منطقها الجدلي – الثابت والمتحول -, وارتباطها ببعضها بعضا – كعلة ومعلول – ليست سوى تجليات, إنها تجليات الصورة, تجليات المشهد, تجليات الروح والجسد فوق الخشبة المسرحية.
إنها صورة متبدلة متغيرة في كل ثانية من زمن العرض المسرحي, لكن هذا التجلي, هذه الصورة, ليست سوى صورة فنية للحقيقة, وليست الحقيقة ذاتها, ليست سوى تجليا لحقيقة العرض المسرحي – الشرطية أصلا - لكنها ليست الحقيقة, بمعنى أنها ليست حقيقية, وفي هذا يتقاطع فن المسرحية – من حيث كون هذا الفن صورة حية – مع نظرية وحدة الوجود العرفانية.
ونستطيع أن نستعير هذا التعبير, المصطلح, المفهوم, لنقول: إن الفضاء المسرحي, المسرح, العرض المسرحي, هو وحدة الصورة الفنية, الصورة التي يخال للمشاهد أنها هي, وليست هي, وهي هي, لكنها ليست هي. هي مرآة محي الدين بن عربي, هي إجابته لابن رشد بنعم, ثم أردف سريعا بلا النافية, فاكفهر وجه ابن رشد, بعد أن سمع بلا, وكانت أساريره منفرجة من سماع الجواب الأول, جواب نعم.
قد يستغرب البعض هذا الجمع – في فهم المسرح والوجود – بين نقيضين من التفكير, وقد يقول قائل: هذا جمع للأضداد, فكيف يمكن لفنان مسرحي مبدع, تسلح بالعلم البحت, والمعرفة الإنسانية المتراكمة عبر التاريخ, والخبرة الحياتية الخاصة, كيف يمكن أن يكون عرفانيا وعلمانيا بآن معا؟؟!!. وأقول: إن الفنان, أي فنان – وأعني هنا الفنان الحقيقي, وليس ذاك الفنان الذي يملأ الدنيا ضجيجاً وتفاهة, ويجلس على طاولة البازار, ليحصل على أكبر كم مالي ممكن, أو صاحب الأنا المتورمة, الذي يستعرض ذاته في الدور المسرحي, والذي يملك وصفات وقوالب جاهزة لكل الأدوار المسرحية التي لعبها, والتي لم يلعبها بعد, ذاك الفنان المسكون بجنون العظمة, أوالمصاب بالبارانويا, والذي يملك مفاتيح بوابات الحكمة, المهووس أو المنحرف جنسيا, وأخيرا ذاك الفنان الذي يؤمن, أن الكلمة طلقة, والمشهد قنبلة, والعرض المسرحي زلزال نووي, أو كتاب عقائدي مقدس...الخ – أقول: إن أي فنان, لا يكون كذلك, إلا بالصدق والسمو الروحي, ولا يمكن أن يكون مبدعا, مالم يدرك ويتذوق التأمل الحدسي الباطني الخاص به, ذاك الذي يأخذ به أخيرا إلى الفرادة والتميز.
الصدق والسمو الروحي, الذوبان في الناس كبشر,حب واحترام الآخر كفرد, كذات إنسانية, أي كوحدة من الوحدات المكونة للوجود, شأنه شأن الشجرة وقطرة المطر, والجبل والفراشة.. ذاك الفهم – الإيمان - للفنان, والفنان المسرحي على وجه الخصوص, هو العتبة الأولى, الدرجة الأولى في سلم الارتقاء الإنساني الجمالي والروحي.
وكما أن الفيزيائي يحتاج إلى مختبر حديث جدا, مجهز بأحدث التقنيات, ليتمكن من الدراسة والبحث والتأمل في ظروف نموذجية, فإن الفنان المسرحي أيضا, يحتاج إلى دراسة علم المسرح وأصول الدراما, وتاريخ الفن المسرحي, وإلى إطلاع واسع على الآداب والفنون الأخرى, المحلية والعربية والعالمية, وبشكل يومي, والأهم من هذا وذاك, أنه يحتاج إلى قلبه, إلى حدسه. وكلاهما, العالم والفنان, يحتاجان إلىالخلوة والتأمل, ليصلا عبرالمجاهدة والمعاناة إلى الكشف, هذا إلى كشفه العلمي, وذاك إلى كشفه الروحي.
يدرك الكاتب الأدبي – المسرحي, الروائي, الشاعر -, والفنان – المسرحي, الموسيقي, السينمائي, التشكيلي - أن التعمق في التفكير, هو نوع من التأمل, لكنه تأمل خاص جدا بالنسبة للأديب أو الفنان, وهو خاص جدا كذلك, بالنسبة لعالم الفيزياء, فالتأمل, والعمق في التأمل عند كليهما – العالم والفنان – يقود إلى إلغاء العقل أو تغييبه, أو توقيفه عن التفكير, رغم استمرار التأمل, ويحل محل توقف العقل, الحدس, كوسيلة للوعي غير المشخص, غير الموصف, في اللحظة ذاتها, وفي تلك اللحظة, يتوقف العقل عن المحاكمات العقلية الموصوفة, وعن المفاهيم المدركة – الحادة والصارمة – ويصبح الحدس, السيد المطلق, هو وسيلة الوعي والإبصار, بل يصبح وعيا خاصا, غير مدرك, ولا يخضع لآليات العقل, من حيث كونه تفكيرا يقظا ومدركا ومشخصا, بل يصبح كشفا بالمفهوم العرفاني, وهذا الكشف هو إدراك الوجود أو الموجود, وهذا ماسمته العرب, شياطين الشعر, وما حددت مكانه بوادي عبقر, وسماه ستانيسلافسكي – اللاوعي الخلاق – وهذا مادعى أرخميدس لأن يخرج عاريا, صائحا ببهجة: وجدتها, وجدتها, ومما دعى أبرز علماء القرن العشرين, انيشتاين, وبعد عمر مديد لأن يقول: (بقدر استناد القوانين الرياضية إلى الواقع, فإنها تكون غيرأكيدة, وبقدر ماتكون أكيدة, فإنها لا تستند إلى الواقع ).
إن معرفة الكثير من الظواهر العلمية اليوم, لا تستند إلى التجربة الحسية, وخاصة تلك الظواهر التي تخص عالم الذرة, وتلك التي تخص علم الفيزياء, بدراسته لطبيعة الضوء الثنائية, وبدراسته لطبيعة الأشعة الكهرومغناطيسية.
لقد حدثت تغيرات جذرية, عن فهمنا للزمان والمكان والمادة, وهذه التغيرات, أدت وستؤدي إلى تصور جديد عن الوجود, لم تنجز ملامحه النهائية بعد, لكن أولى هذه الملامح, يلج من باب وحدة الوجود, وهي نظرية أهل العرفان.
إن الممثل شأنه شأن المتصوف, يرتكز على اللغة, لغة الشخصية المسرحية, والتي تنتمي لواقع زماني ومكاني محددين, وهي تقول هذه الكلمات وليس غيرها, وهذا النسق والتنسيق من الحوار, وليس غيره, لأن ترتيبا دراميا – قصديا – صنعه الكاتب بهدف محدد, هو المقولة الرئيسية, التي يريد أن يؤكدها النص المسرحي أولاً. من هذا الفضاء المحدد, بمقولة النص, يصبح للممثل, الذي يتكيء بشكل أساسي ومهم على طريقة ونهج الصوفي, يصبح للممثل جناحين يطير بهما, ليرى الكل, لكن ضمن منظوره هو, كذات مبدعة, وكلما تعمقت ثقافة الممثل المعرفية, كان الأقدرعلى تجسيد الشخصية المسرحية, فهو بحكم ثقافته العالمية واطلاعه الواسع, يستطيع أن يربط بين سعيه الإبداعي, وسعي المخرج, وسعي بقية الطاقم المسرحي, ليمثل وحدة كاملة, داخل الكل الكامل, ليصبح صورة يتجلى فيها العرض المسرحي بكله,بروحه وشفافيته وسكونه, وصمته وصخبه, بفعله وإقدامه وانكماشه, بغضبه وسروره...
إن الممثل كما المتصوف لا يهرب إلى تأملات مجردة, في محاولاته الأولى للولوج إلى الشخصية المسرحية التي يريد أن يجسدها, إنه يعاني, والصوفي يكابد, للوصول إلى الحضور الفني, كما الصوفي الذي يسعى للحضور الإلهي.
وحين يصل تجسيد الشخصية المسرحية إلى الكمال – أو يكاد – يصرخ الممثل في لحظة ما: أنا ماكبث وماكبث أنا, أنا هاملت وهاملت أنا, بينما يبوح الصوفي: أنا الإله والإله أنا.
وبينما تسدل الستارة لآخر مرة في العرض المسرحي, يقف الممثل لينحني في مهابة الحضور الجماهيري, وقوته الروحية, ليسمع السيمفونية الأجمل, التصفيق اللاهب, وبريق العيون في الصالة, يصل الممثل ألى سعيه في الخلق, بينما يصل الصوفي, إلى سكينته, إلى صمته الذي هو البوح الأرقى في الحضرة الإلهية, ليكون خالقا ومخلوقا بآن معا, ليرى الوجود بعيني الخالق, ويلتقي ها هنا مرة أخرى, الممثل والمتصوف, فكلاهما, خالق ومخلوق بآن معا, الأول خالق ومخلوق بقطعة حياة هي المسرحية – في العرض المسرحي – والثاني خالق ومخلوق, في لحظة حياتية, تتصل بالوجود السرمدي, خلود الخلق وتجلياته وصيرورته.
إن الكلمات التي ينطق بها الممثل, وكذلك الصوفي, ليس لها تلك المعاني التي وضعها مؤلفو المعاجم والقواميس, إنها كلمات من مفردات اللغة – أية لغة كتب بها النص -, لكنها مشحونة بالعاطفة, بالمشاعر والأحاسيس, الناضجة في بيت نار الذات المبدعة, مشحونة بالروح, مشحونة من طاقة روحية, تشتد أو تفتر, تبعا للشغل الكثير في الصمت الكبير, في العزلة والتوحد والسكون العميق.
إن الكلمات مفتاح الرؤية, والرؤية مفتاح التأويل, والتأويل هوية, فهو خاص ومختلف وحقيقي, عند الممثل والمتصوف.
وإذا كان الصوفي يريد أن يعبر عن وحدانية الإله بشكل خاص, بشكل مختلف عن الآخرين, لاختلاف التجربة, ومقدار الحب والسعي, فإن الممثل أيضا يريد في المآل أن يعبر عن فرادته في تشخيص الشخصية المسرحية, فكم من ممثل جسد عطيل فأبدع, وأبان خصوصية جديدة في التعبير, أبان الخفي والمبطن في الشخصية المسرحية ذاتها – ستانيسلافسكي ولورانس أوليفييه في تجسيدهما لدور عطيل -, وكذلك الصوفي فهو يبين بالكلمات – عبر تجربته الروحية في المآل – ذاك الخاص عند الرب الإله.
الزمن والممثل والمتصوف:
وإذا كان الصوفي ينطلق من طهر أصيل إلى الحضور الإلهي، فإن الممثل ينطلق من صدق أصيل أيضا إلى حضور التجلي – التجسيد في العرض المسرحي، لكن في غياب الزمن، فالزمن غائب عند كليهما في لحظتي الكشف والحضور, رغم أن زمنا آخر حاضر هنا، والزمن الآخر هاهنا هو: لحظات متراكمة في المكان، لحظات ماهيتها الذوق والإلهام.
إن الممثل والمتصوف، يجاهدان للخروج، أو للهروب أوللانعتاق إذا شئتم من الزمن الحاضر، حاضر الممثل والمتصوف المحددين بمكانهما فوق ساحة صغيرة فوق البسيطة، إلى زمن آخر مختلف، زمن كوني آخر، ليس له بنية وشكل الزمن الراهن لكليهما، زمن ليس له بنية مركبة، وليس له بداية ونهاية كزمنيهما، أو زماننا، فالممثل يتكىء على نص مسرحي، وعلى أفعال ومشاعر تخص الشخصية المسرحية التي يجسدها على خشبة المسرح، بزمن مختلف في وحداته واستمراريته، فيما لو عاشت هذه الشخصية المسرحية في واقع حقيقي معاش، فالحب يحدث في لحظات، وانجاب الأطفال في دقائق معدودة، والقتل ليس له أية آثار بيولوجية أو سريرية، والحرب تبدأ أو تنتهي ببرهة. وكذلك المتصوف حين يعيش فيضه، أو يفيض عيشه، فرحلة الفيض عنده ليس لها زمان أو مكان، إلا إذا قيس زمنها من خارجه كذات متوحدة.
فثمة شطح زمني عند كليهما، فالشطح الزمني لايقاس بوحدة زمن العرض المسرحي عند الممثل، بل يقاس افتراضيا بأضداد وأسرار الشخصية المسرحية التي يجسدها، وبتراكم هذه الأضداد والأسرار، ومقاربة الزمن هاهنا شرطية وافتراضية بامتياز عند الممثل والمشاهد بآن معا.
أما الشطح الزمني عند المتصوف، فهو انتقال من حال زمني، إلى حال زمني آخر، لايشعر به، ولا يحسه، ولايدركه، رغم أنه زمن بالمفهوم الفيزيائي.
إن عالمنا ثلاثي الأبعاد، أي أنه يتكون من مكان وزمان وكتلة، والكتلة لها أبعاد ثلاث هي: طول وعرض وارتفاع، والمكان له أبعاد ثلاث أيضا هي: طول وعرض وعمق، وهنا نتسائل: هل للزمان أبعاد ثلاث أيضا؟؟. نقول: نعم، وأخمن أن أبعاد الزمان هي: الكتلة والحركة وأنا، أو نحن. أما الزمن الكوني، فهو شأن آخر، هو شأن الرجال الآخرين، علماء الفيزياء، الذين يدرسون الكون متأملين نشأته، ماضيه وراهنيته وصيرورته. يقول انيشتاين: ( إن هذا الكون الزماني المكاني، هو مجمع ماكان، وماهو كائن، وما سيكون، وهو أشبه شيء بكتاب أو لوح دونت فيه الحوادث، ما مضى وماهو آت ). أما جون ويللر فيقول عن الكون والزمن: (جنبا إلى جنب مع كوننا جزء منه، يوجد سوبر مكان – أي كون فوق الاعتيادي - في ذلك الكون تنعدم مفاهيم الزمن والسرعة كما هي مفهومة لدينا, ففي هذا الكون العجيب ليس لمفهوم الزمن أية قيمة، كما له عندنا،وكلمات ماض، مستقبل، قبل وبعد لا معنى لها هناك ).
إن انيشتاين يتحدث هنا عن قدر الكون، أما ويللر فيتحدث عن مفاهيم أخرى للزمن، مفاهيم غير مدركة بالنسبة لنا، لأن إدراكنا محدود.
والممثل والمتصوف في هذا السياق , ينطلقان من مقولتي انيشتاين وويللر، فأضداد وأسرار الشخصية المسرحية قدرية، قدّرها الكاتب المسرحي، وصقلها المخرج برؤيته الإبداعية، وزمن الشخصية المسرحية غير مدرك. أما المتصوف فالقدرية ركن هام من أركان إيمانه، والزمن في فيضه ليس له أبعاد، ولا يعيشه بعقله أو جسده، بل بذوقه. ويدركه المتصوف فقط حين يقرأ ويتأمل كتابه المقدّس, فيلاحظ أنّ قرآنه لم يتضمن كلمة الزمن إطلاقا، وإنما وردت فيه كلمة الدهر، في أولى سورة الإنسان، فيقرأ: ( هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا)، والصوفي يؤمن بقول التنزيل: ( إنّ يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون ).
وللزمن عند الممثل والمتصوف خواص منبثقة، أي أنه يظهر عند مستوى محدد، دون أن يظهر في مستويات أخرى، فهو عند الممثل متقطع، طويل، والإحساس به متبدّل في بداية تعرّف الممثل على الشخصية المسرحية، وكذلك في بداية البروفات، وتنفيذ الميزانسين، أما الزمن في العرض المسرحي، فهو زمن آخر مختلف، لأنه انبثق من تراكم جهد وحس وتأمل، إنه زمن الشخصية المسرحية، زمن الصورة الفنية، زمن المشهدية، زمن الصراع المضغوط والمكثّف، زمن الحب الجميل، والفرح، أو الحزن الكئيب، لكنه زمن مختلف عن زمن الممثل، بكونه إنسانا يلعب، أو يجسّد، ويختلف عن زمن المشاهدين ، وهاهنا ثمة أزمنة انبثاقية، لأنها – الأزمنة – ابنة مستويات مختلفة، ابنة عناصر مختلفة، فطعم الحلاوة في مادة السكر, ليس موجودا في مكوناته، ومكوناته الكربون والهيدروجين والأوكسيجين، وهذه المكونات اتحدت بمقادير محددة وأعداد محددة، لينتج عنها مادة السكر. وهاهنا يسطع الدياليكتيك الرائع، الذي ينبؤنا، بمقولة التراكم الكمي الذي يؤدي إلى تغير كيفي، والتراكم هاهنا محسوب بقدر معلوم، فمكونات السكر هي ذاتها مكونات الكحول، الذي يختلف طعما ولونا ورائحة وبنية وشكلا ووظيفة، عن السكر. والسر في الأعداد، أعداد ذرات الكربون والهيدروجين والأوكسيجين، السر في العدد أو الأعداد، لذا يولي المتصوف علم الأعداد الأهمية الفائقة، ويعتبر أن الأعداد والحروف علوم، لايمكن إدراكها إلا بالكشف، والكشف يودي بالمتصوف إلى أن يرى أن الواحد ليس عددا، والألف ليس حرفا، والكشف والتجلي لايتحصّلان إلا بالسمو الروحي.
والممثل المبدع يعرف جيدا دياليكتيك الزمن، بانتقاله وتغيره – أي الزمن – من مستوى إلى آخر، فزمن عطيل قبل إياغو يختلف عن زمنه بعد إياغو، وزمن حب ديدمونة، يختلف عن زمن خيانتها المتوهمة من قبل عطيل، وحال وزمن جلجامش قبل موت أنكيدو، هو غير حال وزمن جلجامش بعد موت أنكيدو، وزمن حال ماكبث قبل نبوءة الساحرات، مختلف عن زمن حال ماكبث بعد النبوءة، وقد انبثق زمن آخر حين أعلن هاملت: ( نكون أو لانكون)، وكذا زمن حال أوديب وأنتيجون، وشخصيات موليير وراسين، وتشيخوف، وبيكيت وإبسن، وأليخاندرو كاسونا، ولويجي بيرانديللو، وبيكيت وهارولد بينتر، وبيرنارد شو وبرتولد بريشت، وسعدالله ونّوس، وجورج شحادة ومانويل جاليتش.
يقرر البرهان، العلم، أن الكون هو تبادل الطاقة في المكان، في كون لانهائي، والطاقة هي طاقة الفراغ، الذي يبدو للوهلة الأولى، الكون، فراغا، لكن هذا الفراغ ليس فارغا، بل هو مملوء حتى التخمة بالطاقة، وكمثال بسيط يورد علماء الفيزياء، أن خمسة ملايين نيوترون شمسي عالي الطاقة، تمر عبر سنتيميتر مربع واحد من جسم الإنسان، في الثانية الواحدة. فهل ثمة فراغ في هذا الكون الذي شبهه الفيزيائيون المحدثون، بفقاعات من الرغوة المتداخلة والمتوضعة فوق بعضها بعضا؟؟.
وهل ثمة فراغ في العرض المسرحي؟؟ أو في أضداد وأسرار الشخصية المسرحية؟؟ وهل ثمة فراغ عند الممثل في أداءه على الخشبة؟؟ وهل ثمة فراغ في تأمل المتصوف، وفي مكابدته ومجاهدته، وفي فيضه وكشفه؟؟.
إن إبداع الممثل وفيض المتصوف، لايأتيان من فراغ، كما الكون الذي نعيشه، أو الذي لانعيشه، فكل لحظة من حياتنا، ومن حياة الممثل، على وخارج خشبة المسرح، وكل لحظة من حياة المتصوف مليئة بالطاقة، إنها طاقة مادية في المآل, ولكنها مشحونة، ليس بالكهروكيمياء فحسب، بل بالمشاعر والأحاسيس والأخلاق والقيم.
مطابقات متفارقة ومفارقات متطابقة عند الممثل والمتصوف:
والممثل والمتصوف على نقيضين في شغلهما، فالمتصوف ينطلق من الإيمان إلى المعرفة، لذا سمي العارف، أو العارف بالله. أما الممثل فينطلق من المعرفة إلى الإيمان، فالممثل يبحث ويفتش، ويقرأ ويحلل ويستنتج ليلج إلى الشخصية المسرحية، وليصل إلى الإيمان بها، لكنه –أي الممثل – مؤمن أن المسرح أداة تنير درب مشاهديه، وتدخل إلى قلوبهم المسرة والبهجة والمتعة، وإلى عقولهم الفائدة والحكمة، وهم في المآل يحذون حذو البطل النموذج، ويدينون النمط المسطح، التافه والقبيح. والمتصوف يعرف قبل أن يؤمن أن إيمانه سيأخذ به إلى التجلي والفيض والتوحد. وبعبارة أخرى: إن الممثل يؤمن قبل أن يؤمن، والمتصوف يعرف قبل أن يعرف. ووحده المشاهد، يعرف أنه لايعرف، قبل العرض المسرحي، ولايعرف أنه يعرف بعد العرض المسرحي.
وإذا كان الصوفي يصل, في لحظات نادرة ومميزة, ليكون الشاهد والمشهود, في الحضرة الإلهية, فإن الممثل المبدع, يعيش تلك اللحظات على خشبة المسرح, ليكون الفاعل والمفعول, الشاهد والمشهود أيضا, فهو الممثل ذاته, لكنه في نفس الوقت ذاته هو الشخصية ذاتها, وهو الشخصية ذاتها, لكنه الممثل الذي نعرفه ذاته.
ويتبادل الصوفي والممثل الأدوار, فإذا كان الممثل بشغله على الدور المسرحي ينطلق من الغرابة والغموض ليكون ثمة – على الخشبة – الجدة والابتكار والإبداع في العرض المسرحي, فإن الصوفي ينطلق بعكس ماانطلق به الممثل, إذ ينطلق الصوفي, من الجدة والابتكار في مكابدته ومجاهدته, ليصل إلى الغرابة والغموض فيما ينطق به.
وكلاهما يصل إلى مفردتين قد تبدوان متناقضتين. فالصوفي يصل إلى الشطح والممثل إلى الإبداع, لكن الممثل ينطلق من الشطح الفني إذا جازت التسمية إلى الإبداع, وهو في شغله المسرحي, أثناء البروفات, وفي البيت, في لحظات التأمل العميق للشخصية المسرحية, يستطيع أخيرا أن يمسك بمفاتيح الشخصية, المفاتيح الجسدية والروحية والعاطفية, مفاتيح الأضداد والأسرار. يصل أخيرا إلى ذات إنسانية محددة, تمور بالمواقف والمشاعر والانفعالات.
وكلاهما ينهلان من الفيض, الذي يشاهده ويسمعه المتلقي أخيرا, فيدهش– هذا الأخير– لما أنجزه الممثل, ويستغرب, أو ينكر مانطق به الصوفي , والاستغراب ,والإنكار أحيانا , هو الدهشة , والدهشة حضور وفيض جديد للمتلقي , الذي ينعقد لسانه , حين يدرك , أو لايدرك , أن الألف ليس حرفا , والواحد ليس عددا.
والممثل والمتصوف على نقيضين , فالأول يعمل جاهدا إلى التجسيد , تجسيد الشخصية المسرحية التي يلعبها , فالشخصية تتجسد فيه , بحيث يخال للمشاهد , أن الممثل هو هاملت فعلا أو فاوست... ويكاد الممثل أن يفخر بنفسه ليعلن أن :هو أنا .. أما المتصوف فيسعى جاهدا إلى الحلول , أي أن يحل الله فيه , بحيث يبوح أن : أنا هو . وما بين زهو الممثل ب: هو أنا , وبوح الصوفي ب : أنا هو , طريق طويل يقطعه كليهما , وصولا إلى الانصهار , انصهار ذات في ذات , وهاهنا وجه التطابق في المآل , في نهاية المطاف.
والممثل والمتصوف على نقيضين أيضا , في ميكانيزم العمل , السعي , فالممثل ينطلق من المجرّد , الشخصية المسرحية على الورق , إلى المحسوس والملموس , الشخصية المسرحية على الخشبة , أما الصوفي فيتخذ سبيلا آخر , فهو ينطلق من المجسد الملموس إلى المجرد , الممثل ينطلق من ذات غائبة إلى ذات حاضرة , أما المتصوف , فينطلق من ذات حاضرة إلى ذات غائبة.
والممثل والمتصوف على نقيضين آخرين , فالممثل في تجسيده للشخصية المسرحية , يجسد وله موقف شخصي من تلك الشخصية , مع أو ضد , ويجسد وثمة رؤية فكرية وجمالية تأخذ بناصيته أو يأخذ بناصيتها , أما المتصوف فيسعى إلى الوقفة في الحضرة الإلهية بلا موقف , فثمة اندغام عنده بين الرؤية والرؤيا , والموقف عند المتصوف هو الحضورفي الحضرة , هو التماهي , بل هو الحلول , والاتحاد مع الذات الإلهية , وعند كبار المتصوفة , لو قال الصوفي رأيت ربي , اتهم بالتقصير في سعيه , فتأخذهم الريبة في صاحبهم , لأن قول رأيت ربي , يعني في المآل أن ثمة مسافة , في المكان , بين الناظر والمنظور , وهذه المسافة المتبقية هي التقصير بذاته , ففي الفيض الحق ليس ثمة مسافة بين الناظر والمنظور.
والممثل والمتصوف على نقيضين , فالحوار , المونولوج أو الديالوج , على الخشبة ليس حوار الممثل , ولايدل عليه , والأحداث على الخشبة , الأضداد والأسرار , لاتعني الممثل لامن قريب , ولامن بعيد , في حياته الشخصية , إنها تعنيه فقط , خلال زمن العرض المسرحي , وهذا الزمن هو زمن العمل الإبداعي , وهو , أي العمل الإبداعي , بالنسبة له , هو نشاط إنساني , يريد من خلاله أن يشارك الناس حيواتهم , وأن يشاركوه آراؤه ورؤاه , أما المتصوف , فالحوار في بداية طريقه كسالك , يأخذ منحى واحدا , هو حواره مع ربه , ومضمونه الرجاء والحب , أو الحب والرجاء , على أن يسود الحب أخيرا بين المحب الصوفي والمحبوب الله , لكن في نهاية طريق السالك , يتم تبادل الأدوار بين المحب والمحبوب , فيصبح المحب محبوبا ويصير المحبوب محبا , والحوار هاهنا , حوار محب ومحبوب , لكنك لاتميز أيهما المحب وأيهما المحبوب . والصوفي يحب كل ما أبدعته يد محبوبه , وتجليات الإبداع هنا,محصورة بالكاف والنون,بفعل الأمرالصادر عن الذات الإلهية كن ,والذات الإلهية كل يوم في شأن , أما الممثل فلا يحب كل ماصدر , ويصدر , عن الشخصية المسرحية التي يجسدها , فثمة رؤية نقدية لما تقوله وتفعله , ومايصدر عنها من مشاعر واحاسيس , وفعل ورد فعل , رغم أنه , أي الممثل , وعلى الخشبة , هو الذي يقول وهو الذي يفعل , هو الخطيب والمخاطب.
والممثل والمتصوف على نقيضين , فالممثل يعمل في دائرة غفلة الصوفي , والصوفي يجاهد ويكابد ويسعى في دائرة غفلة الممثل. فالممثل يعمل في دائرة الحياة وفي الجزء الأهم منها , الجزء الذي يكون فيه الإنسان مستيقظا , أما المتصوف فيعتبر أن دائرة اليقظة , هي الموت , فهو يقول : الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا , أما الممثل , فإن نوم الناس , في مفهومه , هو غفلتهم , هو رؤيتهم القاصرة , تقاعسهم عن أداء الواجب الإنساني , ونصرة الحق , غفلتهم هي الخضوع للظلم وللإستلاب , والركون إلى الغربة الداخلية والسأم والملل والعفن الروحي , وعيشهم في بؤس جسدي أو روحي , أو جسدي وروحي بآن معا . والنجاة والخلاص يكمنان بالعمل الجماعي , بالنشاط الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والجمالي , أما المتصوف فخلاصه فردي , ميتافيزيقي , إنه يتلهف لنهاية حياته الأرضية , ليرحل إلى حياة برزخية , ومن ثم سرمدية , ماورائية . أما الممثل فخلاصه في خلاص الجماعة , لأن كينونته متحققة بالجماعة , وهو يتلهف لتبدأ الحياة الجديدة , حياة مختلفة ومغايرة , لحياة القحط واليباس التي يسببها البشر للبشر.
وإذا كان للممثل أدواته الإبداعية, فإن للصوفي أدواته للاتصال, وأدوات الصوفي هي: عبارات الاتصال الإلهي. ولكن إذا كانت الأدوات الفنية معروفة, فهي في بطون الكتب المسرحية, وكتب علم الجمال, وهي منثورة على قارعة الطريق, في بيانات مسرحية, ووثائق وشهادات لتجارب ومناهج مسرحية مختلفة هنا وهناك, وإذا كانت عبارات الاتصال الإلهي أيضا مبثوثة في كتب الله, وعلى ألسنة أنبيائه وعلماءه وقديسيه والعارفين به, وأصحاب الطرائق, إلا أن تلك الأدوات والعبارات لا تنفعان – لا الممثل, الفنان, ولا الصوفي – مالم يكن الصدق الصافي والإخلاص الحق, والروح الهائمة, والقلب النابض, والمشاعر اللاهبة, والتوق الذي لا يتوقف, لينجز كل منهما مهمته, للتعبير عن الجمال, وبيان بؤس القبح, للوصول إلى الكمال فوق الأرض, كمال العدل, وكمال التجلي والجمال, والسعي لصنع شيء ما في سبيل ذلك كله.
إن التجلي الإبداعي ليس له وقت, إنه يولد أحيانا في لحظات التأمل العميق, وأحيانا كثيرة يتوالد بالتداعي, لكنه التداعي المستقر في التأمل والصدق الحار. ونسوق هنا مثالا مطولا نسبيا على لحظة التجلي بالتداعي, فيما أورده ستانيسلافسكي أثناء اشتغاله, مع مجموعة (مسرح موسكو الفني) على مسرحية الشقيقات الثلاث لأنطون تشيخوف – في مقالته المعنونة (تشيخوف في المسرح الفني) من منشورات دار التقدم بموسكو – يقول:
(وأثناء أحد تلك التدريبات المضنية وقعت حادثة طريفة أود أن أرويها. كان ذلك مساء. ولم يكن العمل يسير بشكل موفق. وتوقف الممثلون دون أن يكملوا حديثهم, وكفوا عن التمثيل إذ أدركوا عدم جدوى التدريب. لقد تحطمت الثقة في المخرج وفي بعضهم البعض. ومثل هذا الهبوط في النشاط يعتبر بداية الانحطاط المعنوي. وجلس الجميع في الأركان ولزموا الصمت في كآبة. وأضاءت لمبتان كهربائيتان أو ثلاث بضوء كاب, فجلسنا في شبه ظلام. ودق قلبي من القلق ووضعنا اليائس. وراح شخص ما يخربش الأريكة بعصبية فصدر صوت أشبه بصوت فأر يخشخش. ولسبب ما ذكرني هذا الصوت بالجو العائلي الأليف, فأحسست بالدفء في قلبي وأدركت الصدق والحياة, فبدأ حدسي يعمل. أو ربما كان لصوت الفأر المخشخش في اتحاده بالظلام والعجز مغزى في وقت ما من عمري لا أدري عنه. فمن ذا الذي يحدد طرق ما فوق الوعي الإبداعي!
ولهذا السبب أو ذاك أحسست فجأة بالمشهد الذي نتدرب عليه. فأصبح الجو مريحا على خشبة المسرح. ودبت الحياة في شخصيات تشيخوف. فاتضح أنهم ليسوا منشغلين بحزنهم, بل بالعكس, يبحثون عن المرح والضحك, والحيوية... إنهم يريدون أن يعيشوا لا أن يحيوا حياة بلادة وخمول. وأحسست بالصدق في هذه النظرة إلى أبطال تشيخوف فبعث ذلك فيّ الحيوية وأدركت بالحدس ما ينبغي عمله.
وبعد ذلك حمى وطيس العمل من جديد. ولم يتعثر إلا دور ماشا الذي كانت تؤديه كنيبر, ولكن فلاديمير نيمروفيتش- دانتشنكو اهتم بها, وخلال التدريبات التالية تكشف لها أيضا شيء ما في روحها, فأدت الدور بروعة).
وببساطة نلاحظ فيما أورده ستانيسلافسكي, كيف اختلفت زاوية الرؤية – التأويل – إلى شخصيات تشيخوف من الإشراق الشخصي, الذي كان مستقره التداعي والحدس, وقد بثت الروح الجديدة في كل طاقم العمل المسرحي إلا الممثلة كنيبر, وكنيبر بالمناسبة هي زوجة الكاتب العظيم تشيخوف, وبتدريب دانتشنكو المكثف, وصلت كنيبر إلى الروح الجديدة – الرؤية – لعرض (الشقيقات الثلاث).
وستانيسلافسكي، يكاد أن يكون الرجل الأهم في تاريخ المسرح، وهو رجل من أهل البرهان، وشيخهم الأكبر في المسرح العالمي، يتكيء هنا على العرفان، في مخاض الولادة الإبداعية، إنه يضبط لحظة بزوغ الإبداع، وهي لحظة إشراقية بكل تفاصيلها ومكوناتها.
وبالمقابل فإن رجلا من أهل العرفان، وهو شيخ المتصوفة الأكبر، محي الدين بن عربي، يسوق في كراسه: ( لايعول عليه ) عبارات تكاد أن تكون أسسا لأهل البرهان، وخاصة أولئك الذين يشتغلون بأرواحهم وأجسادهم في العروض المسرحية. وكما أوردنا سالفا، ماكتبه ستانيسلافسكي عن التجلي الإبداعي، أثناء الشغل على مسرحية ( الشقيقات الثلاث ) لتشيخوف، فإننا نورد هاهنا ماكتبه الشيخ الأكبر، من آراء، وتكاد أن تكون نظريات في الكثير منها، تكاد أن تكون نظريات فيما يمكن أن نطلق عليه، علم جمال المسرح، أو نطلق عليه وصايا لعمل الممثل، أو أصول الدراما، أو عناصر الصورة الفنية في المسرح، لنتأمل الأورجانون الصغير لابن عربي، ولنتفكر فيما كتب:
ü كل مشهد لايريك الكثرة في العين الواحدة لاتعوّل عليه.
ü الحكمة إذا لم تكن حاكمة لايعوّل عليها.
ü الخوف إذا لم يكن سببه الذات لايعوّل عليه.
ü المخالفة إذا لم تكن عن مقابلة لايعوّل عليها.
ü كل جسد لاينتج همّة فعّالة لايعوّل عليه.
ü المكان إذا لم يكن مكانة لايعوّل عليه.
ü التلوين إذا لم يشاهد في الأنفاس لايعوّل عليه.
ü كل فن لايفيد علما لايعوّل عليه.
ü التجلي المتكرر في الصورة الواحدة لايعوّل عليه.
ü جميع مايردعليك وأنت تجهل أصله لاتعوّل عليه.
ü كل إرادة لاتؤثّر لايعوّل عليها.
ü كل ذوق لايكون عن تجل لايعوّل عليه.
ü كل بداية لايجري إليها صاحب النهاية لايعوّل عليها.
ü كل نهاية لايصحبها حال البداية لايعوّل عليها.
ü المعرفة إذا لم تتنوّع مع الأنفاس لايعوّل عليها.
وهكذا فإن المسرح العالمي, وهو يحبو خطواته الأولى في القرن الواحد والعشرين, يؤكد أنه كان ولازال وسيبقى, ذاك العالم الرائع, الذي يأخذ من مدرسة البيان, ويجتهد في مدرسة العرفان, فهو يخلق عروضا مسرحية فيها من العلم والعقل, ماهو مقبول من أيام الإغريق, وفيها من صراع الأضداد والأسرار الإنسانية, ماهو جدلي وخلافي ورائع وسام, كان ولا زال وسيستمر, لأن موضوعه الإنسان, والإنسان جزء من هذا الوجود في وحدته, تجاذبا وتنابذا, وفيها – في العروض المسرحية – ذاك الخلق العرفاني, ذاك الحدس, حدس الفنان المبدع, الذي يصبو إلى الجمال ويصنعه, ذاك الحدس الذي يصدر من روح الفنان المرهف, الذي يخلق كل ليلة لمشاهديه ذاك الألق الإنساني, الألق الحلم, للانعتاق من الانكسار, الانكسار السيزيفي والأوديبي, والذي استمر إلى اليوم بموضوعات وبأشكال وصور شتى, وسيستمر. والمسرحي بكشفه وبصيرته, بصدقه وبسموه الروحي.. يمنح الآخرين الأمل, الأمل بالعيش في عالم رائع, عالم بلا حروب, ولاجوازات سفر.
حمص- نيسان- 2008

08-أيار-2021
22-أيار-2021 | |
13-أيار-2015 | |
البرهان والعرفان في العرض المسرحي / تأملات في الممثل والمتصوف |
29-أيار-2009 |
22-أيار-2021 | |
15-أيار-2021 | |
08-أيار-2021 | |
24-نيسان-2021 | |
17-نيسان-2021 |
