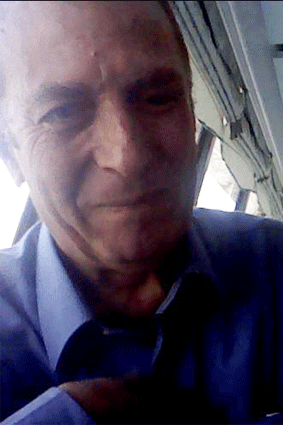
الحنين حكاية عودة ـ ح1
خاص ألف
2010-10-27
الحنين، حكاية عودة هو أخر ما نشر من كتب فيصل حوراني. صدرت منه طبعة خاصة عن دار كنعان في دمشق ، يعيد موقع ألف نشر هذا الكتاب على حلقات حصريا على النت بالاتفاق مع الكاتب
1
أخرجت من فلسطين وأنا في العاشرة بعد سنة من التطوح على الدروب الممتدة بين المسميّة التي ولدت فيها وغزة التي ألجأتني إليها ظروف 1948. ومنذ ذلك الوقت، عشت في المنفى وكابدت ما يكابده المرغم على الابتعاد عن وطنه وكواني الحنين. غير أن أوجاع الغربة لم تشتد في أي وقت بمقدار ما اشتدت بعد أن لاحت فرصة العودة إلى فلسطين وعاد نفر من أصحابي فعلا وصرت أنا في أحاديثهم صاحبهم الذي بقي في الغربة.
ست وأربعون سنة، بل سبع وأربعون، جسد سابح في فضاء لا أرض له، وروح هائمة في الضيق كأنها جنّي يتنقل وهو محبوس في قمقم. الذراع جناح. والساق مجداف. والدروب متشعبة. درب يبعدني عن خطر. ودرب يوصلني إلى خطر آخر. ومفاصل العمر ترسمها المرائب ومحطّات القطارات والموانئ والمطارات. والمآوي جميعها مؤقتة. لم أتوقف عن التنقل إلا حين كان يحتجزني قرار حظر السفر من بلد أو يشملني حصار. وعلى كثرة ما تنقلت، لم يكن لي مكان واحد أقيم فيه وهو يخصّني فأشعر نحوه بالولاء، ولم أختبر ظرفا اخترته أنا بإرادتي فأهنأ به. ست وأربعون، بل سبع وأربعون، تبدّلت الأماكن خلالها بأسرع مما تتبدّل الأماكن في الأفلام، وتعاقبت الظروف بأعجل مما تتعاقب في الحكايات. فهل كان غريبا بعد هذا الذي طال أمده أن أضيق بأي مكان حتى وهو أجمل الأمكنة وأيّ ظرف حتى لو كان أدعى الظروف إلى الانشراح!
كنت ما أكاد آلف مكانا وأتعرف على ناسه حتى أجدني مرغما على الابتعاد ومكابدة أوجاع الفراق، فصرت أقتصد في الاستجابة للألفة أو أتجنبها. وما أكثر ما أقمت في أمكنة ثمّ رحلت عنها دون أن يبقى لي منها ما يشدّني إليها. مئات الناس، بل ألوفهم تعرّفت عليهم في بلد أو غيره، وعشرات المحافل، بل مئاتها، والعديد من مقرّات العمل وزملائه، وما لا عدّ له من العلاقات، فماذا بقي لي من هذا كلّه، لم يبق في واقع الأمر إلا ما له صلة بالشأن الذي أنشغل به، الشأن الذي يكاد يكون هو الوحيد الذي يشغلني: الوطن الذي أبعدت عنه وناسه، المكان الذي حُرمت من العودة إليه والناس الذين أتوق إلى الاختلاط بهم.
جُبت عوالم الشرق والغرب، لم تبق جهة لم أزرها. ركبت إبل العرب، وبغال الأتراك، وخيل المغول، وأفيال الهنود. تفرجت على القرود وهي تتقافز بين الأشجار، والأفاعي وهي تتلوّى في سلال الحواة. وشهدت مصارع ثيران وديوك. أنزلت سنّارتي تحت الجليد في نهر موسكو. وتجوّلت في سوق السمك في شاتليه باريس وراقبت بائعاته اللواتي يتحولن في الأماسي إلى بغايا. طفت في المتاحف ومعارض الفنون والمكتبات العظيمة. وقصدت مواقع الآثار في كل مكان يخطر ببالكم. وشاهدت أعظم العروض في أعرق المسارح. واستمعت إلى أمهر العازفين. قابلت شتى أصناف الناس، عوامّ ونابهين، ثواراً ومحافظين، مستقيمين ومنحرفين. وألفت أذناي جرس لغات عديدة. خبرت المدهشات حتّى لم يعد شيء يدهشني. فماذا بقي. لا شيء إلا أن يكون مما له صلة بحكاية حكاياتي كلها. وحكاية حكاياتي هذه تتلخص في حاجتي إلى مكان يخصّني، مكان أشعر نحوه بالولاء، أحس بأن فيه ما يخصني.
الذين قذفوني إلى خارج قريتي المسميّة ثمّ إلى خارج وطني كله وأنا طفل، ظلوا يطاردونني بينما أنا أكبر، شاؤوا أن أبتعد عن الوطن أكثر فأكثر، ظنّوا أنّي سأنسى حاجتي إلى العودة بمقدار ما أبتعد وسأيأس إذا طال الفراق. غير أنّي، أنا المطارد، ظللت أطارد حاجتي، لم أنسَ الوطن، ولم أيأس، ولم أكفّ لحظة عن تنمية الأمل بالعودة. أسكنتُ وطني في روحي، فَرَدتُ له مساحة الرّوح وفيها نمّيتُه كما ينبغي لأي وطن أن ينمو، وجمّلته. وهل يمكن لوطن الروح إلا أن يكون دائم النموّ وجميلاً. ونقلت وطني معي كلما انتقلت. لم أعش في الغربة دون رفيق، فقد ظل المتوطّن في روحي هو رفيقي الدّائم. ولأنّ من أقصاني عن وطني قد أقصى وطني ذاته عن وطنه، فقد عشنا معاً، غريب ووطنه الغريب. في الغربة، عشت مع الوطن؛ اللاجئ يعيش مع وطنه مادام محروماً من العيش فيه.
لن أروي لكم حكايتي في المنفى، فقد رويت جلها في ما كتبت، وما تجهلونه منها مماثل لما تعرفونه من غيرها يكاد لا يزيد عنه ولا ينقص، وأنا لست من هواة التكرار. ولن أزيد أثقالكم بالحديث عن الآلام التي كابدتها منذ فاجأني اتفاق قيادة منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل، هذا الذي اشتهر باسم اتفاق أوسلو. ولعلّ بينكم من يعلمون أني عارضت هذا الاتفاق. وأنا لم أعارضه لأني ضد الاتفاق مع العدو إذا وفر الاتفاق أسساً لحلٍّ عادل ومستقرّ، فقد ثابرت منذ احترفت الكتابة على الدّعوة إلى مثل هذا الحلّ، حتى حين كان معظم الفلسطينين ضد أي حلّ. بل عارضت لأني لم أجد في اتفاق أوسلو ما يوفر أسس العدل أو الاستقرار. امتص الاتفاق كل قطرة في ضرع القيادة الفلسطينية، وكبّل هذه القيادة بحزَم من القيود، وأوجب عليها أن تلغي سلاح الانتفاضة، ولم يقدّم لها مقابل هذا غير وعود غامضة، قبض ريح لا يملأ أي يد. فهل كان بإمكاني، أنا الذي احترف الدعوة إلى حل تستقر به الأحوال، إلا أن أعارض الاتفاق الذي رأيت أنه يبعد المنهمكين في الصراع عن مثل هذا الحلّ.
و لكم أن تعرفوا أني لم أجهر بمعارضتي فور إعلان الاتفاق، لم أنشر رأيي، بل قلت لنفسي: تقدم بك العمر، والذين يطلعون على رأيك قد يتأثرون به، وهذه خطوة ليست مثل أي خطوة سابقة، فالاتفاق يؤثر على مصير الشعب الفلسطيني لأجيال عدّة وأنت من هذا الشعب، فلا يجوز أن تصدر حكمك بخفـّة، لا يجوز أن تحكم على الاتفاق بتأثير الانطباع العاجل، ولا يجوز خصوصا أن تنشر رأيك قبل أن تحصّنه بالبراهين وتتيقـّن من صوابه.
منذ نشر الاتفاق، قرأته، وكرّرت قراءته. لم أثق بالترجمة، فقرأت النصّ المعتمد، هذا المكتوب بالإنجليزية، واستعنت بمن هم اخبر منّي في اجتلاء دلالات النصوص. وتابعت الأنباء والتعليقات. وتقصّيت وجهة نظر المؤيدين والمعارضين. والتقيت من أعرفهم ممن فاوضوا الإسرائيليين، الذين فاوضوا على مسار مدريد العلني في ظل الرعاية الدولية له والذين فاوضوا على المسار السرّي الثنائي في أوسلو، هذا الذي لم يُقِرّ أي طرف دولي بأنه رعاه. ولمّا كان كثيرون ممن فاوضوا هم من أصحابي، فما أيسر ما استقصيت التفاصيل وتفاصيل كل تفصيل!
وفي سياق الاستقصاء، ظفرت بخلوة مع ياسر عرفات، القائد الذي تعدّدت ألقابه فلم أعد أدري أيّها أكثر ملاءمة له، الذي امتدت مسؤوليته فاستحوذت على مسؤولية أي مسؤول غيره ولم يعد بمقدور أيّما أحد أن يعرف حدودها أو يوقفها عند حدّ. بدأ الرجل الذي أكرمني بتخصيص خلوةٍ يستمع فيها إلى رأيي سعيداً بالاتفاق. فهل كان هذا تظاهراً أملته حاجة القائد إلى اجتذاب الآخرين لتأييده إزاء المعارضة الواسعة؟ ربما كان الأمر كذلك، وربما كان الرجل سعيداً حقاً بالفرصة التي رأى أنها انفتحت. وقد تأنـّى الرجل في الاستماع كما تأنـّى في الشرح مخالفاً عادته، هو الذي يتولـّى أموراً عدّة في وقت واحد فلا يجد وقتاً كافياً لأيّ منها.
في هذه الخلوة، وإزاء ما ظهر من عدم اقتناعي، لم يبسط أبو عمّار الآمال التي يعوّل عليها، هذه التي صرتم تحفظونها عن ظهر قلب لكثرة ما ردّدها، بل كشف هواجسه أيضاً وبسط رؤيته لأبعاد المجازفة التي رأى أنه مقدم عليها وهو يعي أخطارها. قال عرفات إنّ عدوّنا مخاتل فلماذا لا نأخذه بختله، قال إنه اغتصب أرضنا قطعة ً قطعة فلماذا لا نستعيدها بالأسلوب ذاته، وحقوقنا، قال عرفات، ما الذي يضرّ إن استعدناها حقا ً بعد حق. غزّة وأريحا أولا ً، كما هو عنوان الاتفاق الذي يلخص مضمونه، هذا قليل حقا ً، أقرّ عرفات، لكن كلّ إضافة إليه ستنمّيه، استدرك، وابتسم لأفهم ما يضمره، ثم قال: "جنحوا للسلم فما الذي يمنع أن نستجيب، هم مخادعون؟ فمن الذي قال إننا سننحّي الحذر، ألا تعرف أني سيد الحذرين".
لم يكن الرجل الذي لا تبارحه الهواجس حتى إزاء أبسط الأمور بحاجة إلى تذكيري بهذه السمة التي هي من أخصّ سماته، فأنا أعرف كم هو حذر حقا ً. قلت هذا وأضفت أني أعرف أيضا أن لـُعَبَ الختل تغوي الواثق بقدراته. أمّا ما أحجمت عن ذكره أمامه فكان معرفتي أنّ ياسر عرفات معتدّ بنفسه في هذا المجال، خصوصاً هذا المجال، واعتداده بنفسه هذا يشجعه على المجازفة. والواقع أني لو أجزت لنفسي أن أبتسر الصراع مع الصهيونية فأعدّه مبارزة يفوز فيها الأذكياء لربما أقنعني كلام القائد الذي بدا حريصاً على إقناعي. غير أن الأمر ليس هو هذا، إنكم تعرفون ما هو الأمر، وللذكاء دور دون شك لكنه ليس الدور الحاسم، والركون إلى الذكاء يتحول إلى فخّ يوقع بصاحبه حين يهمل الذكيُّ حساب القوى أو يخطئ الحساب. ومن الذي لا يعرف أن غلطة الشاطر قد تصير أخطر الغلطات!
بسطت رأيي. واستعنت بما يعرفه عرفات فاستحضرت تجارب الذين بدّدوا الوقت والقوى في المجازفة وأخطأوا الحساب، حجوم القوى وطبائعها، العدو المسلح بالقدرات وبضمنها ذكاؤه المشهود به، الوضع الإقليمي، الوضع الدولي، وما إلى ذلك مما يُستحضر في هذا المجال. وخلصتُ إلى القول بأنّ المجازفة غير مضمونة العواقب هذه المرّة ومن الخطأ أن يقدم الفلسطينيون على ما قد يؤدّي إلى هلاكهم.
لم يوافقني القائد الذي كان قد شرع لتوّه في مغامرة يراها جليلة، لكنّه لم يظهر أي ضيق بمعارضتي. ولم أوافق أنا القائد الذي يستطيب الإقدام على المجازفة في حدّ ذاته، لكنّي أدركت أن ليس من الممكن ثنيه عن ما شرع فيه. ومن أنا حتى أتمكن من إقناع عرفات بالتوقف! وقد ينبغي أن أقرّ بأن ما أظهره أبو عمّار من سعة صدر وهو يستمع إليّ قد خلـّف في نفسي أثراً طيباً، بل لأقل إنّه أسرني. والحقيقة أن أسر القائد إيّاي استحكم حين أقرّ هو بحقي في أن أعارض سياسته وتأثيره عليّ بلغ ذروته حين قال: "احتفظ برأيك، بل انشره إن شئت، ولنتحاسب بعد ذلك في ضوء النتائج!". ومن الذي لا يأسره أن يضعه رجل له مكانة ياسر عرفات في موضع الندّ!.
لقد بدا عرفات واثقاً من أنه سيفلح. ولأن تسامح الرجل الكبير إزاء تشدّدي في الاعتراض أحرجني، فقد وجدتني أقول إني سأعارض، لكنّي لن أنشر رأيي قبل أن أتيقـّن من صوابه، ولن أهاجمه هو شخصياً في أي حال. وبدا لي أن الرجل الذي استمع وهو يبتسم أسعده ما قلته. وعند هذه النقطة، انتهت الخلوة، وانضمّ آخرون إلى المجلس. وفي حضور هؤلاء، حيث كررت بعض آرائي بشأن الاتفاق، سألني أبو عمّار بنبرة وديّة: "ألن تذهب معي، إذن، إلى غزّة أنت الذي يعترض على اتفاق يعيدنا إليها؟". فقلت، وقد أدركت أن حجة القائد هذه هي سيدة حججه، إن غزة جزء من الوطن، وقد عشت فيها سنة بعد إقصائنا عن المسمية، ولي فيها ذكريات طفولة، وفيها أمي وإخوتي وعدد كبير من أقربائي، وقد انضمت إليهم مؤخراً ابنتي لـَمى وزوجها عَديّ، وأنا مستعد لأن أرجع إليها في أي ظرف، إن كانت السلطة فيها للمحتلّ أو كانت لنا.
والواقع أني عنيت ما قلته حين تحدّثت عن رغبتي في العودة إلى الوطن أيا ما كانت عليه الظروف. وفي فيينا التي أعتزل فيها منذ سنوات متفرغاً للكتابة، تابعت مسألة عودتي هذه، وتابعها أصحاب لي كثيرون، بمبادرة منهم أو بناء على طلبي. وقد عاد أبو عمّار ومرافقوه، عاد فوج، تلاه فوج، تلتهما أفواج. وكاد العدد الذي أتاح الاتفاق عودته يُستوفى فتنسدّ الطريق. عاد ألوف بينهم أصحابي المهتمون بعودتي وأنا أنتظر. وقد انتظرت شهراً وشهوراً، وانقضت سنة ومضت شهور من السنة التي تلتها وأنا ما أزال أنتظر. أما لماذا طال انتظاري فلهذا قصة وإليكم بيانها.
فقد إنداحت نتائج الاتفاق التي تعرفونها، إنداحت بأسرع مما توقع أيّما أحد. واتضح حتى للذين أعماهم إفراطهم في التفاؤل أن ختل العدو المسلح بتفوقه المادي هو الذي يرسم هذه النتائج. حصلت إسرائيل على ما توخته من الاتفاق ولم تف بما التزمته، وقصّر نهج القيادة الفلسطينية، هذا الذي سمّيته أنا نهج استرضاء العدوّ، عن إلزامها. أفرطت القيادة الفلسطينية في التنازل فظل لسان حال إسرائيل يصرخ: هل من مزيد! أن تنحّي وسائل الضغط على الظالم ثم تطالبه بأن ينصفك يساوي أن تدرج نفسك بنفسك في البلهاء. وفي هذه الأثناء، أخرج مستنقع الفساد الفلسطيني ديدانه وقد انفتح أمامها مجال جديد تلعق فيه ما تقع عليه، دون رقيب أو حسيب. وتنمّر الفاسدون على شعبهم، فالفساد يستولد القمع، فيما هم أنفسهم يمعنون في التطامن إزاء العدو. استرضاء العدو واستفزاز الجمهور، وجها العملة التي يتداولها الفاسدون.
ولكم أن تعرفوا أنّ ما أوجع روحي ليس هو سلوك إسرائيل. فقد ألفت أن أرى في الصراع مع إسرائيل قضية عامة، قضية كفاح ضد الظلم ينعش الإنهماك فيه الرّوح وينمّي أجود ما فيها. ألا ينعش الكفاح من أجل العدالة أيّ روح. ولطالما أمتعني الانهماك في المعامع وجدّد ألق روحي! أمّا ما أوجع الروح فهو سلوك ناس السلطة الفلسطينية، ناس القيادة وناس الحلقات التي تحفّ بالقيادة أو تتمتع بحمايتها، خصوصاً سلوك أصحابي من هؤلاء وهؤلاء. ما فعله العدوّ بعد الاتفاق ظلّ من طينة ما كان يفعله قبله، مائة سنة قبله. لم تطو إسرائيل راية الظلم وتحلّ محلها أي راية أخرى. ولم يفاجئني أن تفسّر إسرائيل بنود الاتفاق بما يوائم مصالحها وتتعسف في التفسير لتستحوذ على ما هو مشروع وما هو غير مشروع أيضاً من المكاسب. ولم يفاجئني أن تمعن إسرائيل في نهجها المألوف، فتفرط في استخدام سلاحها المتفوق، وتكبل السلطة الفلسطينية التي أنشأها الاتفاق بألف قيد وتبتزها في كل لحظة. أما ناس السلطة الفلسطينية فهم الذين استبدلوا سلوكاً بسلوك ورايةً براية، هم الذين استبعدوا الضغط الماديّ وأفرطوا في اللين واشتدّ هوسهم في إظهار التسامح، وهم الذين طووا راية الثوّار واستكانوا في الفخّ الذي حشروا فيه ورفعوا حتى داخل الفخّ راية الحكـّام. وهذا هو ما أوجع روحي.
ألم تشهدوا بأم أعينكم كيف أمعنت السلطة في استرضاء العدوّ كلـّما أمعن العدوّ في التضييق عليها والفتك بكرامة شعبها وحرياته وأرزاقه وكيف استشرى في غضون ذلك الفساد. هل كانت هذه سذاجة، أو سوء تقدير، أو رضىً بالفتات الذي يسّر العدو لقليلين الظفر به حتّى يستعين بهم على الكثيرين. ولماذا استمرّ تمسّك القيادة الفلسطينية بالرهان حتى بعد أن ظهر خطله، لماذا استمرأ المجازفون الإمعان في المجازفة حتّى بعد أن انسدّت سبل النجاة. وما الذي جناه الجمهور حين أمعنت قيادته في ترويج الأوهام. وإذا كان هذا كلـّه مما يمكن أن يقع فيه أي طالب تسوية حين يخطئ الحساب، فما الذي يبرر تنمّر السلطة على ناسها فيما هي مستكينة أمام العدوّ.
ضاق تصبّري بما خزنته، فأذنت لمخزوني بأن يفيض. تعذر علي الاستمرار في الصمت فأذنت للساني بأن ينطلق. ولما لم يكن من الجائز أن أنتقد القيادة وأغفل المسؤول الأول صاحب القرار، فما أشدّ ما قسوت في انتقاد ياسر عرفات!
لم يجيء إذنُ العودة إلى الوطن، ولم أتلق جواباً على رجاءاتي المتكررة حين ألححت على تعجيل استصداره. وفي البداية لم أربط بين حجب هذا الإذن وبين أي رد فعل مفترض على ما أكتبه، ذلك أني ألفت احترام الجميع حريّة التعبير في السّاحة الفلسطينية. غير أن شيئا ما وقع فأرغمني على الانتباه إلى أنّي معاقب وأن حجب الإذن جزء من هذه العقوبة.
هذا الشيء له حكاية بدأت منذ ابتدأت المفاوضات السرّية في أوسلو. فقد أوقفت القيادة صرف رواتب معظم العاملين في مؤسسات م.ت.ف. وقيل إن السبب هو شحّ الموارد الماليّة. واستمرّ الوقف شهوراً عانى خلالها الذين انقطعت مواردهم متاعب ومهانات لا حصر لها. ومنذ تسرّب أول الأنباء غير الرسمية عن وجود مفاوضات، استخلص ذوو الفطنة أن القيادة تعمّدت وقف الصرف مؤملة في أن تتضاعف الحاجة إلى مورد فيقبل العاملون في صفوف م.ت.ف. نتائج المفاوضات إذا استؤنف صرف الرواتب. والذي حصل بالفعل أن الصرف استؤنف بعد إعلان الاتفاق، استؤنف بتقنين بدا أنه مدروس ليفي بالغرض، يلبّي بعض الحاجة ويبقى القلق من احتمال وقف الصرف من جديد. وتوقعت، بالطبع، أن يجيئني راتبي أنا الآخر أسوةً بالآخرين. غير أن أملي لم يتحقق. ومضى شهر ثم شهور إلى أن تيقنت من أني معاقب على ما أكتب والعقوبة تشمل وقف الراتب أيضاً، وهو الراتب الذي لا مورد لي سواه، أنا المتفرّغ للكتابة بقرار حمل توقيع رئيس اللجنة التنفيذيّة ياسر عرفات، منذ 1989.
لقد احتججت بالطبع. ولكن الرجل الذي انضاف إلى ألقابه لقب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رفض حتّى أن يتسلّم رسائل الاحتجاج التي أرسلتها إليه، وعنّف كل من حمل إليه رسالة مني شفهية أو مكتوبة وكل من شاء التدّخل لصالحي. صدّ أبو عمّار سعاة الخير، وما كان أكثرهم، وأسكت كل من حاول أن يذكـّره بحاجتي، أنا الذي يعيش في فيينا بغير مورد، أو حتى بمكانتي عنده، أنا الذي طالما أظهر هو في السابق أنه يعزّني.
كانت تلك هي، إذن، عقوبة حجب لقمة العيش ونبذ العائش في الغربة ورميه إلى المهانات. أطع ترزق، قل ما يلائمنا لِتُطعَم أو نسدّ فمك، اتبع مالِكَ لقمة عيشك أو ابقَ جائعاً إن استطعت أن تصبر على الجوع! إنّه السلاح الذي استخدمه الطغاة في كل عصر، صغيرهم وكبيرهم، وهو السلاح الذي طالما فاخر ياسر عرفات قبل الاتفاق بأنه لا يستخدمه.
تردى الحال، إذن. حشر قادة ثورة التحرير أجسادهم في زيّ الحكام قبل أن يستقل الوطن أو يجلو المحتل عنه وقلـّدوا من الحكّام أشدّهم ضيقاً بالنقد وأقساهم يداً على الجمهور. السجون التي احتبس فيها الاحتلال الإسرائيلي المناضلين من أجل الحرية استخدمتها، هي ذاتَها السلطةُ الوطنية، وكثيراً ما احتبست فيها معتقلين كان الاحتلال قد اعتقلهم هم أنفسهم. الأفواه التي عجز المحتل عن سدّها، والعزائم التي فشل في ليّها، والإرادات التي عجز عن قهرها، هذه كلها تولى ناس السلطة معالجتها بدعوى الحاجة إلى إعطاء الاتفاق فرصة والكفّ عن استفزاز العدوّ حتى لا يتنصل منه. ولئن لم تصُبَّ السلطة الوطنية على الجمهور الحجم ذاته من القمع الذي صبّته سلطة الاحتلال، فمرد هذا إلى اختلاف الظروف والتفاوت في حجوم القوّة والقدرة. لكن طبيعة القمع تظلّ هي هي لا يبدّلها تبدّل الرايات. القمع هو القمع، والفساد، وكل ما تعرفونه. وعلى ضآلة حجم القمع الذي مارسته السلطة حين يُقارن بما فعله المحتلّ، فقد بدا القمع الوطنيّ هو الأوجع، أليس صحيحا أن ظلم ذوي القربى أشدّ مضاضة من ظلم الغرباء!
ولقد وُضع الناس أمام معادلة بدا كأن لا فكاك منها. إن عارض الناس سياسة السلطة وسلوكها، قال قادة السلطة إنهم ثوار تحرير وفي ثورات التحرير يتحد الجميع. وإن طالب الناّس القادة بأن يسلكوا سلوك الثوار، قال هؤلاء إنهم حكّام وللحكم حاجاته. ووقع الناس في حيرة؛ إن قاوموا السلطة فإنهم يضعفونها فيستفيد العدوّ الذي يريدها ضعيفة لتزيد سطوته عليها وعليهم ويتمكن من ابتزازها وابتزازهم، وإن استكانوا إزاء سلبيات سلطتهم فإن استكانتهم تشجّعُ القامعين والفاسدين، وفي هذا خدمة للعدو، وأي خدمة، خدمة مضاعفة!
و في مراقبتي للحال الآخذ في التردّي، رأيت أن الوقت قد يطول قبل أن ينعتق النّاس من أسر هذه المعادلة البغيضة. ولم أقتنع بأن السكوت جائز بسبب هذا. لم أر حكاماً حرّروا البلاد وانصرفوا إلى بناء مؤسسات الحكم الوطني المستقل فأقدّر حاجتهم إلى المساندة وأغضّ النظر عن أخطائهم. ولم أر ثوار تحرير فأغضّ النظر عن سلبياتهم. ولم أقع على ما يلزمني حبس سخطي. ولماذا أحبس السخط، ولماذا يحبس سخطه أيّما أحد حين يكون هو واحداً من المكتوين بالنار.
و فيما أنا منهمك في الحملة على القيادة ورئيسها، واصلت السعي كي أظفر بإذن العودة إلى الوطن. وصرت بحاجة إلى أن أمكث في مكان قريب يوفر لي فرص الاتصال بناسي الذين أندبهم للمساعدة. ولكنّي كنت ممنوعاً من الدخول إلى كلّ من مصر والأردن، أقرب بلدين إلى غزّة وأريحا حيث نشأت السلطة. ولما تعذر أن أجد وسيلة تيسر لي دخول مصر، فلم يبق غير الأردن. وكان طريقي إلى هذا البلد، أنا الذي حظر علي دخوله منذ أيلول/سبتمبر 1970، قد انفتح جزئياً في العام 1991، فتحته مبادرة طيبة من الدكتور أسعد عبد الرحمن، صديقي الذي صار المدير العام لمؤسسة شومان الثقافية في عمّان. فقد ندبني أسعد لإلقاء محاضرة في موسم المحاضرات الذي تنظّمه المؤسسة وظفر بإذن يبيح لي دخول الأردن لمرة واحدة استثناء من حظر الدخول. ولأن نجاح المحاضرة وسعادتي بالزيارة حفزا أسعد على توفير فرصة أخرى، فقد تكررت دعوتي لإلقاء محاضرات. وبهذا تيّسر لي أن أجدد صِلاتي بأقربائي وأصدقائي في البلد الذي يقيم فيه جلّ الأقرباء وعدد كبير من الأصدقاء. وعندما اشتدّت حاجتي إلى إطالة المكوث في عمان، سعى أسعد إلى توفير حق الإقامة الدائم لي في البلد، غير أن جهده لم يفلح في زحزحة الحظر. أما ما وفر لي هذا الحق في نهاية المطاف فكان جهد رجل لن أنسى فضله علي هو حاكم الفايز الذي تخطّى محظورات كثيرة يفرضها هو على نفسه واستخدم مكانته كي يتوسط لي فمكنني من الظفر بحق الإقامة، فتوفر لي أن أجيء إلى البلد متى أشاء وأمكث فيه كما أريد.
وبتوفر هذه الفرصة، وبوجود صديق العمر الدكتور منير الحمارنة الذي يستضيفني في منزله، تسنى لي أن ألتقي من أحتاج الإلتقاء بهم من القادمين من الأرض الفلسطينية. وما أكثر الذين التقيت بهم، وما أكثر الذين حاولوا من هؤلاء أن يعود إليّ راتبي وأظفر بإذن العودة إلى الوطن دون أن يفلحوا!
في هذا النحو، انقضى ما بقي من العام 1993 بعد التوصل إلى اتفاق أوسلو والعام 1994 الذي عاد عرفات في أوله إلى الوطن ومعظم العام 1995. وبقيت أسير مضاضة مضاعفة: الافتقار إلى مورد والافتقار إلى إذن العودة.
وها أنا ذا أتذكر واحداً من أصحابي جاء إلى عمان فيما أنا أبحث عن حل لمشكلتي فندب نفسه لحلها. سأعطي لهذا الصاحب اسماً غير اسمه، هو الذي تعدّدت على أي حال الأسماء التي عرف بها، سأسميه عائد، وسأبدأ بأن أنقل إليكم ما ابتدرني به فور لقائي إيّاه: "الجم لسانك ودع الباقي عليّ، أضمن لك استئناف دفع رواتبك والعودة!".
سمعت النصيحة القبيحة فأدركت كم تبدّل عائد منذ عاد وكم تطامن. وقد باح عائد الذي كان يشغل منصباً يضعه في السلطة قريباً من رئيسها بما يعرفه من شأني عند الرئيس. فعرفات، هذا الذي سماه عائد حتى أمامي أنا سيادة الرئيس، ساخط علي لأنّه لم يتوقع أن أخذله أنا الذي طالما وقفت في صفّه في أصعب المواقف، وهو يتهمني بأنّي خالفت عهداً قطعته على نفسي أمامه بأن أصمت فلا أهاجمه. لم يكرر عائد، إذن، الترهات التي روّجها غيره، لم يزعم أن فوضى البيروقراطية هي التي أوقفت صرف راتبي، لم يدّع أن السلطة طلبت لي إذن العودة وأن إسرائيل هي التي لم ترد على الطلب حتى الآن، بل واجهني بالحقيقة: سيقتنع سيادة الرئيس بالإفراج عن رواتبي إن أظهرت ما يتوقّعه مني أنا الكاتب الذي لم يخذل قيادة شعبه الوطنية ولم تقصّر هذه القيادة في إكرامه. واستحضر عائد حقيقة أن سيادة الرئيس هو الذي يسّر لي الحصول على حق التفرغ للكتابة فليس من العدل أن أجنّد قلمي للهجوم عليه. وأكد عائد أن أشد ما يسخط الرئيس هو استهدافي إيّاه شخصيا بالنّقد. وكرّر عائد ما بدأ به: " الجم لسانك قبل أن تأمل بأي حل!".
كان بقائي بلا مورد طيلة ما كاد يبلغ سنتين ونصف سنة قد عرّضني لمهانات يخجلني أن أبوح بها. ولو لم تستمر زوجتي في العمل، هي التي استحقّت التقاعد فأرجأت الظفر به، لربما تعرّضنا هي وأنا إلى ما يصعب تصوّره. وكانت أمي التي بقيت في غزة منذ لجأنا إليها في العام 1948 قد توقعت أن أعود إليها مع أوائل العائدين. بل إن أمي، مثلها مثل أي أم تبالغ في تصوّرها لمكانة إبنها، توقعت أن أدخل غزّة في موكب ياسر عرفات وأكون إلى جانبه عندما احتشد الجمهور لاستقبال زعيمه القادم من المنفى. أكلّم الأم المشتاقة فيكون أول ما أسمعه على الهاتف "متى أراك؟". أمنّي أمي المتلهفة إلى لقائي بقرب اللقاء فتقول: "أخشى أن أموت قبل أن ألقاك". وأصحابي الذين عادوا، الأصحاب الذين ألفتهم في المنافي وشهدت معهم معامع الثورة وخبرت وإياهم الحلوة والمرة، أصحابي هؤلاء راحوا يترقبون عودتي ولا يكفون عن حثـّي على تليين موقفي كي أعود، يقول واحدهم على الهاتف ما يقوله من ألقاه منهم في عمان إن بعض التنازل لا يضرّ خصوصاً إن كانت العودة إلى الوطن هي المكافأة، يرددون هذا ويستحضرون ما كنت أنا نفسي أردده على مسامعهم: النضال من الداخل أجدى، ويضيفون: انتقل مركز الثقل من المنفى إلى الوطن، فلماذا المكابرة.
كان عائد مدفوعاً برغبته في مساعدتي حين طلب مني أن ألجم لساني، إلا أن مطالبته إيّاي بالتنازل الذي لا أقدر عليه أحنقتني. ألا يُحنق الكاتبَ أن يُطالب بالكفّ عن بثّ أفكاره، وبأي شيء يختلف كتم الرأي عن ترويج الآراء الزائفة.
- لن يرجعوني إليك يا أمي.
كنّا في صيف 1995، آخر هذا الصّيف، وكان هذا هو ما قلته لأمّي على الهاتف بعد أن فارقت عائد محنقاً. ولم تغالب أمي هذه المرة أساها.
- رباح هنا، وأنت هناك، تريدان أن تقيما الدين في مالطا بعد أن فسق الجميع، أصحابكما يخزنون المال ولهم الجاه، وأنتما تعاندان، فيتعب الخوف على رباح قلبي ويفري الشوق إليك كبدي.
ورباح الذي ماثلت أمي بينه وبيني في العناد هو رباح مهنّا، أخي منها، واحد من أخوين ولدتهما أمي لزوجها الذي تزوجها بعد رحيل أبي. وكان رباح مثلي منهمكاً في العمل العام، كما كان، مثلي، معدوداً في المتزمتين حين يتعلق الأمر بدواعي الطهارة الشخصية. أما موقف رباح السياسي فقد اختلف عن موقفي، فهو واحد من زعماء الرفض ومعارضته لاتفاق أوسلو ناجمة من معارضته كلّ تسوية مع إسرائيل، في حين نجمت معارضتي أنا من خشيتي أن لا يفضي الاتفاق إلى أيّ تسوية وأن يبدد فرص عقد تسوية معقولة.
أوجعني أن يبلغ أسى أمي حدّ التعريض بموقف ابنيها. ولكي تدركوا لماذا أوجعني أن تقول
أمي ما قد تقوله أيُّ أم، فلكم أن تعرفوا أني ما كلمت أمي مرة قبل هذه المرّة إلا شجعتني على الثبات. وما أكثر ما كانت أمي تتفاخر برباح وبي، أمي ذات الجَـلد، أمي التي لم تهن أبداً، فكيف لا يوجعني أساها!
أما لـَمَى، كبرى بناتي الثلاث التي انتقلت هي وزوجها عَديّ منذ بعض الوقت إلى غزّة فهي لا تحثني بلسانها على شيء، لكن حنيني إليها، هي التي سعدت بالإقامة في وطنها بعد طول التطوح في أوطان الآخرين، كان يحثني. ولئن لم تقل لمى شيئاً لأنها ألفت أن تتجنب الضغط عليّ، فما كان أقوى ما بثه صمتها، وما كان أوجع أن أظل عاجزاً عن تلبية توقها إلى أن تلتقي بأبيها على أرض الوطن!
حملت وجعي وقصدت أسعد عبد الرحمن. ولعلها المرة الأولى التي سمعني فيها أسعد وأنا أتوجّع. وبعد أيام قليلة، وقد صرت أنا في فيينا، جاءني صوت هذا الصديق على الهاتف وكلماته الوجيزة؛ إنه ذاهب إلى غزة ليلتقي ياسر عرفات، وهو بصدد عقد صفقة معه وبودّه أن يضع مشكلتي في مقّدمة البنود. "لا يشغلني شيء بأكثر مما تشغلني مشكلتك"، قال أسعد هذا، وسأل عما إذا كان لديّ أيّ شروط.
جاء هذا العرض فيما كانت نفسي تراودني على أن أتخذ أنا المبادرة وأتصل بعرفات وأطلب المصالحة. تضافر ضغط الحاجة مع أسى أمي وأشواق لمى وإلحاح أصحابي وتأثير قناعاتي وكل شيء من هذا القبيل، فجعلني طالب مصالحة. وبالرغم من تشدّد عرفات في رفض أي وساطة بشأني، فقد أدركت أن وقت حلّ المشكلة قد حان. فالرجل الذي اتبع رهانا لم يتحمس له من المثقفين النزهاء إلا قليلون وجد نفسه محاطا بحشود المتملقين ومستثمري علاقاتهم به لتوسيع مفاسدهم والذين هم من هذا القبيل، واشتدت عزلته عن الآخرين، ولا شك في أنه تائق إلى الموازنة بين هؤلاء وهؤلاء. والواضح أن أسعد الذي لم يُفتن بأوسلو لكنّه لم يساهم في الهجوم على عرفات قد استخلص ما اسخلصته وعزم على أن يجد لنفسه دوراً في مركز الصورة الذي انتقل إلى الوطن.
- لي شرط وحيد هو على كل حال شرط إجرائي أعلم أنه سيستجيب له إن كان راغباً في حل المشكلة.
وأغلب ظني أن أسعد توقع أن يسمع شرطاً جليلاً، ولهذا فإنه فوجئ حين لم أشترط إلا أن أظفر بخلوة مع عرفات لا يقاطعنا خلالها أحد ولا ينصرف هو إلى مشكلة أخرى، عشرين دقيقة، ليس أكثر، لكن ليس أقل.
قد يفاجئكم أنتم الآخرين أن أضع هذا الطلب البسيط بمثابة شرط، أنا الذي لم أضع أيّ شروط أخرى. فاعرفوا، إذن، ما عرفته مما آل إليه أمر ياسر عرفات بعد أن عاد إلى الوطن. فهذا الرجل هو رجل الاستحواذ على أي صلاحية، وقد اتسم تاريخه كله منذ كان رئيساً لرابطة طلاب فلسطين في القاهرة بسعيه الحثيث إلى تكديس الألقاب والاستحواذ على كل صلاحية متاحة. وبعد أوسلو. بعد العودة إلى الوطن، حين ضاقت حلقة منافسيه وزاد عدد المتطامنين أمام استحواذه على صلاحياتهم، صار ياسر عرفات هو المستحوذ الوحيد على كل صلاحية. ولم يعد من الممكن قضاء حاجة لمواطن أو تصريف أمر إلا بموافقة عرفات وتوقيعه. استوى في هذا أن تكون الحاجة معالجة مرض امرأة فقيرة أو بناء ميناء وأن يكون الأمر أمر شراء تذكرة سفر لموظف مغادر في مهمة أو تشكيل الوفد الذي سيمثل فلسطين في أعلى القمم. وكان عرفات كثير الأسفار، فصار وقته حين يستقر في مكتبه، وقته القصير في واقع الأمر، مثقلاً باجتماعات الهيئات القيادية والمجالس العليا العديدة واللجان متعددة الأغراض التي هو رئيسها جميعهاً. وكان على الرجل أن يقرأ ألوف الأوراق التي ترد إلى مكتبه أو تسلم إليه باليد كل يوم من طلاب قضاء الحاجات الخاصة والعامة الذين لا يتوجهون إلا إليه، كما كان عليه أن يستقبل عشرات الوفود والزوار. وانتهى الأمر إلى أن صار المطالب بالبتّ في كل طلب يقرأ الأوراق المكومة أمامه فيما هو يرأس اجتماعاً أو يستقبل وفداً أو زائراً. وصار عرفات يوزع انتباهه بين الجالسين أمامه وشؤونهم وبين الأوراق، ويواصل القراءة والتوقيع فيما هو يتحدّث أو يستمع. وقد ألف رواد مكتب عرفات الفلسطينيون جميعهم، جميعهم بغير استثناء، هذه الاستهانة السافرة بهم أو بالهيئات أو بالوفود التي هم أعضاء فيها. وبوضعي شرطي، شئت أن يعرف من أتوجه إليه من أجل المصالحة أني أطلب أن أحظى بانتباهه كاملاً واحترامه ولا أرضى بأن يُستهان بي.
- اركب أوّلَ طائرة وتعال إلي في عمان!
في لقائه مع عرفات، قال أسعد للقائد الذي استقبله بترحاب إنه راغب في أن يكلمه بشأن شخص يعرف أنه، هو عرفات، يحبه ويقدّره ولا يريد له إلا الخير. كان هذا هو أسلوب أسعد. وبهذا الأسلوب، هيأ صديقي القائدَ الساخط عليّ ليتلقى شكواي وطلبي.
- استجاب دون ممانعة وامتدحك، إنه يعزّك فعلا.
وقد حمل لي أسعد الذي لم يفته ذكر ضائقتي المالية ثلاثة آلاف دولار دفعة ً على حساب رصيد رواتبي الموقوفة وإذن زيارة منحته لي السلطات الإسرائيلية بناء على دعوة لزيارة غزة موجهة إلي من مكتب الرئيس، وهو إذن يبيح لي أن أبقى في غزة زائراُ لمدّة شهر. وقال أسعد غير متستر على سعادته بما تمّ إنجازه: "سيستقبلك، خلوة، كما طلبت".
جزء من رصيد رواتبي وليس الرصيد كله وإذن زيارة وليس إذن عودة، إلا أن هذا الفارق لم يوهن عزمي على حلّ المشكلة. ولم اُضِع الوقت في مراسلات جديدة. إنها خطوة في مقابل ما تصور القائد أنها خطوة منّي. ليكن! حسوب هو هذا الذي أعرفه معرفة تامة، بل بارع في الحساب كلما تعلق الأمر بمجافاة الآخرين أو اجتذابهم. حلُّ مشكلتي المالية كلّها قد يعزّز عنادي الذي رأى هو أنه بدأ ينحل. وإذن الإقامة يبقيني في الوطن حتى لو لم يشأ هو أن أبقى. مبلغ يمكنني من الوصول إليه، وإذن يبقي موضوع إقامتي في يده. ولأقرّ: إني أقدر ذكاء الأذكياء!
- أنا في الطريق إليك يا أمي.
- تَعِدُني ثمّ لا تجيء.
- أقول لك هذه المرّة إني على الطّريق. أنا قادم إليك غداً من كلّ بدّ.
لا بدّ من أن نبرة الصوت الجازمة حملت إلى الأم المتشككة ما طمأنها.
- أنت متأخر في كل حال. الذين سبقوك لم يبقوا لك منصباً تشغله أو شيئاً تسرقه.
أوجزت التي راق مزاجها وصف الحال بهذه السخرية اللاذعة. فجاء الوصف الوجيز أدلّ على الحال من أي وصف. وما أشدّ اعتزازي بأن أكون ابن هذه الأم!

08-أيار-2021
26-شباط-2012 | |
27-نيسان-2011 | |
11-آذار-2011 | |
01-شباط-2011 | |
11-كانون الأول-2010 |
22-أيار-2021 | |
15-أيار-2021 | |
08-أيار-2021 | |
24-نيسان-2021 | |
17-نيسان-2021 |
