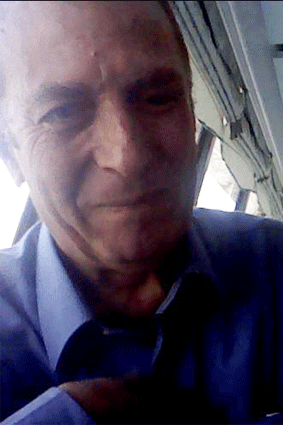
الحنين حكاية عودة ـ ج3
خاص ألف
2010-12-11
3
فحص السائق الريحاوي إذن الزيارة بإمعان ونبّهني إلى أنه يجيز لي زيارة غزّة وحدها ويوجب أن أبلغ حدود القطاع قبل السابعة مساء. وقال السائق إن في التوقف على الطريق مجازفة، فرخصة سيارته تجيز له نقل الركاب على الطريق إلى قطاع غزّة لكنها لا تبيح له الوقوف. ولما لاحظ الرجل الذي طلبت منه أن يتوقف في أماكن بعينها أني أصغيت إلى تحذيراته بتفهم، فقد قدّم من تلقاء نفسه عرضاً.
- سنعبر الضفـّة، وسنعبر بقية البلاد، هذه التي صار اسمها إسرائيل، وبإمكاني أن أخفـّف السرعة في أيّ مكان تحنّ إليه حتـّى تتملاه، أخفف السرعة لكن لا أقف.
ولئن صبّت شروح السّائق ماء بارداً على لهفتي، فقد منـّتني برفقة رجل أريَحيّ. وما كان أحوجني في ذلك الظرف بالذات إلى مثل هذه الرّفقة!
أريحا بلدة أطفأ طول الإهمال ألقها الذي تحتفظ ذاكرتي ببريقه أنا الذي زرتها في العام 1956في رحلة مدرسية قادمة من سورية. ومخيمات أريحا، النويعمة وعين السلطان وعقبة جبر، هذه التي كانت تعجّ بالحيّوية والنشاط السياسي خلت من سكـّانها وصارت دورها أطلالا. على امتداد الطـّريق شميم خراب، وفي معظم الأمكنة مظاهر عوز. والجزر القليلة الناجية تشعرك بأنها تنتظر أن يحلّ عليها الدور. أما القدس التي طلبت من السائق أن يبطئ منذ أشرفنا عليها فقد حلّ بها أوجع ما أثار مواجعي.
تحتفظ ذاكرتي بعتيق المدينة المضمخ بعبق التاريخ وجلال القداسة منذ أخذتني أمي إليها وأنا طفل لم يبلغ السادسة. وقد اغتنت الذاكرة بما انضاف إلى مخزونها في العام 1956. الجليل المقدس وعبقه، والعمائر التي تتطيّب بهذا العبق وتحيط بالعتيق فتحتضنه بانسجامها معه، العمائر التي لا مثيل لها إلا في هذه الناحية من العالم، والأماكن ذات الإيحاءات التي لا ضفاف لها. هذا كـلّه فتكت به أطماع المعتدين، فتبدد العبق، وشاهت الأصالة، وغامت الإيحاءات، وفرضت سطوتها عمائرُ لها وظيفة المصارف وأخرى لها وظيفة الحصون الحربية وطرزها القبيحة. حرب الطمع ضدّ العراقة انتصر فيها الطمع. الحاجة إلى حماية نتائج العدوان من قوة الأصالة فتكت بالأصالة. القباحة ضد الجمال، هذا هو ما آل إليه حال القدس. افترس هوس العدوان روح السلام، ويا فيروز من حقّك أن تغنّي للقدس وتنوحي!
أما المستوطنات التي أنشئت بين مدن الفلسطينيين وقراهم، على روابي أرضهم وذرى مرتفعاتها، فقد داهمتني مظاهر الجدّة والترف التي تميّزها وتسطع وسط محيطها البائس، غير أن هذا لم يجعلها أقل عدوانية أو أقل تنابذا مع البيئة المحيطة بها. أقيمت المستوطنات بفعل فاعلين استندوا إلى سطوة العدوان وليس إلى أي شيء آخر. ولما كان هذا عدواناً سافراً لا يسوّغه أيّ مسوّغ، عدواناً مضاعفاً، على الناس وأرضهم وبيئتهم، على التاريخ والجغرافيا، على القوانين والقيم، على الذوق العام والذوق الخاص أيضاً، فقد بثّ وجود المستوطنات سموماً تملأ الأجواء، وكان هذا هو أقبح ما صدم مشاعري وأنا أعبر الضفـّة. ولئن طلبت من السائق أن يبطئ السير مرة فإني لم أكرر الطلب، بل صرت أتعجل الخروج من طوق المشهد الذي يستفزني. وما كان أبعد هذا عمّا منـّيت نفسي به: فرحة السفرة الأولى على أرض الوطن بعد غياب طويل عنه!
- ألا تحب أن أخفف السرعة في أي مكان؟
- سق بالسرعة التي تلائمك، ولا تهتم!
و لم أحتج بعد ذلك إلى من يقول لي إننا بلغنا المنطقة التي تشغلها إسرائيل. فقد صار دير اللطرون في مرمى النظر. وما كان أيسر التمييز بين متناقضين: مظاهر الخراب والعوز في الجهة التي عبرناها ومظاهر العمران والترف في الجهة التي أقبلنا عليها!
كنا نعبر خط الهدنة القديم، هذا الذي روّج الإسرائيليون من بين تسميات عديدة أطلقت عليه تسمية الخط الأخضر فكأنّهم تقصدوا النكاية بضحاياهم. وهنا، في المدى المعمور بالطرق المريحة والأبنية الفاخرة والحقول المشعّة بالرواء، هنا أيضا ضقت برؤية ما حلّ بوطني. ومن الذي تمتعه رؤية وطنه وقد استأثر الغاصبون به وجعلوه جنّة لهم وحظروا على أصحابه العودة إليه واستكثروا عليهم حقّ التوقف على أرضه أو تفقد ما ضاع منهم فيه.
كرر السائق سؤاله، وكررت إجابتي، وكدت أطلب منه أن يزيد السرعة. وعقّب هو بكلمة واحدة: "مفهوم"، قالها بنبرة امتزج فيها التعاطف والأسى، ثم صمت. ورحنا نجتاز القرى والبلدات، يشرح هو كيف بدّل الإسرائيليون أسماءها العربية وجعلوها عبرية، وأروي أنا ما أعرفه مما يتصل بالأسماء. الاستعمار الاستيطاني وقد هزم ضحاياه، وهذا هو تجسيده على الأرض، محو المعالم، وقلب التاريخ رأساً على عقب. وحين أقبلنا على المكان الذي كانت تقوم عليه قريتي المسمِيَّة، أبطأ السائق السرعة دون طلب مني، وأشار إلى مبنى لا يعرف هو أنه محفور في ذاكرتي، وهتف: "كانت هذه هي مدرسة القرية. هدم الإسرائيليون القرية كما هدموا مئات غيرها في العام 1948، وبقيت المدرسة، وقد جعلوها مدرسة لتدريب شرطتهم".
ما كان أوجع ما وقع نظري عليه، مدرستي، سنوات دراستي الثلاث الأولى ورحلة الاستهداء بنور الحروف، هي ذاتها ماثلة أمامي، البناء الذي جلبت حجارته من صخور باب الواد، والباحة، والمدخل المفضي إليها، والذكريات، مدرستي هي هي لم تتبدّل وإن شُوّهت باحتها فأقيم فيها بإزاء حجرات الدراسة براكات لإيواء الجنود المتدربّين.
و في النقطة التي تلت المدرسة، عند التقاء الطريق الذي قدمنا عليه مع الطريق الواصل بين يافا وغزّة الذي سنواصل السير عليه، جذب السائق انتباهي إلى لوحة كـُتب عليها: "المسمِيّة". وكان هذا هو كل ما أقيم ليشير إلى ما كان في العام 1948 قرية المسمِيّة، أو قل: المسمِيتين، الصغيرة والكبيرة ومنازلهما التي كانت أعدادها مئات وسكـّانهما الذين تجاوز عددهم ثلاثة آلاف. أشار السائق إلى اللوحة، أما أنا فحضرني ما كان قائما في ذلك المكان عند تقاطع الطريقين: محطـّة القطارات، وحانوت سرّيس البقال الذي كان يعدّ أشهى الفلافل، وعبثنا نحن تلاميذ المدرسة في هذا المكان الذي كنّا نرتاده كلّ يوم. وبعد أمتار، وكانت السرعة ما تزال بطيئة، مَثـُلـَت أمامي محطـّة البنزين التي كان يملكها زوج أمي والتي طالما شهدت عبثي مع مجايليّ من أبنائه. ولكـَم عنـّاني أن يمثل أمامي كلّ هذا الذي حُرمت منه!
- بودّي أن تسرع!
ومع أن السائق أطلق لسيّارته العنان، فإن أوجاعي لم تخفّ، فذاكرتي تختزن أسماء المواقع التي توالت وتطفح بذكرياتي فيها ومعلوماتي عنها وعن ما حلّ بها على يد غاصبها.
- هانت، اقتربنا.
قال السائق هذا وهو يدخل في طريق متفرّع من الطريق العريض ويشير إلى لوحة تؤشر نحو غزة. ولم يلبث أن أطللنا على منشآت أشبه بمنشآت معسكر حربي.
- حضّر أوراقك!
كنّا قرب بيت حانون، في مركز التفتيش الإسرائيلي على مدخل قطاع غزّة، أو المعبر الذي أغفل المحتلّون الاسم الفلسطيني للمكان الذي أقاموه عليه، والذي اشهروه باسم معبر إيرز.
- هذا هو حدّي، لا يحق لي أن أتخطّاه، تنزل هنا وتتبع الإجراءات.
وشرح السائق ما ينبغي اتباعه. وقبل أن أفارق الرجل الأريَحيّ، استخدمت هاتفه النقّال واتصلت بمنزل أخي الذي تقيم أمي فيه.
- ليجيء شخص واحد منكم لاصطحابي، واحد فقط، لا أريد احتفالا ً، وأنا أنذركم: إن جاء أكثر من واحد فسأرجع إلى المكان الذي جئت منه.
ما من شك في أن هذه كانت فاتحة سمجة لحديثي مع زوجة رباح التي ردت على الهاتف. غير أنّه المزاج الذي عكرته الرحلة، وهو ضيقي بالذين جعل الواحد منهم من رجعته إلى الوطن مناسبة للتباهي بعدد مستقبليه على الحدود. ولا بدّ من أن نبرة صوتي كانت حازمة الدّلالة، أو لعلّها كانت غريبة. فزوجة الأخ التي عهدتها مهذارة على الهاتف وبارعة في تدوير العبارات لم تعقـّب بغير كلمة واحدة: "حاضر!".
هل خبرتم معبر إيرز هذا. هل عاينتم ما تفرزه العنصرية المسلحة بسطوة القوة وكيف تهبط بمرتبة إنسان إلى مرتبة بهيمة. وهل بقي في زمننا من يعامل البهائم كما يعامل الإسرائيليون الفلسطينيين. وهل بينكم من لا يعلم، من لم يرَ أو يسمع أو يقرأ، كيف يُعامَل الفلسطيني على يد محتلّي وطنه. إذن، لماذا أكرر الوصف وأثير المواجع، أنا الذي لا يحبّ التكرار ولا يتوخّى استدرار أي دموع.
ييللا! كانت هذه اللفظة المنتهرة هي آخر ما رُميتُ به وأنا أتبع إجراءات التفتيش والتدقيق، رماني بها الجنديّ الإسرائيلي الذي أجرى آخر فحص لأوراقي. وبعدها، صار علي أن أضيف ثقل حقيبتي إلى أثقال روحي وأعبر بأثقالي الممر الضيق المؤطّر بقضبان الحديد المخصّص لعبور أهل البلاد حين يبيح لهم الاحتلال أن يجيئوا إلى قطاع غزة أو يخرجوا منه. وعند نهاية هذا الممر الذي يذكّر ضيقه بممرات البهائم، وإن كان أطول منها، تبدأ منطقة السلطة الفلسطينية. وقد انتصب هنا حاجز صدمني، أنا الخارج لتوّي من شبكة الحواجز الموحية بالسطوة، كم هو هزيل ومتطامن.
- أوراقك، إن سمحت!
قالها فتى فلسطينيّ في زيّ الشرطة يقف على الحاجز وهو ينظر إلي نظرة لا معنى لها.
- هل تملك صلاحيّة منعي من الدخول؟
- ...
- هل لك حق إعادتي إن وجدت أوراقي ناقصة؟
- ...
- إذن، لماذا تتعب نفسك؟
داهمت الفتى فاقد الحول بأسئلتي فكأني كنت أداهم السلطة كلّها وأكرر رأيي في الاتفاق الذي لم يمنحها سوى المظاهر. لكن، ما أن انفثأ ضيقي حتى ندمت، لقد جبهت فتىً غريراً بما هو أكبر من قدرته على الفهم واتبعت سلوكاً طالما انتقدته أنا نفسي: التطامن إزاء ذوي السطوة وانتضاء العزم إزاء الذين لا حول لهم ولا قوة. وقد نبّهني ذهول الشرطيّ المغلوب على أمره إلى أنني أثقلت عليه دون سبب.
- اعذرني يا بني، أنا لم أقصد...
وقبل أن أتم اعتذاري، هتف فتى مقبل عليّ من ناحية الحشد الذي ينتظر القادمين:
- عمّي!
عرفني ابن أخي، فأنا كما قال وهو يستسلم لذراعي أُشبه أباه، الهيأة، والصوت، وفورة الأعصاب. وتحدّث الذي طفح البشر من كلّ شيء فيه، تحدث اللهجة الغزّاوية الصافية التي يفتنني جرسها، فيا أيتها الأشواق المخزونة نحّي الأسى وفيضي، فها أنا ذا قد صرت في غزّة مرة أخرى وهي ليست بعيدة عن المسميّة!
أمّي. أمّي وكل سنوات الفراق. الأم والوطن، ابتعدت عنهما أربعة عقود ونصف عقد وها أنا ذا أرجع إليهما كليهما في يوم واحد. أقصيت عن أمي ووطني وأنا طفل لم يتخطّ العاشرة. وكنت وقتها بلا حول ولا خبرة ولا عدّة لمواجهة الحياة. وها أنا ذا قد رجعت بستٍّ وخمسين أو سبع وخمسين طافحة بالخبرات. فقدت الإبصار بواحدة من عينيّ أثناء الحرب التي أبعدتني عن مسقط رأسي، وفقدت السمع بواحدة من أذنيّ في حرب أخرى من الحروب التي لحقتني في المنفى، فصرتُ لا أرى محدّثي إن جلس على يساري ولا أسمعه إن جلس على يميني. احتلّ داء لا شفاء له ظهري، واحتلّ داء آخر لا شفاء له صدري، وتناوشتني شتى الأمراض، وصرت لا أرتاح في قيام أو قعود ولا أهنأ في صحو أو نوم، ولم تعد الآلام تبارحني. مع هذا، بالرغم من كل ما حلّ بي في المنافي، ها أنا ذا قد رجعت ولديّ العزيمة وإرادة الاستمرار، بل الرغبة في مواصلة الإنهماك في المعامع، أيضاً، والقدرة على التجلّي فيها.
أمي والوطن في يوم واحد. إني محتاج إلى أم تحدب عليّ وإلى وطن أحظى فيه بما يخصّني. وها أنا ذا قد رجعت، فهل ظفرت بما أحتاج إليه؟
لا تتعجلوا الحصول على إجابتي، ليس لأني أضنّ عليكم بأي إجابة، بل لأني لم أبلغ أي يقين!
خرّب الاحتلال الوطن وحظر تطوره وإن بقيت جذورٌ عجز عن اقتلاعها. وبدّلت صروف الدّهر أمي وأهرمها تواتر المتاعب وإن بقيت لها القدرة على الاحتمال. ولكم أصاب الذين ربطوا بين الأم وبين الوطن، ليس رمزياً فقط هذا الربط البليغ، ألم أره مجسداً أمامي أتمّ تجسيد.
أطلقتْ أمّي وأنا أجتاز باب الدّار زغرودة صدح رنينها في الحيّ، وهاجت. زغردت التي تجاوزت السبعين كما لم تزغرد إلا حين كانت في عزّ صباها، وهاهت أجود ما جادت به قريحتها هي المشهود لها بالابتكار في هذا المجال. استعادت العجوز فتوتها، ورقصت، ودارت حول نفسها، ذراعاها مفرودان وقدماها يخبطان الأرض. واستحوذ الوجد على المنتشية بعودة الغائب فصمت كل ما حولها. ولم تتوقف أمي إلا بعد أن كاد يُغمى عليها. وما أن استعادت أمّي قوتها حتى جذبتني إليها، واحتضنتني، وراحت تتحسس جسدي أو قولوا: تتفقده؛ ألا تتفقد الأم جسد طفلها الراجع إلى الدّار بعد أن أشقاه عراك الشوارع. وكانت أولى عبارات أمي هي هذه العبارة التي سأتذكرها بعد وقت قصير وأظل أتذكرها بقيّة عمري:
- الآن، أستطيع أن أموت وأنا مرتاحة البال.
حظيت من أمي وأنا في المنافي بأربع زيارات قصيرة، زارتني مرة في دمشق، ومرة في بيروت، وثالثة في قبرص، ورابعة في عمان، ولم تبدر منها في أي مرة إشارة ضعف أو يأس. وعندما قالت أمي هذه العبارة، لم أتلقّها بمعناها الظاهر بل حسبتها طريقة في التعبير عن ارتياحها لعودتي. وحين زغردت أمي من جديد وهاهت وتتابعت زغاريدها وأطربتني مهاهاتها المبتكرة، لم يتبق لعبارتها هذه أي أثر.
كانت تلك زغاريد بهجة ومهاهاة تنبثق عباراتها من حبيس اللوعة، وكانت إعلاناً ينبئ الداني والقاصي، المحبّ والمبغض، الغابط والحاسد، أن الولد الذي طال غيابه قد رجع. ولا شك في أن الحيّ التقط الإعلان وانداح النبأ منه إلى كل مكان في غزة. فقد اكتظت الدار بالوافدين للتهنئة بسلامة وصولي، واختلط الجيران والأصحاب والأقرباء، نساؤهم ورجالهم وكتائب أطفالهم. فهل يمكن ألا يغسل هذا الاستقبال القلب.
كانت لمى ابنتي وزوجها عَدِيّ بين أوائل الوافدين فاتضح أنهما يسكنان في شقة قريبة. وما أسرع ما تفاهمت وإياهما، فإذا كان من المنطقي أن أقيم معهما في شقتهما فإني آثرت أن أبقى حيث تقيم أمي، أن أُشعر الأم بأنها هي أخصّ من يخصونني وأعلاهم منزلة. وتقبّل كل من لمى وعدي الأمر بتفهم هو، في أي حال، التفهم الذي ألفت أن أحظى به منهما على الدوام.
وعندما جاء رباح الذي بحثت زوجته عنه ولم تعثر عليه إلا بعد وصولي، وأُخذت أنا الذي لم أره منذ عشرين سنة بالشبه الشديد بيني وبينه. كان الشبه قائما بالطبع عندما التقينا، رباح ومحمد أخي الثاني لأمي وأنا، في القاهرة، في السبعينات، لكن فارق السن ميزنا آنذاك بأكثر مما أظهر الشبه الذي بيننا. أما بعد هذه السنوات، بعد أن تجاوز رباح منتصف عقده الخامس، فقد صار يُشبهني حتى لكأنه توأمي. وأُخذ رباح بما أُخذت أنا به، فتجمدت حركته للحظات قبل أن تطلقها الأشواق عناقاً وتحايا. وفيما نحن متعانقان، أطلقت أمي زغرودة مديدة وارتجلت مهاهاة وعاودت دورانها الراقص. ولقد خشيت أن يغمى على أمي فهممت بإيقافها، غير أن زوجة رباح سبقتني إلى حماتها ثم أخذت تطمئنني.
- لا تقلق، هو التأثر، غيابك طال، وأنت تعرف قلب الأم.
زوجة رباح اسمها نورا، وهو اسم يليق حقاً بطلاقة محيا الغزّاوية المليحة التي تزوّجت لاجئاً درس الطب في القاهرة كما يليق بالبِشْرِ الذي تبثـّه أقوالها وحركاتها. ولم أكن قد التقيت زوجة أخي هذه من قبل، لكن رباح كان قد أراني صورتها ونحن في القاهرة حين كانا خطيبين. أما معرفتي بها فنشأت عبر المكالمات الهاتفية، هي التي كانت في الغالب أول من يردّ على الهاتف. وقد قادت نورا حماتها التي بدت على وفاق تام معها إلى صالة الجلوس وهيأت لها قعدة مريحة. واستكانت أمي دون أن تفقد يقظتها. وعلى كثرة الذين وفدوا للتحية من النساء والرجال وتنوع أعمارهم ومراتبهم، ظلت أمي هي مركز الجمع وسيّدته. ولي أن أشهد بأن إخوة رباح لأبيه، هؤلاء الذين أعدّ نفسي أخاً لهم، عاملوا أمي، هم وزوجاتهم وأبناؤهم وكل من يلوذ بهم، كأنها الملكة المتوجة عليهم بإرادتهم. وأشهد أيضاً بأن أمي بدت حريصة كل الحرص على أن تتمتع بحقوق ملكة.
- أخونا متعب وهو بحاجة إلى الراحة.
كنا قد اقتربنا من منتصف الليل فاضطر رباح التائق إلى الانفراد بي إلى أن يصرف الحشد. ولم أعترض، فقد كنت متعباً حقاً ومحتاجاً إلى الرّاحة حتى وأنا متوتر وغير قادر على الاستسلام إلى النوم. وما أن غادرنا الزوّار حتى اعتذر كل من لمى وعدي لأن عليهما أن ينهضا إلى العمل باكراً ومثلهما اعتذرت نورا المنهكة حدّ التهالك. وبقينا في الصالة ثلاثة، أمي ورباح وأنا. وحضر كأسان أعدهما رباح دون أن يستأذنني. ولأني أعرف أن أمي متدينة فقد استغربت أن يدعوني رباح إلى الشرب وهي حاضرة، أنا الذي تجنّبت في كل مرّة زارتني فيها أن أشرب أو يشرب أي من أصحابي في حضورها.
- أعرف أنك قليل دين مثل أخيك هذا، إخوته هنا كلهم متدينون. كنت به والآن جئت أنت، كنت بواحد فصرت باثنين، أرجو أن لا يعذ ّبني الله بجريرة أولادي.
لم يكن في النبرة زجر، وما أكثر ما تـُسامح الأم أبناءها!
- أمّـُنا تؤدي الفرائض والنوافل، تصوم عن نفسها وعنّا، وإذا غفر الله لنا فبشفاعتها، أليس كذلك يا أمّي؟
استثمر رباح تسامح أمّنا. وراق الحديث، وانداح في شتى المدارات الحميمة.
- ألن تتزوج؟
يبدو أن السؤال راود أمي طويلاً، ولعلّها خشيت أن تبعدنا أحاديثنا عنه فألقته هكذا، بغير مقدّمات. ولأن السؤال فاجأني، فاجأني من وجوه عدة في واقع الأمر، فإني لم أجب عليه فوراً.
- وكـّل أمرك لي، ولك أن أزوجك أحلى بنات البلد!
لا تقرّ أمي بأن الولد كبر، ولعلـّها معذورة أكثر من أي أم، فهي لم ترني أكبر أمامها.
- هل تريدين أن أطلـّق زوجتي، ألا يكفي أنّ في سجلـّي ثلاث طلاقات...
- أنا لم أرك بعد أن قلت لي إنك تزوجت في فيينا، ولم أر زوجة. ظننت أنك قلت ما قلته لترضيني وتسكت لساني، ثم إنها أجنبية، هذه التي قلت إنك تزوجتها، فهل ستجيء الأجنبية إلى هذا البلاء الذي نحن فيه.
ما كان أحذق هذه الأم! استدرجتني في هذا النحو إلى الخوض في ما يشغل بالها. إني ابنها، وما أتمتع به من ذكاء ليس سوى نصيبي من ذكائها. شاءت التي كابدت غيابي الطويل عنها أن تتيقن من نواياي، هل جاء الولد إلى غزّة من أجل الزيارة أو من أجل الإقامة، وكانت تواقة بالطبع إلى أن أبقى. فهل كان بإمكاني، أنا الذي يملك غيري قرار إبقائي في وطني أو ترحيلي عنه، أن أعِدَ أمي في تلك الليلة بشيء.
في الصباح، قبل أن تكتظ الدار بالوافدين للتحية، هتفت للدكتور رمزي الخوري، هذا الذي كان في المنفى مديراً لمكتب الأخ القائد العام لقوات الثورة الفلسطينية وصار في غزّة المدير العام لمكتب سيادة الرئيس. بكـّرت في الاتصال لأني أعرف أن صاحب اللقبين كليهما لا يحضر إلى مكتبه مبكراً. وبهذا تجنبت أن أطلب التحدث مع القائد الذي سيحرجني أن يستجيب لطلبي كما سيحرجني أن يرفضه. وأظهر ردّ د. رمزي أني لم أفاجئه.
- عرف سيادة الرئيس أنك وصلت. فمتى ستجيء إليه؟
ووشت نبرة الصوت والترحيب المحسوب بأن لدى مكتب الرئيس تعليمات بشأني وهي إيجابية.
- الأخ أبو عمار كثير الانشغال، آخذ هذا في اعتباري، وأنا في كلّ حال بين أهلي هنا وعددهم كبير، ولست مستعجلاً.
اتبعت ما رسمته. فقد عزمت على أن أتفحّص الأوضاع قبل أن ألقى عرفات ولا أكتفي بما سمعته عنها. وأردت أن أحدّد خطوتي التالية، التي قد تصير الأخيرة وأنا واثق بما أفعله، فأذهب إلى الذي سأناقش الأمر معه وقد حدّدت بالضبط ما سأطلبه منه. وحين نبهني د. رمزي إلى ما تقضي به اللياقة، تملـّصت.
- أريد أن أروي شوقي إلى أهلي، تعرف، ست وأربعون سنة، بل هي سبع وأربعون، وأقارب بالمئات، بل هم ألوف. ولن استغلّ وقت القائد من أجل لقاء مجاملة، سأسلّم عليه عندما أجيء إلى لقاء العمل.
ولكي ألغي احتمال تبديل ما اعتزمته، انتقلت إلى نقطة أخرى.
- لا تنس الشرط! أنت...
- عندما تحزم أمرك، هاتفني، وستحصل على الموعد في اليوم ذاته أو اليوم الذي يليه، وستكون الخلوة التي طلبتها، راعِ فقط أن يكون سيادة الرئيس في البلد!
وفي المساء، حين خلت الدّار من الزوّار، حرص رباح على استقصاء ما أنوي عمله، فشرحت له ما اعتزمته. وبسط رباح رأيه، أخوه أنا، قال، وأنا عزيز عليه، أكّد، لكنه في السياسة يفصل بين الشخصي والعام.
- تصرفك صحيح مائة في المائة. لا يجوز أن تظهر بمظهر المتهالك على الالتقاء به، أنت محتاج إليه، وهذا مفهوم والدوافع إليه مشروعة. لكنه هو الآخر محتاج إليك ، ووساطة الدكتور أسعد عبد الرحمن ما كانت لتنجح لو لم يكن عرفات بحاجة إلى أمثالك.
كنّا، رباح وأنا، متفقين في هذه النقطة. فاتفاق أوسلو المثير للجدل دفع عرفات في طريق أبعده عن كثيرين من الذين أعانوه قبل أوسلو في أصعب الظروف. وفي عزلته، أحاط بالرجل أشخاص وزمر تكتنف كثيرين منهم الشُبهات وتسوطهم الألسنة، وهو محتاج إلى الذين لا يحرجه وجودهم حوله.
ولقد كنت عازماً على استثمار هذا الظرف بأتمّ وجه، دون أن أهدر كرامتي. وهذا هو ما أغفى رباح وأنا ما أزال أشرحه له: استثمار الظرف دون إهدار الكرامة.
*****
الحنين، حكاية عودة هو أخر ما نشر من كتب فيصل حوراني. صدرت منه طبعة خاصة عن دار كنعان في دمشق ، تعيد ألف نشر هذا الكتاب على حلقات حصريا على النت بالاتفاق مع الكاتب

08-أيار-2021
26-شباط-2012 | |
27-نيسان-2011 | |
11-آذار-2011 | |
01-شباط-2011 | |
11-كانون الأول-2010 |
22-أيار-2021 | |
15-أيار-2021 | |
08-أيار-2021 | |
24-نيسان-2021 | |
17-نيسان-2021 |
