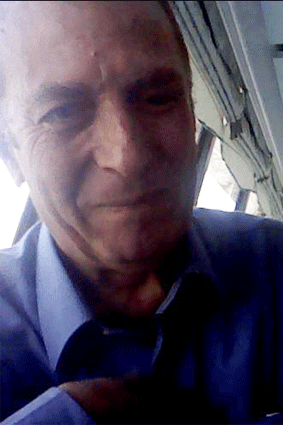
الحنين حكاية عودة ـ ج2
خاص ألف
2010-11-21
2
هل علي أن أروي لكم تفاصيل رحلتي إلى أرض الوطن، هجرتي الأخيرة التي تطلعت إلى أن أختم بها مسلسل الهجرات المتعاقبة. تعرفون دون شك كيف يعامل الإسرائيليون الفلسطينيين، كيف تستولد العنصرية القبيحة سلوكها القبيح. فإن تصورتم أني حظيت بمعاملة مختلفة لأني ضيف القيادة التي عقدت الصلح مع إسرائيل أو لأن لي المكانة التي تنسبونها أنتم إليّ أو لأن آثار الدّاء الذي يفتك بعامودي الفقري ظاهرة للعيان، وإن تصورتم أن وجعي إزاء معاينة التطبيق الفعلي للاتفاق كان أخفّ من أوجاع غيري ما دمت قد عارضت هذا الاتفاق مسبقاً ولم أعلل نفسي بأي أوهام، إن تصورتم أي شيء من هذا القبيل أو ذاك، فكفـّوا من فضلكم عن التصوّر إلى أن تعرفوا ما الذي جرى!
نعرف أن المكتوب يُعرف من عنوانه. وعنوان الوضع الذي أنشأه اتفاق أوسلو دلني عليه ما وقع على معبر الحدود. وأوّل حروف العنوان ظهر عند البوابة التي تسدّ جسر اللمبي أو جسر الملك حسين، الجسر الخشبيّ القصير والضيّق الذي يصل فلسطين بالأردن. فهنا توقف الباص أمام أول حاجز إسرائيلي. وكنّا ما نزال في أول الخريف، فكان حرّ الغور لاهباً، فلم يُسعفنا المكيّف الكليل في الباص العتيق. ومنذ توقّفنا، تلا سائق الباص التعليمات التي يبدو أنه يتلوها في كل رحلة وبدا حريصاً على أن يفهمها كلّ راكب: ابقوا جالسين في مقاعدكم، ممنوع الوقوف، وأخطر منه الحركة داخل السيارة، ولا تغطّوا النوافذ بالستائر، ولا تنسوا أن التدخين ممنوع! ولم يكن وراء القضبان الحديدية للبوابة ما يساعد على أن نفهم لماذا أُوقف باصنا فيما راحت القضبان تنفرج كلّما وصلت إلى أحد جانبي البوابة سيارة إسرائيلية. وقد طال الانتظار واشتدّ وقع اللهب. وكان عسكر إسرائيل الذين تفصلنا عنهم القضبان دائبي الحركة أو منهمكين في أحاديث، دون أن يبدو أن وقوفنا داخل الصندوق المعدني الملتهب يشغل بالهم أو أن معاناتنا تثير فيهم أي مشاعر. وكما توقفنا لسبب غير مدرك، انفتح الطريق لنا دون أن ندرك ما الذي استجدّ فأذن بفتحه.
دامت وقفتنا هذه ثمانية وعشرين دقيقة بزمن عقارب ساعتي أو ثمانية وعشرين دهراً بزمن القهر والهواجس. وكان واضحاً لكلّ منا أنها وقفة ليس لها لزوم إلا أن يكون المحتل مصراً على أن نعرف أنه هو الذي يأذن وهو الذي يمنع حتى مسألة عبور الجسر المفضي إلى أرض الوطن. وهذا هو في أي حال ما تهامسنا به في ما بيننا حين منعنا أنفسنا بأنفسنا من تبادل الحديث بأصوات جهيرة.
الوقفة التالية كانت على الجانب الآخر من القضبان، بعد أمتار فقط من البوابة. هنا، أحاط بباصنا جنود مسلحون راح بعضهم يراقبنا فيما الآخرون يتولون التدقيق في مخزن الحقائب وحنايا الباص وتحت أي غطاء فيه. كان التدقيق الذي تبلغنا أصداؤه بطيئاً، وقد جرى ونحن ملتصقون بمقاعدنا ممنوعون من إتيان أيّ حركة، وهذا بناء على التعليمات التي زدنا عليها نحن أنفسنا بأنفسنا التزام الصمت. وبعدما اطمأنّ جنود إسرائيل إلى أن الباص لا ينقل في أي من مخازنه أو فجواته أو حناياه ما يهدّد الدولة التي يحتلون، هم جنودها، أرض غيرها، صعد جنديان مسلحان ببندقيتين إلى الباص بينما بقي زملاؤهما محيطين به، ووقف احد الجنديين وقفة ترصّدٍ في آخر الباص فيما وقف الجندي الثاني الوقفة ذاتها في أوله. وبهذا، صار كل راكب في مرمى نظرات الجنديين مثلما هو في مرمى رصاصهما. ثم صعد رجل أمن لا يحمل سلاحاً ظاهراً وصعد معه احتقاره الظاهر وبغضه لركاب الباص، بغضه الذي لا يتستر عليه. وتولى الرجل التدقيق في وثائقنا، لا لشيء، كما اتضح لي، إلا ليتحقق من أن كلّ راكب يحمل ما يجيز له الوصول إلى المبنى الذي تشغله إدارة المعبر. وكان هذا التدقيق هو الآخر بطيئاً، أجراه الرجل بإيقاع ذكرني بإضراب التباطؤ عن العمل. تُقدّم للرجل الأوراق التي يطلبها منهك فيقلـّبها واحدة واحدة، ثم يقلـّب كلّ واحدة صفحة صفحة، ويقرأ المكتوب في كلّ صفحة، بعضه أو كلـّه، ويتأمّل في الصور، ويقارن بين كلّ صورة وبين وجهك، ثم يقارن بين الصورة التي على وثيقة السفر أو بطاقة التعريف وبين التي على إذن الزيارة، يجري رجل الأمن المقارنة دون أن يخفي استرابته، ثم يعيد إليك أوراقك، يعيدها؟ إنه يلقيها نحوك إلقاء فتلتقطها يداك إن كنت منتبهاً أو تقع في حجرك أو تسقط على الأرض، ثم ينتقل هو وبطؤه واسترابته إلى الذي يليك. هذه الوقفة استغرقت أكثر من ساعة بحساب العقارب، ناهيكم بحساب القهر والتأذي !
الوقفة الثالثة كانت إزاء بوابة أخرى تعبرها السيارات كي تصل إلى مبنى إدارة المعبر. هنا، عند هذه البوابة، وقع نظري على جنديّ جالس على الأرض وظهره مسنود إلى عضّاده اسمنيّة وإحدى ساقيه ممدودة أمامه والثانية مثنية وإحدى يديه ممسكة ببندقيّة قائمة بحذائه والأخرى طليقة.
وكان هذا الجندي يتبادل حديثاً مع زميل له ظهره مسنود إلى العضّادة ذاتها وهو واقف وبندقيته في يد فيما يده الأخرى تتحرك في إيقاع بدا مُتسقاً مع إيقاع الحديث. وكانت على رأس الجالس الطاقية التي تظهر انه يهودي متدين، أما زميله فكان يعتمر خوذة الجنود. ولم ينقطع حديث الجنديين بوصولنا، كما أنه لم ينقطع حتى حين كان ذو الطاقية يلتفت ويلقي نحونا نظرة تمتدّ كما بدا لي الوقت الذي يحتاجه ليتيقن من أن معاناتنا وسط اللّهب لم تُنتقص. وقد دامت وقفتنا هذه بزمن عقارب الساعة عشرين دقيقة.
الوقفة التالية، الرابعة على مسافة لا تزيد عن بضع مئات الأمتار، كانت إزاء مبنى الإدارة. هنا، توقّف الباص بمحاذاة رصيف ملتصقٍ بالمبنى فهرع ناحيته مسلّحون كانوا في الانتظار فأحاطوا به. وأبقتنا تعليمات السائق في مقاعدنا. وكنّا هنا، أيضاً، ممنوعين من إتيان أيّ حركة. وعندما تلقى السائق الإشارة المناسبة، أذن الرجل لنا بالنزول مهنئاً إيّانا بسلامة وصولنا مما عنى أن هذا سيكون آخر عهدنا بباصه. وتوجّه كل راكب إلى حيث كُوّمت الحقائب بجانب الباص واستلّ حقيبته من الكومة والتحق بالصفّ الطويل الذي يقف فيه الوافدون قبلنا. ومثل كلّ شيء آخر، كان الصفّ يتحرّك ببطء حتى لكأنه ثابت. وحين بلغت أنا مقدمة الصفّ بعد دهور لم أحسب عددها، وجدتني إزاء فتاة أمن إسرائيلية ومساعدين لها موكّلين باستلام الحقائب. النظرة المستريبة، بل النظرات، والحركات المستهينة، ونبرة الصوت المنتهرة، والتعالي، وفوهات البنادق، وعيون حامليها التي تمسح الواقفين في الصفّ كأنها الكشّافات الضوئية التي تمسح مواقع العدو في زمن الحرب، هذا هو ما أحاطني وأنا مجمد إزاء الفتاة بانتظار أن أعرف خطوتي التالية.
طلبت الفتاة أوراق سفري، وفحصتها، وأجرت المقارنات. وحين بدا أن الفتاة فرغت من فحص أوراقي، شال حمّال من مساعدي الفتاة حقيبتي ووضعها على آلة الفحص. وألصقت الفتاة قسيمة على الحقيبة ثم ألصقت قسيمة مماثلة على وثيقة سفري. ولأنّ هذا كلّه جرى ببطء، فقد أتيح لي أن أتأمل التي أقف مجمداً إزاءها. ولم أصدق أنّ فتاة في أولى عشرينيات عمرها، جميلة ورشيقة وبارزة الأناقة، يمكن أن تظهر لمسافر عابر كل ما أظهرته فتاة الأمن الإسرائيلية من بغض واحتقار لو لم توجب وظيفتها عليها إظهاره. لم يكن في هيأتي ما ينفّر، ولم أظهر ضيقي بل أرغمت نفسي إرغاماً على التجلّد، فهي إذن، طبيعة المهنة التي تمارسها هذه الفتاة، وهو الموقف الذي وضعها في صفّ المعتدي الصلف، ولعلها، أيضاً، التعليمات التي تتلقاها من رؤسائها. رسمت هذه الطبيعة مشاعر الفتاة وصاغ الصلف سلوكها. وأجازت لها التعليمات أن تحيطني بما أحاطتني به دون تستر أو أوجبت عليها أن تحيطني به. ولي أن أزعم أني رصدت التماعة شعّت في عينيّ فتاة الأمن هذه ففسرتها أنا على أنها التماعة ضيق. وقد تساءلت عما يضايق الفتاة، أهو اضطرارها إلى أن تتصرف بفظاظة، أم هو اضطرارها إلى التعامل مع ناس تبغضهم؟ هل كانت الالتماعة انبجاسة مشاعر إنسانية تكبتها الوظيفة أو تعبيراً عن مشاعر عنصرية تبيح الوظيفة الإفصاح عنها؟ تساءلت، ولم أصل إلى إجابة.
ويبدو أن انشغالي بمراقبة الفتاة أبقاني أمامها أطول مما هو مباح. وقد أخرجني من شرودي فحّةٌ أحسست نثار سمّها على جلد وجهي: "يللا!"، يللا جافرة فحّتها الفتاة وهي تدفعني بأوراقي ذاتها كي أنصرف عنها. والتقطت الأوراق، وتبعتُ الذين سبقوني على خط سير حددته عيون الجنود وفوهّات بنادقهم.
خطوات قليلة أبلغتني مدخلاً تتصدره لوحةٌ مكتوب عليها: السلطة الفلسطينية، وقد رُسم العلم الفلسطيني بجانب الكتابة. وتصورت أني خرجت من دائرة البغض والاحتقار وانتقلت إلى ربعي. لكن، ما أسرع ما انطفأ تصوّري!
كنت أمنّي النفس بمتعتين، متعة الملامسة الأولى مع أرض الوطن الذي أعود إليه بعد نفي طالت مدّته ومتعة اجتياز معبر أتعامل فيه لأول مرة في حياتي مع رجال أمن فلسطينيين. المتعة الأولى غاضت في طاقية جنديّ الحاجز العسكري حتى لقد نسيت أمرها نسياناً تاماً. أما الثانية، هذه التي تطلعت إلى الظفر بها لأن الاتفاق نص على أن يكون الوجود الإسرائيلي على معبر الحدود غير مرئي، فقد غاضت هي الأخرى مع توالي المشاهد التي بيَّنت كم هو سافر وكثيف ومتسلـّط هذا الوجود. وحتى بعد أن عبرت المدخل الذي تتصدره اللوحة، فقد توجب أن أتوقف ثانيةً إزاء فتاة أمن إسرائيلية ومساعدين لها كي تفحصني، أنا نفسي، آلة أشعة عُيّرت بحيث لا يعبرها حتى خاتم الزواج دون أن يثير جلبة. بالرغم من هذا، فإن رؤيتي اللوحة، وما هو مكتوب ومرسوم عليها أثّرت فيّ، وطغى التأثّر على ما كابدته من مرارات. وقد اشتدّ تأثري حين وقعت عيني، بعد عنائي مع آلة الأشعة وفتاتها التي أرغمتني حتى على خلع حذاءيّ، على شاب فلسطيني مشرق الوجه في بذلةِ خدمةٍ جديدةٍ وأنيقة وعلى كتفيه شارات تظهر أنه ضابط، وهو يرحب بالقادمين.
السلطة، والعلم، وهذا الشاب وترحيبه بي، فكيف لا أنسى ضيقي بما مررت به. ولم يكن غريباً أن أحسّ ببراعم فرح تتفتح في داخلي وأنا أستجيب لترحيب الشاب كأنه قريب لي أوفدته الأسرة ليكون في استقبالي. ولقد كان هذا تحولاً في مشاعري، تحولاً كان من شأنه أن ينمو فتواصل البراعم تفتحها لو لم يُعاجلني ما أخمد الفرح واجتثّ كلّ برعم.
استقبلني ناس أمن فلسطينيون، شابّات وشبّان دُرّبوا تدريباً حسناً وهُندموا هنداماً أنيقاً. وأشعرني هؤلاء بأني حقّاً بين أهلي. وفي صدر الصالة التي كنت فيها، جلس أربعة من هؤلاء خلف منصّة اتجهت أنا إليها. وتسلمت أوراقي شابّة في زيّ الشرطة لها سمات ساكني الغور وحلاوة وجوههم. وقد رحبت الشابّة بي وهي تجتهد في إظهار الكياسة، ودققت أوراقي دون استرابة، ثم دعتني إلى الانتظار، وطمأنتني: "لن يطول".
والواقع أن ما لم يطل كان هو ابتهاجي بهذه المعاملة الكيّسة، أما انتظاري فقد طال. فوراء المنصة، وراء ناس الأمن الفلسطينيين وأعلى منهم، تنتصب واجهة بعرض المنصة يستطيع الجالس وراء زجاجها أن يراك دون أن تراه. وقد انتبهت إلى هذه الواجهة حين وضعت الشابّة الفلسطينية أوراقي في جارور ودفعت الجارور ناحية الجالسين وراءها. ثم رأيت كيف رجع الجارور وفيه أوراق العابر الذي تقدمني في الصف. ولما امتدّ انتظاري وامتدّ دون أن يعيد الجارور أوراقي، فقد بدا على شابّة الأمن الحرج. وقبل أن أمعن في التكهّن، انفتحت سمّاعة مثبّتة على المنصّة، وقال صوت له النبرة التي لفتيات الأمن الإسرائيليات شيئاً بالعبرية، فطلبت منّي الشابة الفلسطينية أن أدير وجهي بكامله ناحية الزجاج حتى تراه صاحبة الصوت. ثم انفتحت السماعة مرة أخرى وصدر أمر الصوت إليّ أنا، صدر بما ظنّت صاحبته أنه كلام عربي: "فيسال، شيل ندّارة!" فنحيت نظارتي عن وجهي؟
أدركت لماذا طال انتظاري، فالمتأملة في صورتي أربكها وضع عينيّ الذي تظهره الصورة مختلفاً عما تراه هي من وراء زجاج واجهتها وزجاج نظارتي الطبية. فأنا أحمل عيناً واحدة طبيعية أما الثانية فصناعية شبيهة بالطبع بالعين الأولى لكنها لا تتحرك مثلها. وفي العادة يجتهد ملتقط صورتي كي تظهر العينان متطابقتين في شكلهما، أما في وقفتي أمام الزجاج وحركة عين وجمود الثانية فقد بدا شكل عينيّ مربكاً للمتأمّلة في الصورة.
وحين رجع الجارور بشيء، تبيّن أنه أرجع وثيقة سفري دون بقيّة الأوراق، وظننت أنهم، وراء الزجاج، لم يفرغوا بعد من تدقيق أوراقي، فوطدت النفس على مزيد من الانتظار. لكن سرعان ما انفتحت السماعة وصدر منها شيء بالعبرية شرحته الشابة التي اشتدّ تحرجها، فعرفت أن المخابرات الإسرائيلية تطلبني وقد حولت أوراقي إلى مكتبها في المعبر. وقالت الشابة: "حسب الاتفاق هذا من حقّهم".
وفيما أنا منصرف عن المنصّة، وجدتني وجهاً لوجه أمام فوزي عودة، وعرفت أن هذا الضابط في قوات الثورة الفلسطينية قد صار مقدماً في شرطة السلطة وأوكلت إليه السلطة مسؤولية المعبر الذي أنا فيه. وترك فوزي ما كان قادماً من أجله واصطحبني إلى حجرة مكتبه وطلب لي فنجان قهوة ليروق مزاجي كما قال. وتحدث فوزي في الهاتف إلى من أدركت أنه الإسرائيلي الذي طلبني. وقال فوزي ما يمكن قوله في هذا المقام: "الأستاذ فيصل صديقي، وهو كاتب وعضو مجلس وطني، وهو ضيف الرئيس الفلسطيني وصديقه"، وما إلى ذلك مما توخّى صاحبي أن يبهر به من أنا مطلوب منه.
- هي مسألة سؤال وجواب، ستذهب حالاً إلى الذي استدعاك ولن يحوجك إلى الانتظار.
وهداني شرطيّ فلسطيني إلى باب لا يحق له هو أن يتخطّاه وهناك، تسلّمني إسرائيلي من أعوان رجل المخابرات، فسرت وراءه وكلانا صامت. وانتهينا إلى حيث ينتظم صفّ طويل من الفلسطينيين الذين استدعوا قبلي. وخطر لي أن أقف في آخر الصف مع علمي بأني غير مطالب بالانتظار. ألا يحرج المقهور أن يتخطّى مقهورين مثله ويتميّز عنهم. إلاّ أن الإسرائيلي حثـّني على المتابعة بإشارة من يده صارمة الدلالة، فسرتُ وراءه في موازاة الصفّ خافض الرأس. وفجأة، هدر صوت بإسمي، وكان صاحب الصوت هو حنّا ناصر رئيس جامعة بيرزيت الذي أعتزّ بعلاقتي الطيبة به. وشئت بالطبع أن أقف وأسلـّم على الصديق الذي ألقاه لأول مرة على أرض الوطن. غير أن الإسرائيلي سحبني من يدي سحباً ثم وقف بي أمام باب طَرَقَهُ طرقةًًً خفيفةً وفتحه ودفعني إلى الداخل. ووجدتني إزاء رجل في ملابس مدنية جالس على كرسي خلف مكتب وأمام المكتب كرسي آخر شاغر.
تلقّاني رجل المخابرات الإسرائيلي بنظرة تفحّصتني بصرامة منذ ولجت باب حجرته. وعندما صرت أمام الرجل، وقف هو، ومدّ يده للمصافحة، وقدّم نفسه بهذا الاسم العربي : "فريد". ورحّب الرجل بي بعربية طلقة، بعبارات إن كنّ من العبارات الجاهزة فهنّ مما لا يستخدمه الإنسان إلا حين يصطنع المودة.
- فريد اسم مستعار بالطبع.
أردت أن يفهم رجل المخابرات بهذا أني لست غرّاً تأكل المجاملات حذره ولا قليل الخبرة. وقد تجاهل هو ملاحظتي حتى لكأنه لم يسمعها، وواصل ما بدا لي أنه أسلوب مهنيّ تدرب عليه، فكرر الترحيب. كان هذا رجلاً في عقده الرابع، ومع أنّي تأملته لأعرف منبته فإن ملامحه لم تشِ بهذا المنبت، فهي ليست اشكنازية كما أنها ليست سفاردية وليست حتى بين بين. ودلّ حديث الرجل على أنه يتقن العربية إتقاناً متميزاً ويستخدم اللهجة التي يستخدمها من حصّلوا من الفلسطينيين تعليماً عالياً. إلاّ أن نطق الرجل بعض الحروف اتسم بلكنةٍ تكشف أنه ليس من أبناء العربية وإن بدا أنه يحرص على إخفاء هذه اللكنة.
اللكنة ومحاولة إخفائها، وزيف الترحيب، والإفراط في استخدام عبارات المجاملة الجاهزة، هذا كلّه قوّى حصانتي ضدّ الوقوع في أفخاخ الكلام. ودون أن أقصد ذلك، انبثق من خزين المرارات ما تحويه الذاكرة من جرائم رجال المخابرات الإسرائيلية، فتفاقم ضيقي، واحتجت إلى استنفار إرادتي بأشدّ قوّتها كي أسيطر على ردّ فعلي.
شاء الرجل، على ما بدا لي، أن يجعل ترحيبه بي فاتحة لحديث تنحلّ فيه تحفّظاتي، فبدا لي غبياً لأنه اختار هذه الفاتحة الزائفة بالذات.
كنت على يقين من أن المرحب بي لا يُكنُّ لي أي مودّة، ولا تبهره الصفات التي أضفاها عليّ المقدم فوزي، وليس في عودتي إلى وطني الذي يحتلـّه جيشه ما يسعده. وما دام الرجل قد غالى في الترحيب، فإنه لم يزد على أن دفعني دفعاً إلى الإحساس بأنه يستغبيني. وقد تحتمل أن يستغبيك من ليس عدواً لك، أما أن يستغبيك عدوّ فهذا فوق الطاقة.
هل فطن رجل المخابرات إلى هواجسي؟ لا أظنّ أن هذا المحترف قد فطن لأيّ شيء، فلو أنه فطن لـَما أمعن في اصطناع المودة. وأغلب الظنّ أن الرجل نسب صمتي وهو يرحب بي إلى دهشتي إزاء حسن استقباله. وفيما هو ماضٍ في ما بدأ به، أخذت المسافة التي تفصلني عنه تمتلئ باللزوجة. الاسم المستعار من أسماء العرب، والابتسامة المرسومة بريشة المهنة القبيحة، والمغالاة في الزيف، فهل يمنعني الختل عن التفكير بأنّ هذا الرجل ذاته ربما عذّب بيديه زملاء لي وأصدقاء وأقرباء. ألم يرسل ناس المخابرات الإسرائيلية، على تعدّد مؤسساتهم، ألوفاً من أنبل أبناء فلسطين إلى المعتقلات، ألم يعذّبوهم ، ألم يفتكوا ببعضهم حدّ القتل، أليس الاحتلال في حدّ ذاته جريمة وهؤلاء هم عيونه وآذانه مثلما أنهم هم أنيابه. مقتنع هو دون شكّ بأن معسول الكلام يفتن العربيّ ويأسر إرادته، وهل يوجد محتلّ مبرأ من العنصرية. هل قلت اللزوجة؟ إن ما فصلني عن رجل المخابرات الإسرائيلية يستحق وصفاً أعفّ عن ذكره.
- اسمك؟
أخرجني السؤال من سهومي لكنه لم يوهن إحساسي بالتأذي.
- اسمي، عمري، مهنتي، وما إلى ذلك، هذا كله موجود في أوراقي وهي أمامك. أنت لم تستدعني لأكرر ما تعرفه.
لم يكن خفيفاً ذلك الرجل، غير أن الإجابة غير المتوقعة فاجأته دون شك. وخيل إليّ أني أربكت رجل المخابرات، لكنه بقي متماسكاً.
- هذا ليس تحقيقاً رسمياً، أحببت أن أتبادل معك حديثاً، حديث إنسان لإنسان، عرفت أنك كاتب، فأردتُ ..
- لماذا لا تدخل في الموضوع؟
- في الحقيقة ، أردت أن أعرف رأيك في الاتفاق. عندكم أكثر من رأي ..
- هذا مكتب أمن، وأنا لا أستعرض في مكاتب الأمن آرائي السياسية، هذا المكتب أو غيره، فإن كانت عندك أسئلة بخصوص مسائل أمنية تنسبها لي فإني أصغي.
تركني الرجل أتمُّ ثورتي الصغيرة، لكنه لم يؤخذ بعنادي.
- إنه الفضول الشخصي ولا شيء غيره. أحبّ أن أتعرف على الطيّبين وأعرف آراءهم في ما يشغلنا كلّنا، فما الذي تخاف منه. لو سألتني عن رأيي لأجبت بكل سرور، فأيّ ضرّر يصيبك إن أحببت أن أتعرف عليك؟
- الطيبون وغير الطيبين، يتعارف الناس في ظروف متكافئة ، يتبادلون الآراء برغبتهم وليس بالإكراه. بالإكراه يصير للأشياء أسماء قبيحة، أنت تعرف. وأنا لم ألتق بك برغبتي فأنت الذي..
- هل كثير أن أعرف رأيك في الاتفاق؟ أنا لا أطلب أن تبوح بالأسرار.
لماذا تشبث هذا المحترف بظنه أني غرّ. إني أعرفهم، وهم متماثلون، ناس المخابرات هؤلاء في كلّ مكان، قل أي شيء أمامنا في البداية وبعدها يأتي وقت قول ما نريد سماعه.
- رأيي في الاتفاق لا أعرضه أمامك. حكومتكم فاوضت منظمة التحرير الفلسطينية، منظمتي، وإذا كان عندي ما أقوله فإني أقوله لناسنا. فهل يرغمني الاتفاق على عرض آرائي أمام مخابرات إسرائيل؟
يبدو أن الملاحظة التي قلتها من باب المشاكسة كانت نقطة في الصميم. فالبروتوكول الذي ينظم إجراءات المعبر لا يجيز التنقيب في آراء العابرين. وأغلب ظنّي أن الرجل تصوّر أني مطّلع على هذا البروتوكول. والذي حدث أن رجل المخابرات وقف فجأة وبسط ابتسامته المهنية على وجهه، ومدّ يده لمصافحة الوداع، وسأل: "كاتب؟ فهل أنت كاتب سياسي أو أديب؟".
أن ينتهي اللقاء في هذا النحو، بهذه السرعة، أن لا أتعرض للمتاعب التي هجست بها، كان في هذا نجاة لم أتوقع الظفر بها بهذا اليسر، فوجدتني أقول بنبرة بارحتها روح التحدّي:
- الأدب والسياسة معاً، الأدب هو الحياة، والسياسة هي أيضاً الحياة.
ولدهشتي، أنا الذي صرت راغباً في الحديث، لم يُبدِ هو أيّ اهتمام بما أقول، حتى لقد خيّل إلى أنه لم يصغ إلى إجابتي.
فوجئ المقدم فوزي بعودتي : "لم تبرد القهوة التي طلبتها لك". فرويت ما جرى. وحثّني صاحبي على استعادة أدق التفاصيل. وهو الذي أفهمني أن البروتوكول يجيز لي أن أرفض الإجابة. لكن صاحبي الذي تلقى موقفي بارتياح حذ ّرني: "لن يفوّتوها لك، فهيئ نفسك لاستفزازاتهم !".
توجهت إلى المخرج الذي مَثُل أمامي وأنا أظنّ أن متاعبي على المعبر بلغت نهايتها. غير أن رجل أمن إسرائيلي رابض وراء كمبيوتر استوقفني وعالج أزراراً على كمبيوتره ثم أفهمني أني مطلوب لتفتيش ما لم تفصح عربيته البائسة عن طبيعته. وتوجهت إلى حيث أشار رجل الكمبيوتر لأكتشف أني مطلوب لما يسمّونه التفتيش الأمني.
وهنا، أيضاً، كان في الانتظار عدد كبير من الخلق، فتوجب أن أنتظر ساعة، ساعة بحساب عقارب الساعة. أما بحساب المرغم على البقاء بغير حركة الذي تكتنفه النظرات المستريبة وفوهات البنادق، فقد بدت هذه الساعة دهراً مديداً. وحين طولبت بالتوجه إلى الركن المنزوي الذي يُجرون فيه هذا التفتيش، وجدت منصّة تقف وراءها فتيات الأمن الموكلات به، ولم أعرف إلى من منهن ينبغي أن أتجه، فبقيت حائراً إلى أن جاءني أمر إحداهن : "هون، من فدلك!". هذه العبارة التي ستبدو لمن يقرأها مهذبة جاءت مع النبرة التي صرتم تعرفونها انتهاراً لا صلة له بأي تهذيب. وبالنبرة ذاتها، أمرت بأن أبحث عن حقيبتي بين الحقائب المكومة في الركن. وحين جئت بالحقيبة، أشارت الفتاة إلى المنصّة، ونبرت: "حط شنتة هون!". فرفعت حقيبتي، ووضعتها عل المنصّة أمام الفتاة، فيما كانت هي قد شرعت في حديث مع زميل لها قدم من حيث لا أدري وأهملتني.
طالت وقفتي أمام المنشغلين بحديث بدا لي بغير نهاية. واشتدّ ضيقي، أنا المزروع في الموقف المحرج المتهيب من التفوّه بكلمة أو الإتيان بحركة. وحين انتهى الحديث آخر الأمر، كست الفتاة وجهها تكشيرة ويديها قفّازين، واستعاد صوتُها النبرة المنتهرة. وبهذا كلّه، سدّدت فتاة الأمن نحوي رشقة أسئلة: هل هذه الحقيبة لك؟ هل ساعدك أحدٌ على تعبئتها؟ هل فيها سلاح؟ مال؟ مجوهرات؟ هل حمّلك أحدٌ شيئاً لتنقله إلى إسرائيل؟ هل أنت، إذن، مسؤول عن كل ما في الحقيبة؟ فلمّا لم تشِ إجاباتي بما يريب، فقد صدر الأمر على الفور: "افتح شنتة!". وما أن عالجت قفل حقيبتي وفتحتها حتى طلبت الفتاة منّي، بالإشارة، هذه المرّة، أن ابتعد عنها وأجلس على مقعد قبالتها.
من هذا المقعد، راقبتُ اليدين وهما تجوسان في الحقيبة وتستخرجان حوائجي قطعة قطعة وتنتهكان خصوصية أشيائي بلا تستر، تبقيان قطعاً في الحقيبة وتكوّمان قطعاً أخرى إلى جانبها. وقد استخرجت اليدان الآلة الكهربائية التي تنظّم تنفسي أثناء النوم، أنا المصاب بداء يجعل رئتيّ أكسل من أن تقوما بالمهمة وحدهما. ويبدو أن الآلة حيّرت الفتاة. وكنت محتاطاً لهذا الموقف فأبقيت مع الآلة كرّاس التعليمات الخاص بها والتقرير الطبي الذي يصف لي استخدامها، لكن الفتاة لم تنتبه لوجودهما.
وشئت إزاء حيرة الفتاة أن أجتذب انتباهها إلى الكرّاس والتقرير، فنهضت عن المقعد ناوياً أن اتجه إليها، غير أن الصوت المنتهر زجرني: "إبكَ كرسيّ". ومن حسن حظي أني فهمت هذه العبارة التي لا تُفهم، فبقيت في كرسيّ. واستدعت الفتاة أحداً، فلبّاها من بابٍ خلفها فتى حمل الآلة ومضى بها، ثم استأنفت النبش والفرز حتى استوفته. وعندما أرجع الفتى الآلة، تصورت أن أوان خلاصي قد حان. لكنّ الفتاة كانت قد انشغلت من جديد بحديث جرى هذه المرة مع زميلة لها استوفت نبش حقيبة أخرى.
وفي حيرتي، أنا الذي رأيت ما جعلني أستحضر أجواء روايات فرانز كافكا، لم أدر ما إذا كان من حقّي أن أنبّه الفتاة إلى حاجتي للإنصراف أم إن في هذا مجازفةً بالتعرض للزجر. وبالرغم من اشتداد ضيقي، آثرت أن أنطوي على حنقي، وشحنت تصبّري بدفعة جديدة مما بقي من قوة إرادتي، وهدّأت نفسي. ومضت بحساب عقارب الساعة دقائق أخرى، صرتم تعرفون كيف أقيسها أنا بحساب الضيق، وأنا أهدهد الأمل بأن الفتاة ستنتبه لي ذات لحظة فتطلق سراحي. وحين حانت هذه اللحظة وانتبهت الفتاة إلى عملها من جديد، توقعت أن تستدعيني هذه الفتاة لألمّ حوائجي وأمضي بها. إلا أن الفتاة هتفت بدل ذلك بإسم، فلبّاها شاب تظهر ملامحه أنه من يهود اليمن. وحمل الشاب حوائجي المكومة إلى جانب الحقيبة ومضى بها. زمن آخر أطول، وضيق أشدّ، وفقدان حيلة معذ ّب، ثم عاد الشاب بحوائجي وألقاها إلقاء داخل الحقيبة. وفي هذه الأثناء، كانت الفتاة التي أنتظر منها إشارة الخلاص قد انشغلت بحديث جديد. ولم أهتد أنا إلى وسيلة أنبّه بها الفتاة لوجودي دون أن أتعرض للزجر أو أثير ريبة العيون وفوهات الأسلحة التي تحيط بنا.
وأبقتني حيرتي في مقعدي دهراً آخر إلى أن صار وقع الانتظار أثقل من أيّ قدرة على الاحتمال. فوقفت بجانب مقعدي متردداً بين التهيب والإقدام. وعندما انتبهت الفتاة إليّ بدا أن حركتي ساءتها، لكنها لم تزد عن أن رمتني بنظرة مؤنبة ودعتني بإشارة من يدها إلى المنصة ثم نبرت: "سكّر شنتة!". فتعجلت تسوية حوائجي وإقفال الحقيبة كيفما اتّفق، وهممت بالانصراف بها فيما الفتاة منشغلة بالحديث. لكن، ما أن حرّكت حقيبتي، وقبل أن أبرح بها المنصّة، حتى اتّضح أن يقظة فتاة الأمن ما زالت تشملني: "شو إنت ما بيفهم، حمار إنت؟ خلّ شنته وانكلع!". وجلجلت الشتيمة في المكان وسمعها كل من فيه.
رويت لكم هذه التفاصيل كلها لتدركوا سبب انفجاري بعد أن احتملت ما احتملت. لم أفهم سرّ استياء الفتاة ما دمت لم أخالف لها أمراً أو إشارة. كما لم أفهم لماذا ينبغي أن أنصرف بدون حقيبتي التي استُوفي تفتيشها. فهل كان بمقدوري أن أواصل ابتلاع المهانات دون أن أنفجر. وجود المحتلّين في حدّ ذاته فيه ما يكفي من الاستفزاز حتى لو أحسنوا السلوك، فكيف والسلوك هو هذا الذي وصفت لكم بعضه!
انفجرت دفعة واحدة. فاض مخزون الحنق، قديمة ومستجدّة. وهدر كلام لم أنتق تعابيره ولم أدققها. إنه الحنق حين ينفثئ دمّله فيسيل ويهدر. ولم أنتبه إلى نفسي إلا حين رأيت الفتاة تبكي. نعم، بكت فتاة الأمن، فأذهلني بكاؤها.
كان المقدم فوزي قد غادر المعبر فانشغل معاونوه بالمشكلة، الجدل الممضّ مع أسياد المعبر، والاتصالات، ومكتب الرئيس في أريحا الذي يبدو أنهم استنجدوا به. كل هذا وأنا محتجز ومتهوم بأني أهنت موظفة أمن واعتديت عليها أثناء قيامها بواجبها وتمردت على أنظمة المعبر. ساعتان بحساب العقارب ولا داعي للانشغال بحساب آخر؛ مرّ الوقت وأنا أتوجس أني لن أنجو من هذه الورطة، فكيف تقاس أوقات الهواجس. وفي الختام، انعقدت تسوية. وقيل لي إن التسوية تيّسرت لأن الفتاة سامحتني وغفرت لي تطاولي عليها. وصار عليّ وفق أحد بنود التسوية أن أطيّب خاطر الفتاة فأعتذر لها وأطلب رضاها ثم أشكرها على تسامحها.
و في الركن الذي أرجعت إليه لأصالح الفتاة، توجب أن أتبع بقية الإجراءات. ولما كانوا قد روضوني على احتمال الأذى حتى لا أتعرض لأذى أشدّ منه، فقد اتبعت هذه الإجراءات وأنا مستكين. واتّضح أن من المحظور على العابر الفلسطيني حمل حقيبته بنفسه في أي مكان فيه ناس الأمن الإسرائيليون، وهؤلاء موجودون في كل مكان. أما كيف تعبر الحقائب المعبر فإن ساحباً آلياً يلقيها بعيداً. وقد وجدت حقيبتي وسط كومة الحقائب التي ألقاها الساحب على الجهة الأخرى من المخرج الذي يربض رجل الكمبيوتر عنده.
المحتل جائر، والواقع تحت سطوة الاحتلال ضحيّة. معتدٍ وضحية، هذا هو جوهر الوضع، وهو جوهر لا يبدّله نوع السلوك الشخصيّ لأي من طرفيه. ولن ينصلح هذا الوضع إلا بزوال الاحتلال.
- علينا أن نصبر. نحن على أول درب والمشوار طويل يا أخي ومعقّد. وليس لنا إلا الصبر.
بهذه الكلمات واساني موظف في الجمرك الفلسطيني الذي كان آخر من تعاملت معهم، فعرفت أنه قد انشغل بالمشكلة هو الآخر. وهذا الموظف هو الذي دلّني على الباص الذي يحمل العابرين إلى الاستراحة المخصصة لهم في أريحا وقال: "في الاستراحة تجد السيارات التي تنقل المسافرين إلى شتى الاتجاهات".
غادرت عمان في السابعة صباحاً. وغادرت المعبر الأردني بعيد الثامنة. ولو لم يكن الاحتلال الإسرائيلي موجوداً لبلغتُ أريحا بعد دقائق، سبعة أو ثمانية. أما مع وجود هذا الاحتلال، فقد بلغت أريحا في الثانية بعد الظهر.
أيها الوطن الذي لا وطن لنا سواه، كان الخروج منك موجعاً وصارت العودة إليك موجعة. والسبب واحد في الحالتين والمسبّب!
table.MsoNormalTable { font-size: 11pt; font-family: "Calibri","sans-serif"; }
الحنين، حكاية عودة هو أخر ما نشر من كتب فيصل حوراني. صدرت منه طبعة خاصة عن دار كنعان في دمشق ، تعيد ألف نشر هذا الكتاب على حلقات حصريا على النت بالاتفاق مع الكاتب

08-أيار-2021
26-شباط-2012 | |
27-نيسان-2011 | |
11-آذار-2011 | |
01-شباط-2011 | |
11-كانون الأول-2010 |
22-أيار-2021 | |
15-أيار-2021 | |
08-أيار-2021 | |
24-نيسان-2021 | |
17-نيسان-2021 |
