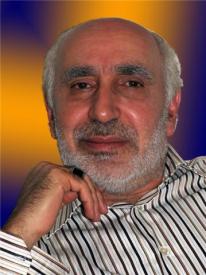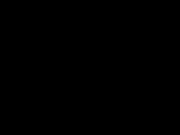توقفنا في مكان سماه السائق لي " نهر عيشه " والحق يقال أن النهر الوحيد الذي شاهدته هناك كان لونه أصفر و مكوّن من سيارات الأجرة التي أخذ سائقوها بالتدافع وخطف حقائبي ، بعد فترة من الشجارو التفاوض فيما بينهم استقر بي الحال في أحد السيارات ، ونحن نهم بالانطلاق تذكرت نصيحة صديقتي لي بأن أتظاهر بمعرفة المكان وكأنني " بنت البلد" اعتقدت أن هذا سيكون سهلاً بما أني ابنة البلد بشكل ما حتى لو لم أعرفه حق المعرفة
في بداية كل عام دراسي، كانت تبلّلني دموع شجن حامضة.. دموع ذلك الطفل الذاهب إلى العمل كسيراً، وأصحابه يزقزقون فرحاً كالعصافير وهم في طريقهم إلى المدرسة. هذا كان في الأزمنة الرخوة، قبل أن يشدّ الموت قوسه ويطلق سهامه على عصافير أكبادنا، فبعضها احتوته القبور، وبعضها قصقصت جناحيه، بعضها توارى في الجحيم الداخليّ، وبعضها فرّ بروحه وأحلامه خارك الحدود. فكيف بي الآن؟ وملايين الصغار، الشهداء منهم والأحياء، يطالبونني بكتبهم ودفاترهم وأقلامهم وضحكاتهم وشقاواتهم
رايت لقطة مجتزأة لعساكر سوريين ينظفون منطقة التضامن من "الجرادين" كما قال احدهم.... ووعد بأن يكمل مهمته في التخلص من "الجرادين".
"الجرادين" هم نحن جميعاً على مايبدو.
كما سمعت عن قتل العساكر المساكين في حلب مكبلي الايدي ليموتوا استعراضاً لشهوة الانتقام.....
مات السفير الأمريكي انتقاماً لفيلم لم يعرض بعد ولكن اخذاً بثأر يتخيله أصحاب الفكرة...
لهذا كان على الفُرقاء أن يجتمعوا من شتاتهم، ويتوحّدوا. وهو ما كان. يوم الخامس من سبتمبر الجارى كان موعدنا فى «مركز إعداد القادة»، لانطلاق المؤتمر الأول وإعلان البيان التأسيسى لجبهة «مصرُ الوطن». يا إلهى! يا له من اسم! وكأن الشك قد بدأ يتسربُ إلى نفوسنا بأن لنا «وطنًا»، اسمه: «مصر»، فبات علينا أن نُذكَّر أنفسنا بأن لا هُويةَ لنا إلا: مصر. على أننا فى الواقع لم ننسَ، لنتذكر. إنما نُذكِّر أولئك الذين يحاولون أن يشكّكوا فى تلك الحقيقة، لكى ينتزعوا لأنفسهم حقوقًا، ينزعونها من سواهم، بزعم «المُغالبة»، تلك التى أسقطناها فى يناير، ويحاولون ابتعاثها
هو يجلب الطعام وهي تدفع إيجار الغرفة والصالة . أرسلَ زوجها الأول أولاده لها لأن زوجته لا تقبلهم . ولديها اثنان من أزواج متعددين . قالت : جميع أولادي لا يذهبون إلى المدرسة . ليس عندي تكاليفها . أكبرهم فتاة في السابعة عشر من عمرها .
ليست هذه هي المرأة السورية الوحيدة التي تعاني من ذلك . بل كل واحدة تأتي إلى مكتبنا ترشد أخرى لتستشيرني ويقول لي جمعيهن : أعتبرك كأمي .ولا يحركنّ ساكناً حول قضاياهنّ
صباح الخير لصمتك وصخبك وضجيجيك، صباح الخير لطهر هوائك وتلوّثه، صباح الخير لازدحامك ولأحاديث السّائقين السّريعة، صباح الخير للشّباب في جامعاتك يحمونك بالحرف والصّورة، ويخبئون الإدراك المعتّق في غياهب الصمت حتى ينالوا زمناً يؤمنون به، لأنّ ثمّة الآن من يعتبر الوعي جريمة و خطيئة، صباح الخير لك و أنت تتّسعين أكثر بحلم في عيون شبابك وهم منفيّون قسراً في المهاجر .
صباح الخير يا شااااااااااااام
في وطني صار الناس ينامون على أصوات تهز بيوتهم وتجفل المدينة... بثيابهم كاملة و بكامل عدتهم للرحيل و كثير من الأطفال ينتعلون أحذيتهم في أسرتهم استعداداً للرحيل في حال سقوط القذائف و الرصاص على المنازل... و غالبية النسوة يغتسلن بثيابهن الداخلية خشية أن يمتن أو يغادرن البيوت و هن عراة ....
و خارج وطني بات العالم أكثر بلادة وبلا حس أو إنسانية
والقصة الثانية مفادها انه جرت العادة ان يبقى رجلا في القبيلة اذا خرج الرجال منها لطلب ماء او لبحث عن مرعى جديد. لم يكن هذا لخوف من غزو بل من المخابرات. كانوا يقومون بغزوات امنية يسمونها بالزيارة يحملون كتبا للبيع لأناس لا يقرؤون. كان حظي انني كنت رجل البيت في احدى الغزوات الامنية تلك. اتوا حاملين كتابا عن فكر القائد الفذ. حاولت ان لا ادفع ثمنه متحججا بأعذار غير مقنعة مفادها انه لا احد في القبيلة يعرف القراءة.
م تكن الأفكار يوماً.. سوى سيل جارف لكل الكلام الذي يجب أن يقال.. كحكايات الجدة لنا وقت ننام.. فرغم كل تلكؤها.. تصرّ على أن تقولها كاملة.. لتصل للمغزى.. حتى نفهمه.. وهي لا تدرك اننا كنا قد غفونا منذ البداية.. ورأينا المغزى في مناماتنا.. سيأخذنا هذا السيل.. حتى نهاية العالم.. ولن ينضب يوماً.. سنلم عناقيد الأحرف.. ونصنع منه طوق نجاتنا من تفاهة الحياة.. لكي نصعد.. لن نتردد يوماً بأن نبتسم لأنفسنا حين نجلس أمام الرب.. ليقول لنا.. الحكاية النهائية..
فالمثقف ليس نقدي فحسب، وإنما موجه، وقادر على الارتقاء بالخطاب السائد لمستوى مختلف انطلاقا من تحليل الحدث، وعدم التعامل معه كحدث منفصل ولحظي.
أثار هذا التساؤل، ما تم تداوله لوقت أكثر مما ينبغي لموضوع الوثيقة الخاصة بجد بشار الأسد التي وجهها للاحتلال الفرنسي بدعوى حماية العلويين، والمطالبة بدولة علوية.