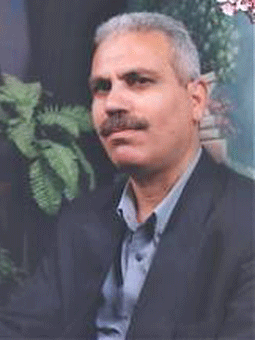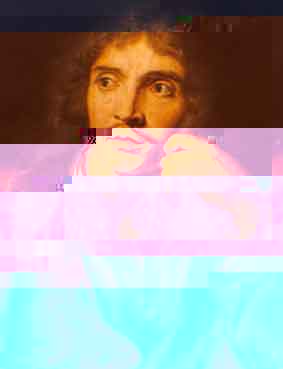ثمَّة أمكنةٌ ندخلها مرة، فينتابنا فيما بعد حنينٌ جارفٌ إليها، وكأننا ولدنا في تلك الأماكن!.. هكذا يمكنك أن تنتمي إلى مدن قد لا تعرف فيها إلا بضعة أزقَّة ونيِّف، وهكذا أيضاً قد تعشق بيوتاً بالكاد جلست في مضافاتها قليلاً من الوقت.. رفعت فيها أنخاب الحالمين إلى سماء عالية.. لا أحد يعرف بصحّة من تشرب اليوم وبصحّة من تشرب غداً، ولا أحد يعرف إلى أيِّ جهة تميل القلوب. لكنَّ قلباً يميلُ إلى جهة البحر أكثر قرباً من خيار البوصلة الصحيح. ولا يمكن أن ننسى قبل أيِّ استفاضة أنَّ «بوصلة لا تشير إلى القدس مشبوهة» كما يقول مظفر النواب.
ثمة من يقول إنَّ الأماكن هي سكانها. وعليه لن يكون الاهتداء إلى قلعة الشاعر حازم العظمة على طريق المطار إلا ضرباً من العبث؛ فالذهاب إلى هناك سيجعلك في اللحظة ذاتها في عرضة للشعر ووحوش البرية التي
الأمر لا يتعلق بزهرة عادية، ولا بمدينة عادية. فالزهرة ليست في حديقة وإنما تبعث بجذورها في تراب إنسان، والمدينة هي بقايا الإنسان نفسه. وبين زهرة محمود المسعدي ومدينة التركي ياشار كمال تكمن المأساة.الكاتب التونسي الراحل محمود المسعدي، قال على لسان بطل روايته الشهيرة "حدّث أبو هريرة قال": "لا يطربني شيء مثل الزهرة على القبر"، وقد يكمن السر في المفارقة التي يحملها المشهد، فعندما يتأمل الناس أسفل المشهد يبكون، ثم يتأملون أعلاه فينشرحون ويقبلون على الدنيا.لكن الذي ستأمل المشهد البانورامي يصاب بإحساس غريب، هو مزيج بين هذا وذاك. فلا يعرف الواحد حينها نفسه إلى أي قوم ينتمي، وربما تطور الإحساس عنده وعاش في غربته المتزايدة بين أهله ما تبقى في حياته من أيام.
(رأسمالي على النمل) لابد في أي جلسة لي أن أخذ دور المنظر ضد الرأسمالية والرأسماليين والبرجوازيين وكلام اليسار الذي يحمل عامه المائة والخمسين عملياً وآلاف السنين نظرياً وتطبيقياً فأنا لا أوفر فرصة لمهاجمة الليبرالية والعولمة وأخذ دور المخون الأكبر للناس عندما لا أحترم وجهات نظرهم أو أفكارهم ولسوء القدر كان لي درس مع الطبيعة وكان هذا الدرس درس خصوصي
سلام عليك أيها الأسمر... كيف أنت؟ أينما كنت أنت. بقيت تحلم بالطيران، و مقارعة النجوم، إلى أن أصبحت نجمة فعلاً..! اشتقت لك .. اشتقت لجلجامشك.. لطروادة التي كتبت عنها, و النيل الذي أخبرتني قصته و أهديتني مفتاحه .. اشتقت للبحر الذي أنجبك.. اشتقت لجنونك ..لشرودك .. لغموضك.. اشتقت لكل ما فيك.. اشتقت لصديقي الذي أتعبني..
العالم لم يتغير مذ تركته الفرق الوحيد أننا بتنا ( عايشين وحدنا بلاك) لازالت جراحنا مفتوحة ,كرامتنا مقهورة و دماؤنا مهدورة . ولازلنا عرباً لا نتقن سوى التغني بأمجاد ولت، و الضحك على لحى قصت ... الموت لازال في ضيافتنا فقد استطاب الكرم العربي. فتارة هو في ضيافة ضمائرنا، و تارة أخرى مشاعرنا .. تارة يستقبله أطفالنا و تارة شيوخنا و نساؤنا .. و هو أيضاً ضيف عزيز عند من اختاروه طريقاً للحياة ..!
أدركني وعيي لذاتي في وسط عمان البلد. كنت أبحث عن كتاب. كتاب يخرجني من حيرتي. فحيرتي طالت أكثر مما يجب. صارت وسيلة مفضلة لإضاعة الوقت في التنقل بين عدد من البدائل، ولكن دون أن يشكل أي منها محطة وقوف وانطلاق دائمة. فمثلا كتبت الفصل الأول لروايتين، وكتبت عشر قصص قصيرة تنتظر التنقيح. وترجمت عشر صفحات من كتاب عن الخرافات والسعود والنحوس ولم أعد لأي منها، وشاهدت فلما معادا أربع مرات على الفوكسموفي مع أنه فلم آكشن تافه "دفشوا" فيه اسم عربي وألصقوه بالارهاب، وذهبت إلى الطبيب حين أوشكت على الشفاء من سعال ديكي، وخجلت من إطلاع الطبيب على ألم البواسير الذي يجعلني أجلس بزاوية 45 درجة، واكتشف الطبيب بالصدفة أن ضغط دمي مرتفع، وطلب مني أن أقيسه كل ثلاثة أيام، ففرحت ونسيت الموضوع(هل أعاني من ميل الى تدمير الذات؟)، وكي أقنع ابني بأن يدرس لأن الامتحانات اقتربت، وعدته بدينارين كاملين(لمن يعتقدون أن الدينارين شيء لا يذكر فليعلموا أن مصروف ابني اليومي
هل من وجود للكاتب في غياب قارئ يقطع هذه الكتابة، بغض النظر عما إذا كان هذا القارئ عابرا أم متفحصا ذا بصيرة ثاقبة؟
في الحقيقة أجد لهذا السؤال أكثر من مسوِّغ يستدعي طرحه. على أن ما يدعوني إلى الكتابة أساسا في هذا الموضوع هو حجم التأفف الذي يبديه بعض الكتاب ملء الصمت وهم يُعْرِضون عن التواصل أو بالأحرى الرد على قارئ مفترض فيما يتعلق بهذه القضية أو تلك، دون أن يفطن هذا الكاتب أو ذاك إلى أن هذا القارئ هو بدوره كاتب، وربما كان شأنه مع الكتابة أعظم من شؤون آخرين – ومنهم الكاتب المتأفِّف ذاته -. وكل ما هنالك أن هذا القارئ (الكاتب) يغلِّف ذاته بثوب التواضع. ومؤكد أن التواضع ذاك هو ما يعطي لكتابته صيتا ولقراءته معنى ووزنا.
أما التأفف الوارد في صيغة صمت فهو يختزن رغبة جامحة في التجاهل – مهما عظم شأن القارئ
كنت أودُّ العُواء مثل أيّ ذئبٍ في هذا العالم، وكنت أريد لصورتي أن تحفر لها ظلاً في قوام القمر الباسق. أنا ماوكلي القادم من أدغال الرَّب، والذاهب إلى أدغال الرَّب. لست أجازف إلا بربع ما جازف به نبيّ بلا رسالة للخواء. أقسم إنِّي كنت أودُّ العواء وأن أطارد قطعاناً من حُمر الوحش وغزلان زرقاء تهبط من سماوات باسقة، غير أنه "ولمَّا اشتدَّ ساعدها رماني"..
أقسم إنه لديَّ من الحب- مثل آدم حاتم- ما يدمِّر ثلاثة أرباع وجه الله، وإنني أعزل أدخل مقصورة الملكة وليس فيَّ شهوة للطَّعن. بريئاً مثل الذئب من دم يوسف ويوسف لم يمت.. لم يمت البهيّ الشهيّ الرائع، ولم يمت آباؤنا الميتون ولا أخوتنا الميتون.. لم يمت أحد. والبحر يزحف خلفي ومازلت أركض ذبيحاً!! على كتف من أصعد لأرى البحر..
قبل شهور، في عزّ الشتاء، دخلتْ قِطةٌ رماديةٌ خِلسةً من البلكون، واستقرتْ في بيتي. اكتشفتُها في الصباح وقد اختارتْ أحدَ الأسِرَّة الشاغرة ونامتْ، بعدما دسّتْ رأسَها في وسائده طمعًا في بعض دفء من برد يناير القارس. فرِحتُ بها. وعلى مدار أيامٍ حاولتُ استمالتها دون جدوى. هي تحبُّ المُقام عندي، بدليل أنني تركتُ لها باب الشرفة مُشرعًا ورفضتِ الخروج. أضعُ لها اللبنَ في الصباح، وقطعةَ سمكٍ عند الظهر، و"أبَسْبِسُ" لها لكي تأتي، لكنها تنظرُ لي في ذُعر ولا تقربُ الطعامَ حتى أبتعد. وبعدما تطمئنُ أنني جلستُ إلى مكتبي، وانشغلتُ عنها، تَقْرَبُ الصحنَ، وتأكل. أرقُبُها بطرفٍ خفيّ فترتجفُ أذناها حين تلتقي عيوننا. تحدّقُ في عينيّ طويلاً بنظرة تقفُ بين التساؤل والحيرة والشكِّ، وقليل من الامتنان. لكنها أبدًا لا لكنها أبدًا لا تستجيبُ لمحاولاتي الاقترابَ منها لتدليلها والمسح على شعرها. أظنُّها تريدُ أن تحبني وتطمئن لي، لكنَّ عهدًا طويلاً لها في الشوارع بين مطاردات المارّة وسخافاتهم وزجْرهم لابد أورثَها انعدامَ ثقةٍ في بني البشر بمجملهم.
يبدو لي أن لغتنا العربية قد ضاقت ببعضنا –على رحابة صدرها- حتى صرنا مضطرين إلى استعارة المصطلحات الهامة من اللغات الاخرى لنعبرعما يجول في خواطرنا، ولو أن أبو الأسود الدؤلي خرج من قبره في هذا الزمان، واستمع إلى بعض أحاديثنا دون ذكرالأخبار ومصائبها، لطفق جارياً إلى قبره وهو يحمد الله على العافية والموت.وها هي صديقة لي أعرفها منذ زمن بعيد تصاب بعدوى العولمة اللفظية، فتصبح الثقافة في نظرها (لا تقل لي كم كتابا قرأت بل قل لي كم مصطلحاً حفظت)، فإذا بدماغي وهي تتحدث إلي - باستخدام مصطلحاتها المعقدة التي لا ناقة لي فيها ولا جمل- يحتاج إلى دعم لوجستي شديد اللهجة، وهي تحكي لي عن (بيوغرافيا والدها، او سيكولوجية والدتها، وطبوغرافية غرفتها، وإيديولوجيتها الخاصة في الحياة العامة، وحاجتها إلى معارضة الأحكام التعسفية الجائرة التي يحكمها بها أخوها، وبيروقراطية الحياة،) متطرقة إلى أدق التفاصيل
في حوار مع الكاتب والصحفي أحمد منصور، ضمن برنامج "علمتني الحياة" الذي بثته قناة المحور الفضائية منذ أشهر، ذكر الكاتب والصحفي المتميز أن الكتابة تستغرق منه وقتا طويلا. والشيء نفسه يقال عن القراءة. وذكر أيضا أن الكتابة تجبره على الانعزال عن الآخرين - في مكتبه -، سواء أكان بعيدا عن أسرته خارج الوطن الأم، أم كان يقاسمها البيت نفسه، مما جعله يعترف بنبرة - لا تخلو من ألم – بأن الكتابة كثيرا ما تأخذه عن بيته وأبنائه.
حين نسمع مثل هذا الكلام تبدو لنا المسألة عادية وطبيعية، ونتفهم طبيعة عمل هذا الصحفي المتألق بوصفه منتجا للأفكار، خصوصا وأن نجاح كتاباته وأسلوب حواراته وتغطياته – كما هو الشأن في تغطيته لحرب العراق – يبرر أي تقصير في حق أسرته، ويُتَوُِّجه بتقدير جماهيري قَلَّ نظيره. وفي تتويجه تتويج للكلمة الصادقة والهادفة.