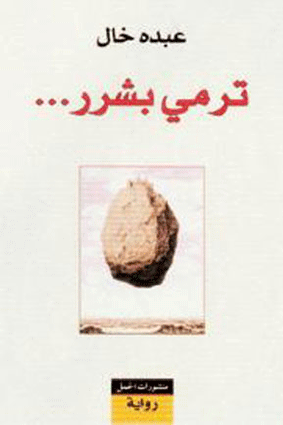صدور مجلة ثقافية في فلسطين خبر مفرح بالضرورة.
ذلك ما أحسست به عند قراءتي خبر صدور العدد صفر من مجلّة "أوراق" الثقافية الفصليّة عن "دائرة الثقافة والإعلام" في منظمة التحرير الفلسطينية ووزارة الثقافة في السلطة الفلسطينية ، لما يحمل الخبر من مساحة تفاعل جديدة للمبدعين الفلسطينيين وهم يواجهون أشكالا مختلفة من التضييق والحصار.
مع ذلك توقفت طويلا أمام "هيئة التحرير" التي أنيطت بأفرادها مسئولية الإشراف على المجلّة لسبب بسيط لا يتعلّق بنيّة رفض هذا الاسم أو ذاك ، ولكن ببساطة بسبب ما يكرّسه اختيار البعض من "تقاليد" ثقافية ووظيفية تجعل الحياة الثقافية الفلسطينية في شقّها الرّسمي
أصيغ عنوان هذا المقال على هيئة سؤال:
هل الصراع الفلسطينى ــ الإسرائيلى قابل للحل العلمانى؟
أجيب بسرد قصة لها دلالة فلسفية!
فى ديسمبر ١٩٧٥ أسهمتُ فى تأسيس «المجموعة الأوروبية العربية للبحوث الاجتماعية» تحت رعاية مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، وإثر تأسيسها اجتمعت اللجنة التنفيذية لتحديد قضية يمكن أن تكون موضوعاً للمؤتمر القادم، وكان رأى ممثل المؤسسة أن تكون القضية المثارة من القضايا التى لن يكون لها حل إلا فى القرن الحادى
يثير المفكر الكبير صادق جلال العظم في كتاباته وحواراته وأحاديثه أكثر القضايا إلحاحاً وأهمية، ويطرح ما هو مثير وإشكالي بجرأة وصراحة. ويتطرق هذا الحوار لمشكلة العلمانية والدين والحركات الدينية، ويتوقف عند التجربة التركية التي قد تكون دراستها مفيدة لنا نحن العرب في هذه الظروف.
* هناك الكثير من الإشكالية والتشابك تسود المناقشات في مجتمعاتنا العربية، ومنها سورية، حول العلاقة بين الدين والعلمانية والليبرالية والديموقراطية والمجتمع المدني، ما رأيكم بذلك؟.
** ما يجري حالياً من مناقشات وممارسات عربية، وبخاصة في بلدنا العزيز سورية، بين الدين والعلمانية.. إلخ، دون الدخول في الشربكة
عليّ أن أشكر جائزة بوكر للرواية العربية، على كلّ هذه الحركة التي صنعتها في بركة حياتنا الثقافية الرّاكدة. وعليّ أن أشير بداية أنه حراك ما كان ليحدث بهذا الزّخم لو لم تكن البوكر كجائزة قد نهضت على مراحل ثلاث، القائمة الطويلة، ثم القصيرة، ثم اختيار الرّواية الفائزة، بل إنني سأسارع لأزيد أن تلك المراحل قد وجدت قدرتها على تحريك الرّاكد من خلال إعلانها على القرّاء، ومعها إعلان أسماء أعضاء لجنة التحكيم.
هكذا دخلنا ككتاب ومثقفين وقرّاء اللّعبة، وانتقلنا مع كلّ قائمة إلى مساحة الجدل والرّهانات، أي المشاركة في محاولة معرفة النتائج. لا يعني هذا أن النتائج كانت تتطابق بالضرورة مع تلك التي حدّدناها في خياراتنا، فقد كنت مثلاً أنتظر وصول
من أنت ؟؟
وهل حقاً أنت موجود؟؟
وما دورك في هذه الحياة؟؟
أم أن الحقيقة هي أن الذين سبقونا كذبوا علينا فاتبعناهم بغير هدىً وقلدناهم بغير بصيرة.
هل أنت حقاً من طلب منا إعمال العقل .. ونبذ الإتباع والتقليد .. فأمرت عبادك بالتفكر والتدبر والتعقل والنظر .. وعبت عليهم إتباع آبائهم والسير على نهجهم بغير علم.؟؟
فيما مكثنا نتفرج على العصر، قفز الشاعر محمد ديبو اليه محرزا كأسه الذهبي.. ومانعنيه بالعصر هنا، هو العصر الافتراضي.. العصر وقد بات يشن حروبه الالكترونية، ويصادق بأدواته الالكترونية، وينقل ماله بالادوات الالكترونية.
ديبو، الأكثر خبرة بالتشات والتشاتيون، تنقل عبر الانترنيت فوقع.. وقع بنوبة قلب، ودقة قلب، ومطالبات قلب واستحقاقات قلب، فبات :-من أهل الغرام.
هو كذلك، وعلى الطرف الآخر، انضمت الينا (رشا)، الوجه الرقيق الحالم، الزنبقة التي يمكن كسرها ان لم تنطلق كما القصيدة في فضاءاتنا، وتنتقل هكذا عبر يوميات محمد ديبو، وقد بات بقامته المختزلة، راقص تضيق الارض به، فيأخذ فضاءاته من الجهات
/تعقيب على سحبان السواح حول أفكاره عن المرأة والحجاب والشبق الجنسيبعد قراءتي للافتتاحية المثيرة،ليس فقط للجدل، وإنما من نواح عدة. عدت بذاكرتي إلى أيام الجامعة، أي منذ ما يقارب العشر سنوات. حينها كنت على أبواب التخرّج. وفي تلك الفترة كانت تلازمني إحدى الفتيات المحجبات كصديقة مقربة لي (حبيبة). وكان كل من حولي يتعجب لمصاحبتي لها منذ السنة الثانية من دراستي بمن فيهم زميلاتي السافرات –الغير محجبات- لعلمهم بطبيعة أفكاري الدينية المتحررة إن صح التعبير ولكثرة توفر الطالبات الغير محجبات في كلية الآداب في ذلك الوقت لدرجة أن واحدة من تلك الزميلات جهرت برأيها
لا يمكن إخراج فيلم مثل «واحد - صفر» عن السياق السياسي والاجتماعي الذي يمرّ به المجتمع المصري عموماً، فمع شعور المواطن بالعجز عن تحقيق طموحاته ومواكبة ضغوط الحياة ومتطلباتها، وفي ظل انعدام حرية التعبير وعدم القدرة على ممارسة أي فعل تغييري على أرض الواقع، يتم اللجوء إلى وسائل «نظرية» بديلة تنحصر فاعليتها في الأثر التطهيري الشعبي، وليس أكثر من ذلك. فبإمكان حركة 6 أبريل أن تصنع ما تشاء على موقع الفايس بوك، ولكن الاحتجاج العملي في الشوارع أمر آخر. لا مانع من انتقاد الوضع العام وتردي القيم. بل السب والشتم إذا اقتضى الأمر، طالما أن كل شيء مضبوط ومحصور في إطار «الكلام» لا أكثر.هذا النوع من الإستراتيجية «التنفيسية» ينتقل إلى السينما كأحد الأسلحة التعبيرية المعتبرة، فيتم تمرير بعض الأفلام بين فترة وأخرى، لعرض مَشاهِد يمكن أن تروّح
قبل سنوات، حينما كنتُ طالباً في كليّة الاقتصاد بجامعة دمشق، إحدى الجامعات الحكوميّة الأربع، لم أكترث لحضور المحاضرات، بسبب كثافة الطلاب وعدم قدرة قاعات الكليّة القليلة على استيعاب العدد الكبير من الطلاب. فكان يصدف أن أدرس أحياناً على سطح منزلنا المُشرف من جبل قاسيون على مدينة دمشق، وأذهلني حينها عدد المآذن الخضر التي تعلو في سماء المدينة. وقتئذ لم أفكّر إلا في المنظر الجميل الذي تضيفه هذه الألوان على المدينة الشاحبة.
منذ أسابيع مضت، شرعت بالبحث والتقصّي عن معلوماتٍ قد تفيدني في كتابة مقالي هذا، واجتاحتني رغبة في كتابة بحث عن بناء الجوامع
تأنيث الشتيمة
لماذا كلما أراد رجل شتم آخر استعار أمّه أو أخته أو واحدة أخرى من "نسائه"؟ الجواب واضح طبعاً: حتى تكون الشتيمة شتيمة، يجب أن تطعن الرجل في أعزّ ما "يملك"، وهو ما يسمى في مجتمعاتنا الذكورية بالعِرض أو الشرف.
القضية، إذن، أكبر من مجرد طرق التعبير عن الإهانة. إنها قصة ثقافة تعتبر المرأة ملكاً من ممتلكات الرجل يتوجب عليه صونه والدفاع عنه؛ قصة لغة تعتبر المرأة طارئاً أو حالة خاصة، كما تدل على ذلك "تاء التأنيث" و"نون النسوة" وغيرها. لكن في الوقت الذي تمتلئ فيه مكتبات اللغات الأخرى بأطنان من الدراسات عن هذه الأمور، تكاد لغتنا العربية -وأجرؤ على القول إنها من أكثر اللغات تمييزاً ضد المرأة-