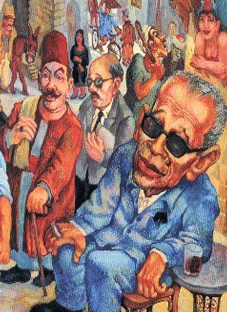عندما قام مارسيل دوتشامب بتقديم المبولة الحديثة التي أطلق عليها اسم "النافورة" في العام 1917م كقطعة فنية موقّعة, كان فعله هذا بمثابة ردة فعل على رعب الحرب العالمية الأولى, وعلى الإنهيار الكلي للأمم المترقية, وعلى انهيار القيم الجمالية التي ترافقت مع إبادة جيله أنذاك.
لكن السمعة السيئة ما لبثت أن لحقت بنافورته, ذلك أن عالم الفن وقتها كان في أبهت حالاته, فبدأت التأويلات الساخرة تتدفق, كماء المرحاض الفائض, على عمل دوتشامب وعلى المبدأ الفني لابتكاره بالكامل: "ثم متى لم تكن المبولة مبولة؟ وإذا لم تكن مبولة فماذا ستكون بحق الجحيم؟!" ..لقد مثلت النافورة رمزا للالتباس في أوقات شديدة الالتباس, أو على الأقل هكذا جعل منها الناس بردود أفعالهم.
بعد أربع وثمانين سنة, هاجم الإرهابيون مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاغون
إنني أقول :
إن الإله ضلال , و أنا لم أعد أؤمن به بعد اليوم , إن الإله كذبة و نفاق , و أنا أحاربه , الإله هو الدين , و هذا لا يعزيني ( يقدم لي التعزية ) فقط , لكنه أيضا محنة أو ابتلاء , و هذا لا يمنح البشرية فقط السكينة و السرور , بل إنه قد كتب أكثر صفحات التاريخ ألما و دموية , و لهذا فإنني أحارب الدين .
إنني أقول :
الوطنية هي دوغما ( عقيدة جامدة ) جديدة . تظهر على أنقاض العقائد القديمة التي تنهار , إنها الإيمان الجديد , الضروري للسادة بحيث يمكنهم أن يحتفظوا بالسلاسل التي أعدوها للعبيد .
"القرآن كتاب لا يعترف بوجود المرأة ككائن مستقل".. "و يعتبرها أداة لإشباع غريزة الرجل"،
"العودة إلى الإسلام تعني انقراضنا الحضاري"..
ّالدين يُدنّس المرأة رغم أنها تنجب الأنبياء"..
هي بعض الآراء الصادمة التي دأب الشاعر السوري المقيم بباريس على عرضها أمام الرأي العام، في كتبه ودراساته،
وانتقد الشاعر المرشح مرات لجائزة نوبل العالمَ الإسلامي ومنظومته الفكرية التي اعتبرها "منغلقة" و"رجعية" و"متخلفة" لا يمكن دفعها للأمام إلا إذا تخلت عن إدراج الدين في مختلف مناحي الحياة، واقتدت بالمنظومة الفكرية الغربية.
«ليس لحرية التعبير قيمة إذا لم يستمع أحد لما يقال، يجب أن تكون هناك حرية استماع كذلك». سمعت هذه الجملة في برنامج جوائز الإيمي الأميركية على لسان أحد الفائزين، فكان أن أخذتني الجملة لواقعنا الحالي، فنحن، وصولاً الى مرحلة فكرية خطيرة، نفتقر إلى الإثنين. بصراحة ومباشرة، لقد سيطر التيار الديني الإسلامي على العقل العربي المسلم اليوم، فوضع أمامه مئات المحرمات التعبيرية، ثم آلافاً غيرها استماعية.
أؤكد هنا أن الخطاب المسيحي الديني ليس بريئاً من المنحى عينه، الفرق، أن المسيحية اليوم مقننة علمانياً، فقوانين البلدان الغربية الحاضنة للمسيحية تحمي حقوق أفرادها في حرية التعبير والقراءة والاستماع، وتضع قيوداً مدنية وإنسانية على أي خطاب ديني متشدد، حامية من خلالها حقوق الأفراد في اعتناق، أو ترك هذه الديانات، من دون أن يشكل ذلك خطرا على حرياتهم أو حقوقهم الإنسانية والمعيشية.
كان اليوم الجمعة 14 تشرين الأول (أكتوبر) عام 1988، المكان ميدان طلعت حرب في مدينة القاهرة، الوقت التاسعة صباحاً، أهمية المكان، أن الحاج محمد مدبولي صاحب أكبر مكتبة في المنطقة، كان في تلك الفترة يبيع الصحف والمجلات ويضعها على الرصيف في شكل ملحوظ أمام مكتبته، الجرائد كثيرة، وهذه المرة كانت الكميات المطبوعة أكثر من المألوف، اشترى رجل يبدو ذا مكانة مرموقة أغلب هذه الصحف، ومعه ابنته الشابة التي لا تقل عنه مكانة، بكل براءة، قالت: أنا شفت له فيلم «بين القصرين»، و«اللص والكلاب».
كان الخبر الرئيس في كل هذه الصحف هو «فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل في الأدب»، الخبر عرفه المصريون والعرب طوال نصف نهار الأمس، وتحولت وتحولت البيوت إلى فرحة غامرة، قبل هذا الحدث السعيد بفترة،
ألف .. وكالات .. صحافة عربية
حقيبةنوبل للآداب حصدها غوستاف لوكليزيو .
وزعت أخيرا في الأول من أمس حقائب جائزة نوبل. في ما يخص الآداب والتي تهمنا كموقع ثقافي أعطيت الحقيبة المليئة بالدولارات التي ضاعت قيمتها في البورصة، بورصة الأوراق المالية ضمن التدهور المالي والاقتصادي الذي يعصف في العالم وفي أمريكا، موجهة سياسة العالم.
يعرف المعنيون جميعاً أن فكرة «الديوان الغربي – الشرقي» ولدت في السنة 1998 بمبادرة من شخصين كبيرين: المفكّر عازف البيانو إدوارد سعيد، والمايسترو عازف البيانو دانيال بارونبوئيم. وقد أرادا من هذه الفكرة أن يُوجدا مكاناً – مَشْغلاً أو محترفاً، يلتقي فيه شبان موسيقيون فلسطينيون وعربٌ ويهودٌ للدراسة معاً، والتعارف القريب الوثيق في ما بينهم. وقد تحققت هذه الفكرة، عملياً، بإنشاء «أوركسترا الديوان الغربي – الشرقي» في السنة 1999،
كتبت »كرسي« على انها قصة قصيرة وهي الآن لم تتأكد من انها رواية
بعد »تفاصيل«، كتابها الأول (وهو مجموعة قصصية) صدر للكاتبة السورية ديمة ونوس رواية (عن »دار الآداب«) جديدة بعنوان »كرسي« وتروي فيها »سيرة« شخص يدعى درغام، تجعله مثالا عن موظفي الدوائر الرسمية في العالم العربي، أي تحاول الدخول إلى رسم صورة عن آليات تفكير أي شخص وصولي لا يتورع حتى عن الوشاية بأصدقائه وكتابة التقارير ضدهم من اجل الوصول إلى مبتغاه.
رواية، تدخل عميقا في الراهن السياسي ـ إذا جاز القول ـ لترسم لوحة عن أشخاص ومجتمع. لوحة لا بد أنها تشكل رسما عن حياة نغرق فيها.
حول كتابها الجديد، كان هذا اللقاء:
برزت ظاهرة في الحياة الأدبية المصرية خلال السنوات الأخيرة أُطلق عليها اسم «الكتابة الجديدة». هذه الظاهرة أصابت عدداً من كتاب الرواية المعروفين، بحسب قولهم، بالقلق على مستقبل الرواية في مصر. ربما رأوا فيها شبحاً يزحف على مصادر الصدارة التي استقروا فيها نتيجة أعمالهم الإبداعية، ولكن أيضاً بسبب القوى الاجتماعية التي ساندتهم، وشبكة العلاقات التي نشأت بينهم وبين أصحاب النفوذ في الإعلام، والثقافة والنشر، وأحياناً في الأوساط السياسية المهمة. ففي كل البلاد، وفي كل العصور يُوجد للقوى الاجتماعية السائدة دور في إبراز كتابة روائية معينة، والترويج لها، وبالتالي دور في إضفاء الشهرة، والمكانة على كتّاب روائيين مُعينين، وفي تشكيل الذوق العام للذين يستهلكون أعمالهم.أُطلق على هذه الظاهرة اسم «الكتابة الجديدة» لأنها تتناول مجالات في المجتمع والحياة، ومواضيع، وقطاعات من الناس تجاهلها معظم كتّاب الرواية، لكنها فرضت نفسها على
عندما لا يحتمل العاشق "الآله" رؤية المعشوق وقد انبعث نوره، يستفحل أمر العشق-الأله، فتصيبه غشية هي ما يسمّيه القرآن، وتسمّيه نصوص العشق "صعقا". (...) يحيل الصّعْق إلى "الغشية" والموت، كما يحيل إلى العامل الذي يسبّبهما، وهو إمّا أن يكون "الصّاعقة"، وهي إحراق البرق الإنسان أو "نار تسقط من السّماء في رعد شديد"، وإمّا أن يكون الصّوت يسمعه الإنسان "كالهدّة الشّديدة". ولعلّه من الضّروريّ أن نميّز بين مفهوم الصّرْع والغشية المرتبطة به ومفهوم الصّعق.