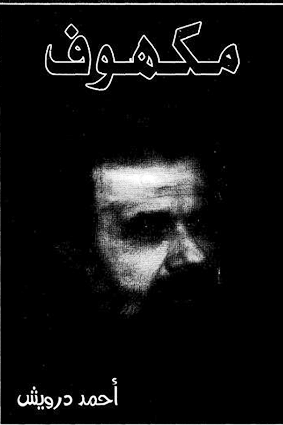ترى ما الذي يمنحُ مثل هذه الكلمة توهّجاً كما وهجُ "المشاهدة"؟ أتراها الدّهشة؟ ربّما الدّهشة...فكلّ عشقٍ لا يُحاكُ بالدّهشةِ المستمرّة في النبضِ لا يملكُ جدارةَ العشقِ، وربّما لهذا كانت تردّد نبيّةُ العشقِ لنبيّها باستمرارٍ: حين ترحلُ الدّهشةُ عنّي تجاهكَ، سأترككَ.
ولأنّ الدّهشةَ تعتمرُ كيانَ نبيّ العشقِ روحاً وجسداً، كلاًّ وبعضاً، سيكرّر القول لها: كلّكِ بي مذ أمطرتكِ سماء الله بقلبي ندى، أراكِ في ملامح الجميع ولكن لا أحد يشبهكِ.
حريّ بالعشقِ أن ينزعَ كلّ ضيقٍ من صدورِ أنبيائه، فقد كانت نبيّةُ العشقِ تفرحُ لوجودِ نبيّها كلّما اعتراها الحزنُ : ..
من ينكر أن الأجانب توغلوا بمهارة في علومـ ( نا ) حتى صاروا أعرف منا في شؤون دينـ ( نا وتفاصيل تاريخنا بل في مجمل ثقافتنا، وعلى خلافنا فإن نزعتهم العدائية دفعتهم إلى التنقيب عن مرجعيات أفكارنا ومذاهب فقهـ ( نا ) وأصول معتقداتـ ( نا ) التي جعلت الفاتحين قبلنا أقوياء واستطاعوا بإقدامهم أن يفتحوا معظم العالم، وأن يشملوا بعلومهم شتى نواحي المعمورة من سوء التقدير أن نضع شخصية بمثل البروفيسور محمد أركون في خانة العداء، ونصب عليها وابل بغضائنا وكراهيتنا، ونصورها في أذهان الطلبة أنها ذلك الذئب المحتال المختبئ، وبذلك نكبح ،.
إذا كان الله جباراً وعالماً بكل شيء، وإذا كان الله خيراً، فكيف يسمح بوجود الشرّ والألم؟ إن العلماء يعرفون جواب هذا السؤال والذي يتلخص في كلمة " Theodicy" أي الدفاع عن كون الله خيراً مطلقاً بالرغم من وجود الشر. العبرانيون القدماء، أولئك الذين كتبوا التوراة وأولئك الذين كتبوا الإنجيل كان بإمكانهم أن يدركوا جيّداً أنّه مهما كانت غايات الله فإنّها لا تتضمّن التأكيد على تطبيق العدالة في حياتنا هذه لكثير منا يفكرون ويقولون لأنفسهم إن وجود العذاب والشرّ – اللذيْن لا معنى لهما – يُبين أن الصفات المفترضة ل.
هذه الطبيعة المغلقة للأديان الشمولية هي التي قادت إلى حروب دينية لا نهاية لها، سواء بين طوائف الدين الواحد أم بين الأديان المتخالفة. ولقد درستُ تاريخ الإنسان السياسي والحضاري منذ العصر الحجري القديم إلى أواخر الألف الأول قبل الميلاد، ولم أعثر على خبر واحد عن حرب قامت لأسباب دينية، وغالباً ما كان القائد الغازي يقدم فروض الولاء لآلهة المدينة التي تفتح له أبوابها دون قتال، أما إذا أقام الغازي في الأراضي المفتوحة فإنّه سرعان ما ينسى آلهته ويتحول إلى عبادة الآلهة المحلية.
إنّ الهدف الأسمى هو "حماية الرجل" من فتنة المرأة، حمايته من غواية النظر إليها. لا أحد يتحدّث عن حماية المرأة من فتنة الرجل ويطالب الرجال بستر فتنتهم. تبدو غواية الرجل للمرأة – في الوعي العام – أمر مقبولا، إنّه الطبيعي. فتنة المرأة هي غواية الشيطان. هكذا يعود الوعي العامّ إلى أسطورة الخلق التوراتية، حيث أغوت حوّاء أدم؛ فارتكب معصية الأكل من الشجرة المحرّمة، فطُرِد وهي من الجنّة. القصة التوراتية تقول:
السماء. والرمالُ الحارةُ لا تفي بالغرضِ المطلوبِ من سادةِ الجنِّ المنتظرين هفواتِ آبائِهم. خَاْطِبْهُم أولاً واطلبْ ودَّهم، فأنتَ مجبرٌ على طاعةِ ما لا تراهُ وما لا تدركه الحواسُ المستسلمةُ لمربّعِ المادة. قد سِيقَ من قَبْلِك كلُّ الخليقةِ فأبدتْ امتناناً منقطعَ النظير. ما عليكَ إلاِّ أنْ تجثو وتقدم القرابينَ المختلفةَ الألوانِ والأطوالِ..
قيلَ لي: الأزرقُ لونه المفضل!. وما شأنكَ أنتَ في اختياره؟ ربَّ قائلٍ لا جدالَ في الأذواقِ فكيف بالأقدارِ؟
من هم «جنود الله»، كما جاء في رواية حداد الصادرة حديثاً عن دار رياض الريس؟ إنهم هؤلاء الذين يحتكرون حقيقة مقدسة، تسمح لهم أن يفصلوا بين الحق والصواب فصلاً باتراً، وأن يقايضوا «حياتهم المؤمنة»، وهم «يستشهدون»، بموت غيرالمؤمنين. فلا وجود لـ «جنود الله» إلا بوجود «جنود الشيطان»، السائرين بخط مستقيم إلى جهنم. وإذا كائن الروائي، وهو يرثي الثقافة، انطلق من معيش عربي، واتخذّ له المكان الذي يشاء، فقد آثر في «جنود الله» أن يذهب إلى بغداد، حيث بارود «الإيمان المتعصّب» يرمّد الأشجار والعيون والكتب. وسع الروائي، برهافة عالية، حيّز تأمله، ذلك أن «جنود الله» يتوزعون على «مسلمين» وعلى بعض جنود الاحتلال الأميركي، الذين لهم «رسالة خاصة»، توحد بين نصرة الحق وحرق البشر وتساوي بين «الإرهابيين» والأبرياء.
ناشد نجلا السيدة الإيرانية التي حُكمت بالرجم حتى الموت لاتهامها بالزنا سكينة اشتياني العالم بالتدخل لمساعدة والدتهما. وهما قالا بلغة حزينة ومؤثرة إنهما يشعران بالوحدة وأن "الجميع قد تخلى عنا في إيران، عدا محامي والدتنا الشجاع جافيد هوتان كيان." وأضافا أن مسؤولين في طهران قالوا لهما إن "الرأي العام العالمي مهتم بحياة والدتنا الآن، لكن حالما سيقلّ الاهتمام بقضيتها، حينئذ سيعودون لتدمير حياتنا
من جديدٍ تُقَدِمُ سلمية قرباناً جديداً على مذبحِ الشعرِ، هذه المرة الشاعر "أحمد درويش" وبعد حياةٍ قصيرةٍ ( 46) عاماً (1964- 2010) غادرَ الشاعرُ الذي أحبَّ الحياةَ وحاولَ التصالحَ معها ، لكنها خذلته ، فكان الموتُ على موعدٍ معهُ في بدايةِ أيلول بعد أن طرقَ بابَهُ فرحَّبَ به أحمدُ قائلا ً له : "البيتُ بيتُك "
عاشَ الشاعرُ في سنواتهِ الأخيرةِ أزماتٍ عدَّةْ منها النفسية ومنها الوجودية ومنها الاجتماعية ، وأصبحتْ علاقةُ الشاعرِ بنفسهِ وبالآخرين شديدةَ الارتباكِ ، مما ألجأه إلى العزلةِ و( الانكهاف ) الذي أودى به بطريقةٍ تراجيديةٍ موحشةْ.
كيتُ إثرَ مخاضِ ميلادٍ - وفاة - عظيمٍ على رفوفِ مكتبتي المتواضعةِ لأن الكتابَ لا يموت والكتبُ لا تبكي، بكيتُ على وقعِ أحاديث أُصرّ على أنها ليست حزينةً لأنها تشبهُ تلك التباشيرَ التي يتناقلها الناسُ عند بوادرِ بعثِ الأنبياءِ، لا أحسبُ نفسي من المبتدعين إذا قلتُ أن محمد أركون تنبأَ في وقتٍ مبكرٍ لواقعِ ما يحدثُ الآن على صعيدِ العلاقاتِ الدوليةِ والعلاقاتِ العربيةِ على وجهٍ أخص، ذلك ما كنتُ ألتمسهُ في نقاشاتهِ المستمرةِ بخصوصِ بناءِ الإنسانِ على ضوءِ فلسفةِ الفكرِ الإسلامي ومقارنتها بالفلسفاتِ الصديقةِ والمعاديةِ، ومبادرته في طرحِ منهجيةٍ لائقةٍ لمزواجةِ الدينِ بالحداثةِ حتى لا يموت التاريخُ أو يتحنط في نقطةٍ ما، فهو يصرُ على طرحِ المكنوناتِ العقليةِ العربيةِ والبحثِ فيها، وفي سبلِ وصْلها بالآخرِ كضرورةٍ تقتضيها الحضارةُ وفقَ عُسر مخاضِ التجديدِ الذي عطّلتهُ تهمةُ قصورِ اللغةِ العربيةِ والدينِ الإسلامي، هذه التهمةُ التي أشْهَرَهَا وروجَ لها الغربُ الذي احتكرَ النظرياتِ واحتكرَ مبادرةَ الإبداعِ والاختراعِ.