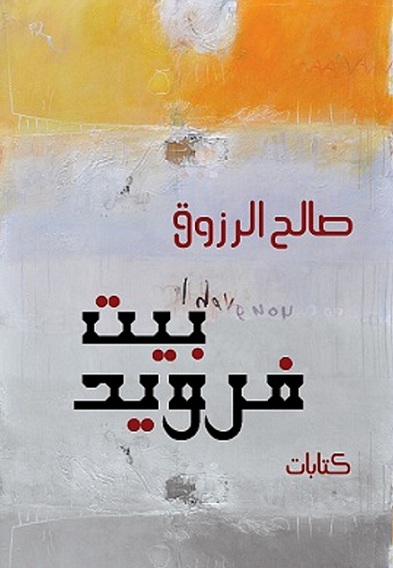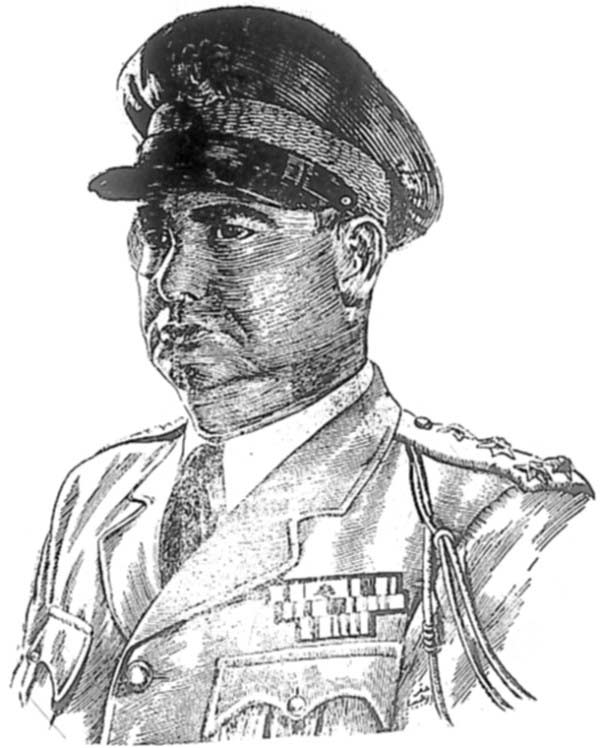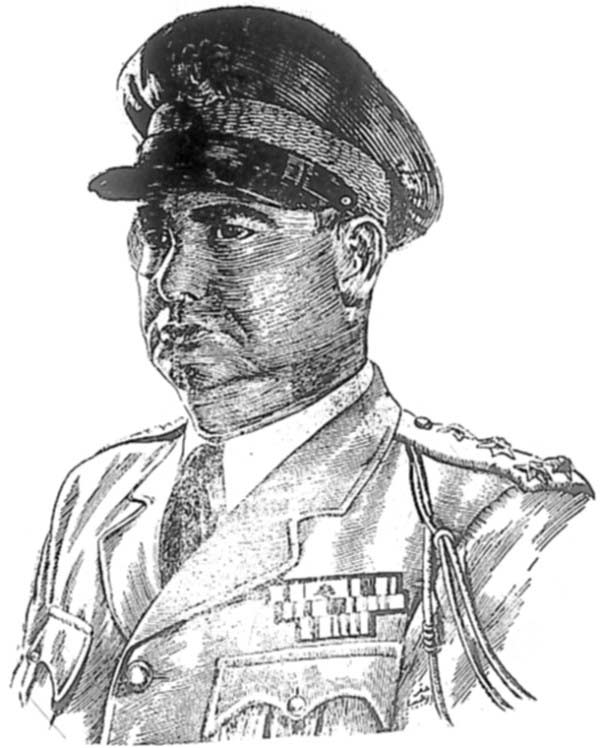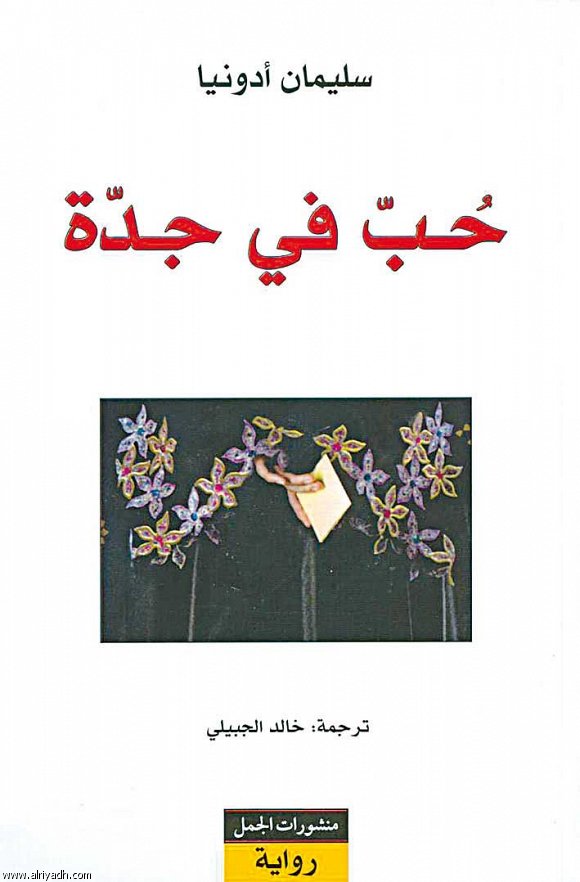ويرى ياسر أنور أن سبب الأزمة الراهنة ليست في العلمانية ولا في الإسلام، ولكن في التشوه المعرفي والمنهجي لدى العقل العربي الذي عجز عن ممارسة دوره الإبداعي، فلجأ إلى استعارة القوالب الجاهزة.
ويتوقع المؤلف حدوث اشتباكات أكثر حدة بين العلمانيين والإسلاميين في المرحلة القادمة، وهو ما دفعه إلى تقديم بعض الحلول التي يلخصها في الداروينية الاجتماعية إتاحة الفرصة للجميع دون ممارسة دور الوصايا من كلا الفريقين على خيار الأمة
عن دار مجلة ألف لحرية لحرية الكشف في الإنسان والكتابة صدر كتاب ( بيت فرويد ). لم يرغب المؤلف بتسميته قصصا، بل أطلق عليه اسم كتابات، ورغم أن تلك الكتابات أقرب إلى القصص ولكنها أيضا تحتمل أن تكون كتابات خارجة من عباءة القصة، خصوصا أنها جاءت تحت عنوانين رئيسيين رؤيا ـ خيال.
تمتزج الرؤيا بالخيال، وتلعب الحالة النفسية للكاتب، البطل دورا بارزا في تلك الكتابات، وهي لا تنتمي إلى فترة زمنية واحدة،
بصدور رواية ( بنات طهران ) لناهيد رشلان تضاف إلى رصيد الرواية النسائية ورقة جديدة.
فهي تأتي بعد ( بنات الرياض ) لرجاء الصانع التي حاولت أن تعمم المفهوم القومي و الوجودي على سواكن نسائية في مجتمع السعودية المحافظ ، و بعد ( قراءة لوليتا في طهران ) لأذر نفيسي و التي كانت هي الخيط الرفيع الذي ربط مشكلة بصدور رواية ( بنات طهران ) لناهيد رشلان تضاف إلى رصيد الرواية النسائية ورقة جديدة.
فهي تأتي بعد ( بنات الرياض ) لرجاء الصانع التي حاولت أن تعمم المفهوم القومي و الوجودي على سواكن نسائية في مجتمع السعودية المحافظ ، و بعد ( قراءة لوليتا في طهران ) لأذر نفيسي و التي كانت هي الخيط الرفيع ،
.
ولد أنطون تشيخوف في عائلة تاجر متوسط الحال من مدينة تاغانروغ الروسية الجنوبية وله ستة إخوة. وقد ورث من هذه الأسرة حب الحياة والموهبة الساطعة إلا أنه لم يرث فلساً واحداً من النقود. وأصبح بسرعة خيالية، إنساناً بحرف كبير بفضل دأبه الذاتي إضافة إلى موهبته الفطرية الأخاذة .
وما أن استقر به المقام في موسكو حتى أخذ ينشر المقالات والزوايا الصغيرة والفكاهية ثم انتسب إلى كلية الطب دون الانفصال عن عالم الأدب وصار الطبيب الشاب يعالج المرضى ويبدع قصصاً قصيرة
ان الزعيم ، هذا الرجل ذو الهالة الكبرى في سورية ، يأتي إلى منزلي و يبكي شاكيا من ظلم الحملة عليه ، حتى أنه اقترح مرة على شكري القوتلي أن يقيله من منصبه حفاظا على كرامته ، و أن يعينه محافظا في حلب ، كان الزعيم ، عندما يذهب إلى مكتب رئيسه المباشر وزير الدفاع خالد العظم ، يلاقي تجاهلا بل و تحقيرا حين ينتظر ساعات بعد الموعد المعين حتى يفتح له مكتب العظم ، و أحيانا لم يكن هذا المكتب ليفتح فيعود الزعيم من حيث جاء.
كان مدير المشتريات في الجيش العقيد أنطون بستاني ،
ن خلال جلساتي المسائية معه في مكتبي تعرفت أكثر على حسني الزعيم و ماضيه. فهو من مواليد حلب عام 1889 . و والده كان رجل دين و كان مفتي الجيش العثماني ، و له شقيق هو رجل دين توفي قبل أعوام قليلة و اسمه الشيخ صلاح الدين الزعيم ، و شقيق آخر هو بشير الزعيم. و كان حسني يردد دائما موضوع رغبته في العودة إلى الجيش ، مما جعلني مرة و خلال زيارة لي إلى وزير الدفاع آنذاك المرحوم أحمد الشراباتي ، أتحدث في هذا الموضوع مع الوزير ، و لكن ما أن لفظت اسم حسني الزعيم حتى هب الوزير الشراباتي واقفا و صارخا : يا لطيف ...
وجاء الضابط في نهاية المطاف بالموافقة على عبوري. وأوصلني بسيارته إلى الجانب الفلسطيني حيث استقبلني رجال شرطة كانوا يستدفئون على نار حطب أوقدوه داخل محرسهم. واستدعى هؤلاء بالهاتف سيارة تاكسي، فبلغت الديوان الذي ينعقد فيه مجلس العزاء قرابة التاسعة. وكان الديوان قد خلا إلا من الأقرباء الحميمين. وعلى كتف رباح الذي احتضنني، أفرغت الكثير من توتري.
للكاتب الإريتري سليمان أدونيا
"ناصر؟"
لم أرد.
مرة أخرى، نادتني، "حبيبي؟"
هذه المرة أجبت، "نعم، يا حبيبتي".
"أرجوك قل لي لماذا أحببتني مع أنك لم ترني؟"
فالتاريخ و المجتمعات لا تتقدم زحفا. بل تنطلق قفزا. فالتاريخ و المجتمع ينطلقان من انكسار إلى آخر ، مع قليل من التذبذب بينهما. لكننا مع هذا ( شأننا في ذلك شأن المؤرخين ) نحب أن نؤمن بما يمكن التكهن به ، أي بالتقدم المتنامي البطيء.
و لقد أذهلني اعتقاد لم يبارحني منذ أن أتاني ، بأننا مجرد ماكينات " عظيمة " للنظر إلى الوراء ، و بأن ليس هنالك من هو أشد من البشر مخادعة للذات. و كلما مر علي عام زاد اقتناعي بهذه العلة البشرية.
حين تبدأ عيناي بالتفتح قليلا ، متغلبتين على آلام وخز الحطب في الرأس ، تكون هي قد نشرت ابتسامتها في أجواء المكان. لم تكن تمضي ، بسرعة ، لتهبني ما يقرره أبوها أو قبل ذلك ، من قدري: " هكذا الرجال ، و إلا فلا". تكرمني بكلماتها ، الداعية لي : " بارك الله فيك.. أغناك و قوّاك.. حفظك.. حفظك".
قولها : " أدام الله شبابك و أبهج عمرك" ، كان أكثر ما يفرحني ، ففيه تطريني مرحلة الشباب ، التي يؤكد كل من حولي أنني ما زلت صغيرا عنها. تكبرني ، كما قالت أمي ، بخمس سنوات ، فيما كنت في الثانية عشرة من عمري.